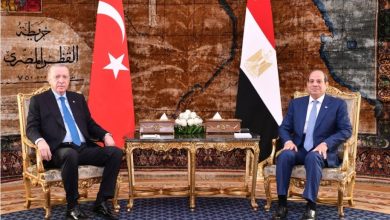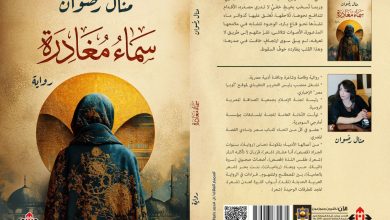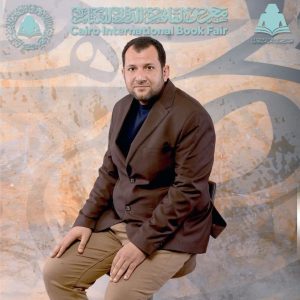
تتأسس قصيدة “على مشارف قريتي” للشاعر محمد عكاشة على صورة مركزية تنهض بها البنية السيميائية من بدايتها حتى نهايتها، وهي صورة الجسد المتشظي، الجسد المنهار، لا بوصفه كينونة فردية، بل بوصفه مرآة لوجود جماعي أعمق: هو جسد القرية، جسد الأرض، جسد الأنثى، وجسد الوطن. تفتتح القصيدة بهذا الانهيار الفاجع: “انهار نصف جسدي / وتلاشى ظلي / فجرت إليه كل حشرات الأرض”. الجسد هنا لا ينهار فحسب، بل يغدو موضوعاً للاجتياح، تلتف حوله “كل حشرات الأرض” بوصفها علامات على التآكل والزحف الكامن تحت سطح الحياة، في إشارة إلى خيانة الزمن أو فساد الواقع. وتلاشي الظل ليس مجرد اختفاء مرئي، بل هو محو للهوية، لانعدام التأثير، أو كما في السيميائيات البصرية، هو انطفاء الأثر الرمزي للذات.
على مشارف قريتي
انهار نصف جسدي
وتلاشى ظلي
فجرت إليه كل حشرات الأرض
قالت أمي
شرخ قد أصاب رأسي
قليل من التبن وحفنة من تراب معجونة بالماء
ترتق الوجه وتشعل الذاكرة
حتى تجري الأحصنة من الأذن لأرنبة الأنف
وتضخ الرقبة دماء تلون رمل الوادي
قالت جدتي
شق بطول صدري
قليل من الطمي وحزمة من حطب
تلتحم الأوردة وتحط القافلة
وماء ينبع من بئر
وتبني قواعد البيت
قالت القرية
فجوة أسفل بطني
وأمعاء تتدلى
من بابل للقاهرة
بركة ماء وتراب وتبن
ورجال يعجنون الطمي
يشدون غشاء البطن
ويرممون الجلد
لينبت النخل
قالت العير
أمي ونساء متشحات
يمضغن الرمل
وفيضان نفط
يبتلع كل الجسم
عند هذه العتبة من الانهيار، تبدأ سلسلة من الأصوات الأنثوية في الاستجابة لهذا الجسد المجروح، فتتكلم الأم أولاً، حاملة معها وصفة ترابية بدائية، تقول: “شرخ قد أصاب رأسي / قليل من التبن وحفنة من تراب معجونة بالماء / ترتق الوجه وتشعل الذاكرة”. إن استخدام عناصر أولية مثل “التبن” و”التراب” و”الماء” يحيل إلى طقس من الطقوس القديمة التي تتعامل مع الجسد ككيان من الأرض، كأن الشفاء لا يكون إلا بالعودة إلى الطين الأول. هنا، تشتبك العلامة الجسدية بالرأس، أي موضع الهوية والتفكير، كأن الخلل في الرأس يحتاج إلى مادة الأرض لا إلى دواء حديث. ثم تردف: “حتى تجري الأحصنة من الأذن لأرنبة الأنف / وتضخ الرقبة دماء تلون رمل الوادي”. فالصورة تتحول من ساكنة إلى ديناميكية، من إصابة إلى بعث، من الدم إلى التلوين، ومن الفردي إلى الجمعي، إذ إن “رمل الوادي” هو المكان الذي يتأثر بتجدد الجسد.
ويأتي صوت الجدة ليصعد من هذا المستوى العلاجي إلى مستوى كوني أكبر. تقول: “شق بطول صدري / قليل من الطمي وحزمة من حطب / تلتحم الأوردة وتحط القافلة / وماء ينبع من بئر / وتبني قواعد البيت”. الجدة لا تداوي موضع الرأس بل القلب، موضع الحب والنبض والحنين. استخدام “الطمي” و”الحطب” يعيدنا إلى رمزين شديدي الأهمية: الطمي هو مادة الحياة، وهو ما يجعل الأرض خصبة، أما الحطب فهو وقود الدفء. هذا التفاعل بين المادي والرمزي يخلق شبكة من العلامات التي تربط بين الجسد والبيت، بين القلب والمؤسسة، حيث يصبح “الشق” في الجسد مدخلاً لتأسيس البيت لا لانهياره. ما ينبع من البئر ليس ماءً فقط، بل هو علامة على انبعاث الحياة من الجوف، من الأعماق.
لكن النص لا يكتفي بالذات الأنثوية المباشرة، بل يمنح “القرية” صوتاً أيضاً، حيث تُجسد القرية نفسها كأنثى مجروحة: “قالت القرية / فجوة أسفل بطني / وأمعاء تتدلى / من بابل للقاهرة”. هذا التصوير يفتح الباب لتأويل القرية كرمز للوطن الأنثوي، الممزق بين حضارات، والنازف من التاريخ والجغرافيا. “بابل” و”القاهرة” ليستا مجرد مدينتين، بل علامتان لثقل الميراث والمركزية الثقافية. الفجوة في البطن تحيل إلى جرح ولادي أو ربما إلى اغتصاب جغرافي، والأمعاء المتدلية ليست سوى بقايا وطن يُفرغ من جوهره. ومع ذلك، تحاول القرية أن تُرمم نفسها: “بركة ماء وتراب وتبن / ورجال يعجنون الطمي / يشدون غشاء البطن / ويرممون الجلد / لينبت النخل”. “النخل” هنا هو علامة الخصوبة والامتداد، وهو ما يربط بين فعل الرجال في العجن، فعل العودة إلى المادة الأولى، وبين الأمل في عودة الحياة.
ثم تأتي القافلة أو “العير” بوصفها آخر الأصوات في النص، لتقلب المشهد من فعل الترميم إلى مشهد الطمس النهائي. تقول: “قالت العير / أمي ونساء متشحات / يمضغن الرمل / وفيضان نفط / يبتلع كل الجسم”. النساء المتشحات يمضغن الرمل، أي أنهن في حالة من الصبر أو القهر أو الجوع أو الذوبان في الأرض، لكن ما يأتي بعد ذلك هو الطوفان الحقيقي: “فيضان نفط” يبتلع الجسد بأكمله. وهنا تتحول العلامة من الأرض إلى النفط، من المادة الترابية إلى المادة الرأسمالية، من الطمي إلى النفط، وهي نقلة سيميائية حاسمة تُظهر كيف أن الحداثة المفترسة تلتهم الكيان بأكمله. لم تعد هناك إمكانية للترميم أو البعث، لأن الفيضان لا يترك شيئاً في مكانه.
بهذه البنية المتماسكة من الصور السيميائية المتلاحقة، تكتب القصيدة سردية كاملة عن الانهيار والبعث، عن الجسد بوصفه مرآة للقرية، والقرية بوصفها أنثى نازفة، والأنثى بوصفها ذاكرة تتكلم بلغة التراب والطمي والماء. يستعير النص عناصر من المعجم الزراعي والترابي، ويقابلها بأخرى من معجم الحرب والرأسمال، ليقول إن الذاكرة لا تُرمم بالحداثة، بل بالعودة إلى الطين الأول. إنها قصيدة تُقرأ لا بوصفها شِعراً فقط، بل بوصفها خارطة جسدية لبلد يعاني تمزقات تاريخية وجغرافية، وتعيد تعريف الجسد لا ككيان مادي، بل كعلامة كبرى، تنهض وتنهار، حسب ما يقال في التراب.
د. أحمد كرماني
قالت العير
للشاعر محمد عكاشة، مصر

على
مشارف قريتي
انهار نصف جسدي
وتلاشى ظلي
فجرت إليه كل حشرات الأرض
قالت أمي
شرخ قد أصاب رأسي
قليل من التبن وحفنة من تراب معجونة بالماء
ترتق الوجه وتشعل الذاكرة
حتى تجري الأحصنة من الأذن لأرنبة الأنف
وتضخ الرقبة دماء تلون رمل الوادي
قالت جدتي
شق بطول صدري
قليل من الطمي وحزمة من حطب
تلتحم الأوردة وتحط القافلة
وماء ينبع من بئر
وتبني قواعد البيت
قالت القرية
فجوة أسفل بطني
وأمعاء تتدلى
من بابل للقاهرة
بركة ماء وتراب وتبن
ورجال يعجنون الطمي
يشدون غشاء البطن
ويرممون الجلد
لينبت النخل
قالت العير
أمي ونساء متشحات
يمضغن الرمل
وفيضان نفط
يبتلع كل الجسم