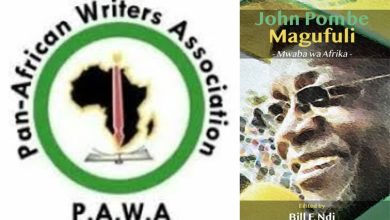المسلسل التونسي “رڨوج الكنز” (ويُنطق حرف القاف ذو الثلاث نقاط “ج” في الدارجة التونسية)، مسلسل قُدّم في شهر رمضان الماضي، ويُعدّ الجزء الثاني من مسلسل عُرض بنفس الاسم في رمضان 2024. يُفترض أن أحداثه تدور في اللازمان واللامكان، في عالم أسطوري، أو إن شئت في عالم “الواقعية السحرية” وفق تصور المخرج، وهو ما انعكس على الملابس والديكورات التي تُحيل لتلك العوالم.. على الرغم من عدم تناسقها بما يعبّر عن أزمنة أو حقب بعينها.
 لكن الإسقاط على الواقع كان مباشرًا وفجًّا، لدرجة لم تترك لخيال المتلقي البسيط أي فرصة للاجتهاد أو بذل أدنى مجهود ذهني للتأكد من أن الإسقاط على الواقع المعيش.
لكن الإسقاط على الواقع كان مباشرًا وفجًّا، لدرجة لم تترك لخيال المتلقي البسيط أي فرصة للاجتهاد أو بذل أدنى مجهود ذهني للتأكد من أن الإسقاط على الواقع المعيش.
في هذا العمل الدرامي المتأرجح، اجتهد المخرج عبد الحميد بوشناق في التركيز على عناصر الفرجة المتعددة، إلى درجة ازدحام الأحداث بها، ما يجعل المتابع يتساءل إن كانت قد حُشرت حشرًا.
كما قدّم صانع موسيقى العمل اجتهادات موسيقية جيدة، وإن شابها الصخب أحيانًا، إلى درجة يمكن وصفها بـ”Distortion”، مع إدماج ألحان وأغانٍ وإيقاعات لغيره من الملحنين، بما فيها لإجناس موسيقية مختلفة ومغايرة، والوقوع في فخ التكرار للجُمل الموسيقية. وقد حدث الأمر ذاته في كوريغرافيا العمل التي تولّتها أميمة المناعي.
 لا يستطيع المرء أن يفعل كل شيء:
لا يستطيع المرء أن يفعل كل شيء:
صحيح أن كثيرًا من الأعمال المسرحية أو السينمائية أو التلفزيونية قد استُغلّ نجاحها وتحولت إلى جنس درامي مغاير، لكن البَون شاسع بين الأجناس الدرامية وحرفية إخراجها.. وبالتالي، أن يتصور البعض أنه قادر عليها كلها، فهذا إمعان في خداع النفس قبل خداع المتلقي.
لكن يبدو أن المخرج عبد الحميد بوشناق قد قرر استغلال النجاح الجماهيري والتجاري لمسلسله “رڨوج الكنز”، فاستسهل تحويله إلى عمل يظن أنه مسرحي.
ونجاح العمل الفني جماهيريًّا وتِجاريًّا لا يعني بالضرورة أنه عمل جيد، بقدر ما يعني مكاسب مادية ومعنوية إضافية لصنّاعه.
 من “دڨة” إلى “الحمامات”:
من “دڨة” إلى “الحمامات”:
لا يمكنك أن تلوم المهرجانات إذا خاطبت جانبي الربح والجماهيرية، كما فعل مهرجان دڨة الدولي حين اختار عرض “رڨوج” ليكون عرض الختام، ولا مهرجان الحمامات الدولي حين جعله عرض الافتتاح بعد أيام.
رغم أن المهرجان الأول مهرجان خاص، والثاني عمومي، فكلاهما يبحث عن النجاح الجماهيري.
في العرض الذي تحول من مسلسل إلى مسرحية، اجتهد المخرج في صنع عدة مستويات على خشبة المسرح، مع وجود معادل بصري من خلال استخدام شاشات عرض للبث الحي تارة، والمسجل تارات أخرى، تتكامل أحيانًا مع الأداء الحي.
كما وُضعت الأوركسترا في صدر المكان وعلى جانبيه، صحبة المايسترو، مما شكّل ازدحامًا سينوغرافيًّا يقترب مما يمكن وصفه بـ”الفوضى السينوغرافية”، دون أي مبرر درامي مقنع.
لم يكتفِ المخرج بمحاولة قول كل شيء، حتى لو بدا مقحمًا ليستكمل “المباشرتية” المُخلة، عبر محاولة جمع كل النقد السياسي والاجتماعي وغيرها في خطاب واحد، إلى حد التكدّس، مع محاولات ملحّة للعب والتلاعب بمشاعر الجمهور إلى حد الابتزاز أو الاستجداء العاطفي.
فمن خلال الانتقال من النقد المباشر جدًا للفساد عبر شخصية “الديناري” (التي أداها محمد صابر الوسلاتي بأداء مصطنع “artificial” قد يعجب بعض الجمهور لكنه يفسد الذائقة الفنية)، إلى مشاهد تُظهر المظلومية التي تتعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي، وهي مأساة تضمن تدفق المشاعر وشلالات الدموع، إن أردت.
ولا بأس أيضًا من استكمال الجانب الميلودرامي بغية الوصول للتراجيديا الشعبوية، عبر قتل الصديق لصديقه، أو الأخ لأخيه في إحالة فجة لقصة “قابيل” و”هابيل”، أو من خلال صور الراحلين من ذوي الشعبية، مع استدعاء ألحانهم وأغانيهم.
وربما لم يكتفِ المخرج بالازدحام الفوضوي لخشبة المسرح، فرأى ضرورة إقحام مشهد “الزردة” الاحتفالي بكامل مفرداته، والذي يشبه إلى حد كبير “الموالد” في المشرق.
ومن مشاهد المصارعة إلى “الرقص بالحصان”، بكل ما يحمله من عنفوان وفرجوية، حتى لو تم حشره دون مبرر درامي.
ثم يعود الفساد ليهدد أرض الوطن “رڨوج”، من خلال تهمة باطلة تتعلق بالبحث عن الكنوز والآثار. وهنا يسعى المسؤول الفاسد إلى مقايضة سلامة الأرض باغتصاب العرض، ولو تحت مسمى الزواج الإجباري.
لكن في لحظة صحوة وطنية شعبوية، تنتفض الجماهير لاسترداد الوطن، وإحياء الحلم عبر العمل الدؤوب، فيكتشف أبناء “رڨوج” أن الكنز الحقيقي بداخلهم، من خلال نضالاتهم، وكفاحهم، وقصص عشقهم التي تختزل مفردات الوطن.
وكان من المخل والمزري أن يُطلب من الجمهور إشعال مصابيح الهواتف الجوالة لتصاحب العرض الذي يصعب أن تحدد إلى أي الأجناس الدرامية ينتمي. فمسألة إشعال مصابيح الهواتف الجوالة تُحيلك مباشرة إلى العروض الغنائية والموسيقية الصاخبة لنوعية معينة من الفنانين، والتي لا تتناسب أو تتماشى بأي صورة من الصور مع هذا الكم من الابتزاز العاطفي الشعبوي للمشاعر الوطنية والإنسانية التي ألحّ عليها مخرج العرض..، وهو ما يعكس سوء تقدير وخلل الرؤية “إن وُجدت”، والذي يتحمله مخرج العمل دون غيره..، في عمل يمكنك أن تصنفه كما يحلو لك إلا أن تعتبره عملًا مسرحيًا. ولا معنى لإعادة اجترار أحداث مسلسل بحذافيرها على خشبة المسرح مع بعض اللمسات التي لا تضيف قيمة حقيقية حتى يدّعي صانعه أنه يقدم عملًا مسرحيًا، فيما الأمر تجارة صريحة بنجاح شعبوي سابق.
ربما تصوّر البعض أن بالإمكان تجاوز بعض هنّات العمل باعتباره استعراضيًّا ينتمي لعالم “الفانتازيا”، لكن إقحام مشهد الاحتفاء بالراحل أحمد كافون، تصاحبه كلمات يتوهّم المخرج أنها قصيدة، مع إحدى أغاني الراحل، وإطلاق الحمام، وصور السماء والزهور… كل هذا تجاوز الابتزاز العاطفي إلى ما يمكن وصفه بـ”الشحاذة الشعبوية” لمشاعر الجمهور، طمعًا في جماهيرية ونجاح تجاري على حساب ذائقة التلقي لدى جمهور يسعى الفن الجاد أن يضيفها إليه.
ويبقى عرض “رڨوج” ناجحًا محليًّا، ولكن لا تكفي فرجوية “رقص الحصان في الزردة” لاستدراج المتلقي الإقليمي أو العالمي لقبول نفس البضاعة المستهلكة فاقدة الهوية الدرامية، على العكس مما كانت تفعله في السابق مشاهد “الحمامات الشعبية”، و”مظاهر الشعوذة”، و”قهر النساء في المجتمعات الذكورية” التي تختزل الشرق في صورة مزيفة إرضاء لخيال الغرب.
……
وربما كانت لنا عودة بعد هذه القراءة الأولية. ويمكن مشاهدة لقطات مصورة إضافية على قناة الكاتب ، يوتيوب