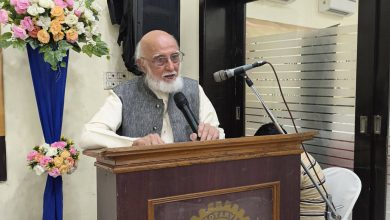(ما زلتُ أفتّش عن جوابٍ لابنتي الصغيرة، يوم سألتني: لِمَ أمسكت خالتي بالسكين، وكادت أن تُطفئ أنفاسها بيدها؟ كيف أشرح لطفلة صغيرة أنّ شبح الانتهاك والرّعب قد يدفع صاحبه إلى البحث عن الخلاص؟ آثرت الصمت، لكن السؤال ظلّ معلقًا بيننا، يراقبني كما تراقبني عيناها البريئتان. وأنا كذاك السؤال معلقةً في الهواء، لا أعلم كيف أنزع من ذاكرتي عيون أطفالي المذعورة، وشعوري بالعجز بأنّ حضني لم يكن حِصْنهم)

في الثالث عشر من تموز، شهدت محافظة السويداء هجوماً منظّماً نفّذته قوات تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، مدعومة بعناصر من بعض العشائر البدوية، بذريعة فضّ اشتباك بين مجموعات بدوية وفصائل محلية من أبناء السويداء. غير أنّ مسار الأحداث كشف أنّ الهدف الحقيقي كان فرض السيطرة على المدينة بالقوة العسكرية.
فرضت القوات المهاجمة حصاراً خانقاً على المدينة، أعقبته عملية اقتحام شرسة تخلّلها قصف بالدبابات استهدف الأحياء السكنية ومراكز تجمع المدنيين. وأسفر هذا الهجوم عن مجازر مروّعة اتخذت طابعاً طائفياً، أودت بحياة الكثير من الأبرياء، وترافقت مع أعمال حرق وسلب ونهب شملت الممتلكات العامة والخاصة، في مشهد من الانتهاك الممنهج لكرامة الإنسان وحرمة الحياة.
وعلى الرغم من انسحاب القوات المهاجمة لاحقاً من مركز المدينة، فإنها ما تزال تحتفظ بسيطرتها على ستٍ وثلاثين قرية تهجّر سكانها في ريف السويداء الشمالي والغربي، وتستمر في فرض حصار خانق على المدينة نفسها.
شهادة كاثرين الجوهري ناجية من مجازر السويداء: صراع بين الفصائل والبحث عن الأمان
صباح السبت الثاني عشر من تموز، غادرت منزلي مع أطفالي الثلاثة في حي المهندسين متجهة إلى بيت أسرتي مقابل مشفى السويداء الوطني.
مع حلول مساء الأحد، بدأ التوتر في حي المقوس، حيث انتشرت مشادات ومناوشات بين الفصائل المحلية والبدو. وفي يوم الاثنين، تصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ.
بحلول مساء الاثنين، بدأت العائلات في إخلاء المباني القريبة من منزل أسرتي، واحتدت المعارك بين الفصائل المحلية والقوات المهاجمة على حدود السويداء.
صباح الثلاثاء، ازدادت حدة الاضطراب، إذ توجّهت مجموعات من أهالي السويداء نحو المقرن الشرقي ومدينة صلخد. ومع الظهيرة، تسللت الأخبار عن دخول مسلحين إلى دوّار العمدان وقتلهم شبابًا من آل قرضاب، وهي عائلة تسكن على مقربة من حارتنا. كان ذلك مؤشراً على أن الأحداث اقتربت جدًا، لكنني قررت البقاء في بيت أهلي.
عند المساء، انتشر شباب من المنطقة أمام المشفى المقابل لمنزلنا. لم يكن في الجو ما يوحي بخطر وشيك. الساعة الثامنة مساءً حملت أنباء “تحرير السويداء”. باتت المدينة هادئة نسبيًا، وكأنها تستعد ليوم جديد.
الأربعاء صباحًا، كان المشهد طبيعيًّا إلى حدٍّ كبير. قضينا الوقت في تنظيف المنزل والعناية بالأطفال. قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وبينما كنا نشرب المتّة، دوّى في الأفق صوت جنازير دبابات تقترب، تلاها إطلاق نار متقطع. كانت الدبابات تمر على الطريق العام حيث يقع منزل أسرتي، لكن بدا أنّها لا تتجه لاستهدافنا مباشرة.
انتقلنا فورًا إلى الحمام للاحتماء. بعد نحو ربع ساعة، سمعنا أصوات تبادل إطلاق نار وحوارات متقطعة بين بعض الشبان في الخارج. صعدت أختي إلى الشرفة، ورأت شابًا في الشارع، فسألته لمن هذه الدبابات، فأجابها بأنّهم حصلوا عليها إثر اشتباك مع القوات المهاجمة في دوّار العمران في اليوم السابق. حينها عدنا مجددًا إلى غرفة المعيشة.
ساعات من الرعب في بيت العائلة
بعد نحو نصف ساعة من الهدوء النسبي، عاد القصف مجددًا، لتظهر ثلاث دبابات أخرى غير تلك التي انسحبت سابقًا. تبيّن لاحقًا أن دخول هذه الدبابات كان جزءًا من عملية خداع للشبان الذين كانوا يحرسون المنطقة. سرعان ما تمركزت القوات في محيط بيت أهلي، وحاول المسلحون اقتحام البوابة الرئيسية المؤدية إلى الطابق الثاني، لكنهم فشلوا في كسرها. عندها اتجهوا إلى المدخل المنفصل للطابق الأرضي، وتمكنوا من تحطيم بابه والدخول.
منذ اللحظة الأولى، كان واضحًا من لهجاتهم، والتي غلبت عليها النبرة البدوية، أنّهم ليسوا من أبناء الحي. تصاعد التوتر إلى ذروته حين بدأوا بنقل معدات ثقيلة إلى سطح المبنى، تتضمن رشاشات ثقيلة من نوع “23” وبنادق قنص، حيث نصبوا مواقعهم فوق البناء مباشرة.
خلال ما يقارب أربع ساعات ونصف، كنا مختبئين في الحمّام، داخل حوض الاستحمام، لأن النوافذ والغرف الأخرى كانت مكشوفة تمامًا للقناصين. حتّى شرب الماء كان تحديًا ومخاطرة؛ كنا نزحف، ونمدّ أيدينا بحذر شديد إلى المجلى لملء الكوب، ثم نعود سريعًا إلى مكان الاحتماء.
كلّما همّ المسلّحون بإطلاق النار، كنا نفتح أفواهنا قليلًا لتخفيف ضغط الصوت على الأذنين، وفي إحدى المرات كان القصف شديدًا لدرجة أنني فقدت السمع مؤقتًا لمدة نصف ساعة. معظم الاستهداف كان موجّهًا نحو المشفى المقابل لنا، مع ضربات طالت المنازل القريبة.
في لحظات الهدوء النسبي، حاولت فهم طبيعة السلاح الذي نسمع صوته، فسألت عمي وزوجي عبر الهاتف عن الفرق بين صوت القناص والرشاش، فأكدوا لي أن ما نسمعه هو صوت رشاش من عيار “23”، وهو يُصنّف كسلاح متوسط الثقل.
ساعات ممتدة من الخوف والرعب الشديد، خصوصًا على أطفالي. حاولت الحفاظ على رباطة جأشي أمامهم، فرويت لهم قصصًا لإلهائهم، لكنني شعرت أنّهم يلمحون قلقي. في لحظة، أمسكت ابنتي زينة — ست سنوات — بيدي وقالت بصوت خافت: “أنت خايفة؟ أنا معك… ما تخافي”. كلماتها البسيطة في تلك الظروف كانت أقوى من أيّ محاولة للتماسك.
لحظة المواجهة المباشرة
لن أنسى تلك اللحظة أبدًا. كانت ابنتي الصغيرة قد أمسكت بيدي قبل دقائق، تحاول أن تمنحني القوة، لكن المشهد تبدّل فجأة مع صوت الطرقات المتتالية على أبواب المبنى. كان المسلحون يمرون على كل شقة في الطابق، يطرقون بعنف وهم يرددون: “يا إخوة… يا إخوة…نحنا هون”. شعرت حينها بجمود تام، وكأن الخوف الذي سكنني طوال الساعات الماضية قد تحوّل إلى برودة قاسية، إلى لحظة تشبه انفصال الروح عن الجسد.
كلّ طابق في المبنى مؤلّف من أربع شقق. طرقوا كل الأبواب حتى وصلوا إلى باب بيت أهلي. كانوا يعرفون أننا في الداخل، حاولوا فتح الباب بالقوة. فتح لهم والدي في النهاية، وهو يدرك أننا آخر من بقي في البناء بعد أن غادرت جميع العائلات، باستثناء شاب من الجيران في الطابق الأرضي، عمره عشرون عامًا، هذا الشاب كان قد تطوّع لحراسة المشفى، لكنّه عاد ليأخذ بعض الأغراض من منزله عندما دخلت الدبابات، فوضع سلاحه جانبًا وجاء ليختبئ معنا.
كان الشاب يجلس معنا في المنزل خلال ساعات القصف. وما إن فُتح الباب حتى اندفع إلى الداخل قائد المجموعة ومعه ستة مسلحين. وجوههم قاسية، نظراتهم حادّة تبعث على القلق. لمحونا ونحن مختبئون في حوض الاستحمام، فابتسم القائد ابتسامة باردة وقال: “لا تخافوا، ما بدنا نأذي حدا… عندكم سلاح؟” فأجبنا بالنفي.
بدأ بتفتيش المنزل متنقلًا بين الغرف حتّى رأى كتاب القرآن، فأخذ والدي إلى الصالون وسأله: “أنتم سنة؟” أجابه والدي: “لا، نحن دروز”. تبادل أفراد المجموعة النظرات باستغراب، إنّهم يجهلون كل شيء عنّا، ثم تساءلوا عن سبب وجود القرآن في المنزل فأوضح والدي الأمر.
بعدها التفت القائد نحو الشاب الذي كان معنا وسأله عن هويّته. سارعت أنا وأختي إلى القول إنّه شقيقنا، في محاولة لحمايته. حاولنا أن نظهر أنّه فرد من العائلة لحمايته، طلب القائد من الشاب فتح هاتفه المحمول، وعندما فعل، ظهرت صورة له وهو يحمل سلاحًا. سأله القائد: “من أين لك بالسلاح؟” فتدخلت بسرعة: “هو لا يملك سلاحًا، فقط التقط صورة مع أصدقائه، ولا يعرف حتّى كيف يستخدم السلاح” (يعني فيك تقول شباب بيحبوا يتباهوا) الشاب ظل صامتًا تقريبًا، بينما كنت أشرح نيابة عنه لأبعد عنه الشبهة.
لم يقتنع القائد بكلامي، وقال بلهجة حاسمة: “سنأخده”. عندها انفجرنا أنا وأختي في البكاء والتوسل: “منشان الله، رجعوه… لا تؤذوه… هو شاب صغير، لا يعرف استخدام السلاح، وليس لي سوى أخ واحد”. ورغم توسّلاتنا، اقتادوه وأغلقوا الباب خلفهم، تاركين في المكان ثقلًا صامتًا أشد وطأة من القصف نفسه.
ساعات تحت وطأة الابتزاز النفسي والتهديد
عقب اقتياد الشاب “أمير”، أغلق قائد المجموعة الباب، وأمرنا بعدم فتحه لأيّ شخص. أدركنا لاحقًا مغزى كلامه.
النية كانت متجهة نحو إعدامه؛ إذ وُجّهت فوهة بندقية روسية إلى رأسه، وسمعنا أحدهم يقول: “نقتله”. في تلك الأثناء، كان القائد مترددًا في تنفيذ القرار، بينما كنت أنا أتمتم بالدعاء في داخلي، ورغم حالة الرعب التي تنتابني شعرت أن أمير لن يمسّه سوء.
لم يمضِ وقت طويل حتى سمعنا طرقًا على الباب. الطارق أحد أفراد المجموعة، ينتمي إلى عشائر ريف حلب الجنوبي، وأخبرنا أنّه هو من تدخّل لإعادة “أمير”. جلس بثبات بارد، متحدثًا بلهجة خالية من الانفعال:
“لولا هالولاد الصغار كنت صفّيتكم واحد واحد… مبارح صفّيت تسعة من بيت واحد وبينهم طفلين”.
نبرته توحي بأنّ الأمر مألوف بالنسبة له، مما جعل المشهد بأكمله أشبه بضغط نفسي ممنهج.
منذ الساعة الرابعة عصرًا وحتّى التاسعة مساءً، تردّد هذا الشخص على المنزل نحو اثنتي عشرة مرة، يدخل أحيانًا للتفتيش وأحيانًا لطرح أسئلة تفصيلية عن حياتنا وأفراد العائلة. في إحدى المرات، عثر على مبلغ مالي صغير قرابة ثلاثة ملايين ليرة سورية، تركه مكانه، وقال لنا: “خبّوهم.. أحسن ما حدى ياخدهم”، مُحاولًا أن يجعلنا نثق به، مؤكّدًا أنّنا أمانة عنده. فيما لم يعثر على المبلغ الأكبر الذي تمكّنا من إخفائه.
تنوّعت أسئلته بين الاستفسار عن هوية الأطفال، وأماكن نومِنا، وأوضاعنا الأسرية، وحتّى تفاصيل الغرف. سألني عن زوجي رغم علمه بعدم وجوده، في محاولة واضحة لجمع أكبر قدر من المعلومات. قالت له أمّي: “اعتبرني مثل أمك و هدول خواتك”. أجابها بحدّة: “أنا ما بيشرفني أنتو تكونوا أهلي… أنتو دروز”. ثم أشار إلى ابنتي ذات الثلاث سنوات، وقال: “البنت بهالعمر عنّا بتتحجّب، مو مثلكن”.
ظلّ يتردد إلى المنزل على فترات متقاربة، من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة، يجلس أحيانًا دون هدف واضح، ويطرح أحاديث جانبية أو تعليقات ذات طابع استفزازي، حتى تجمّد الدم في عروقنا.
وفي زيارته الأخيرة، أمرنا بترك الحمام — حيث كنّا نختبئ — والجلوس في الصالون، قائلاً: “الحمام أنجس مكان بالبيت… اجلسوا هون، هاي المنطقة صارت صديقة إلنا، وما عاد حدا بيأذيكم”. كانت كلماته تحمل مزيجًا مربكًا من التطمين المشروط والتهديد الضمني، ما أبقى حالة القلق والترقب قائمة رغم وعوده.
اقتحام مسلّح ومحاولة اعتداء تحت التهديد المباشر.
عاد في وقت لاحق برفقة شخص آخر يرتدي حزامًا ناسفًا، ووقف عند باب المنزل وهو يحمل بندقية روسية موجّهة نحو الداخل. سبق أن استفسر عن الغرف ومَن يشغلها، فحين سأل عن الغرفة الداخلية وأجبناه بأنها غرفتي مع أختي، أصرّ على تفتيشها، مشترطًا أن ندخل معه. حاولت والدتي مرافقتنا، منعها مُرافقه قائلاً: «لا يا حجي، إنتِ بتضلي هون وما بتخلي الأولاد يفوتوا».
دخلتُ أنا وأختي “غزل” إلى الغرفة، حيث كان والدي و”أمير” — ابن الجيران — ووالدتي وأطفالي في الصالون. أغلق الستائر وذكر أنّ هناك إطلاق نار من هذه الجهة، ثم أمرنا بإفراغ محتويات الخزائن على الأرض. بدا مرتبكًا وعنيفًا في حركاته، وفي وقت سابق كان قد تحدّث عن سيارة ستأتي لـ«أخذ أبي والشاب إلى التحقيق»، وعندما استفسرت منه عن وجهة التحقيق، أجاب «المخفر»، فواجهته بالقول إنه لا توجد مخافر، ما أوضح لي زيف روايته.
طلب منا إخراج الملابس من الخزانة، وأمرنا برفع أيدينا، ثم بدأ بتفتيشنا بطريقة مهينة، متعمّدًا لمسّ مناطق حساسة. كان ذلك تحرّشًا مباشرًا. أنا وغزل ننظر لبعضنا، لم أستوعب ما يحدث، شعرت أنني قد أفقد عقلي. ثمّ طلب منّنا الركوع على الأرض، وهددنا إن أصدرنا صوتًا سيُفرغ طلق بندقيته في رأس كلّ واحدة منّا. وفي هذه الأثناء، أسمع صوت أمي تحاول الدخول، ومرافقه يهدّدها بإطلاق النار إن تحرّكت. حاول الاقتراب جسديًا من أختي ورفع قميصها، فقمت بدفعه عنها بحزم، قائلة في نفسي: “سنموت على أي حال، لكن لن أسمح له بلمسنا.”
ردّت أختي بحدّة: «فشرت يا كلب»، ودفعته هي الأخرى. اشتد التوتر، فحاول تثبيتها والسيطرة عليها جسديًا، لكننا قاومناه معًا، فيما كان مسلحًا وبندقيته معلّقة على كتفه. في هذه اللحظة، تلاشى شعور الخوف من داخلي، وأصبحت على يقين بأني سأموت، بقي خوفي فقط على أطفالي وأهلي. صرخت أنا وغزل في وجهه بأعلى ما نستطيع، محاولةً إحداث ضجيج قد يسمعه عناصر آخرون في الخارج، إذ كنّا نعتقد أنّهم يقتلون من يرتكب مثل هذه الأفعال. دخلت والدتي مسرعة إلى الغرفة حاملة ابني الصغير وهي تصرخ، ظنًّا منها أنّه قتلنا، فوجّه بندقيته عليها مهددًا بإطلاق النار. حاولت أن أرفع صوتي لأصرخ بأننا نتعرض لمحاولة اغتصاب، لكن التوتر والصدمة كبّلا حنجرتي.
في هذه الأثناء، اغتنم المسلّح الآخر الموجود عند الباب فرصة الفوضى وسرق هاتف والدتي. الأسوأ حين حاولت إخراج ابنتَيَّ الصغيرتين من الصالون، وقف أحد المسلّحين خلفهما والآخر أمامهما، والسلاح موجَّه نحوهما، ما جعلني أتصوّر للحظة أنني سأشهد قتلهما أمامي. استمر الصراخ والمواجهة، وأطلقت أختي سيلًا من الشتائم الغاضبة، حتى بدا أن المعتدي فقد السيطرة على الموقف، فدفعنا وخرج مسرعًا، وأغلق الباب خلفه فورًا.
الأكثر إيلامًا بالنسبة لي كان رؤية أبي و”أمير” متجمّدين ومصدومين، لم يستوعبا ما يحدث، فالعجز كان سيد الموقف أمام مسلّح يقف بحزام ناسف قد يفجّر البيت ويقتل الجميع بضغطة زر. منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، وأنا أستيقظ على صوت بكاء والدي.
كانت أختي منفعلة وخائفة لحدٍّ فقدت فيه السيطرة على أعصابها، فأمسكت سكينًا مهددةً بقتل نفسها إذا عادوا، هذا المشهد ظلّ يثير أسئلة بناتي حتى اليوم. كنت أجيبهنّ بأنها كانت «تريد تقشير تفاحة» لتخفيف وطأة المشهد عليهنّ، وأعلم أنّهما لا تصدقاني في كلّ مرة أحاول فيها أن أجد مخرجًا أو تفسيرًا.
بعد ذلك، حاولت الاتصال بأيّ شخص في السويداء، لكنّ إشارة الشبكة كانت ضعيفة، ولا تتوفر التغطية إلّا في زاوية محددة من المنزل.
اتصلت برامي، صديقي من أيام الدراسة الجامعية، شاب من السويداء مقيم في دمشق، وأبلغته بما حدث معنا، فرد قائلاً: «احرصوا على نقل كل ما يمكن نقله من الكنبيات وأغلقوا الأبواب بإحكام». بدأنا بنقل الكنبيات ووضعها فوق بعضها بعضًا، ثم أغلقنا الأبواب لتأمين المنزل. الأبواب مصنوعة من الحديد والزجاج، وبين الزجاج شرائط حماية ناعمة، مما صعّب كسرها.
بعد ربع ساعة، عاد المسلّح برفقة مسلّح آخر، وحاولا فتح الباب بالقوة، وصرخا مطالبَين بفتحه، لكننا لم نستجب، فبدأا بكسر الزجاج. شعرت حينها بخطر كبير، ولا يمكن وصف حالة الرعب والخوف على أولادي وأهلي، وخاصة أنهم قد يرمون قنبلة داخل المنزل. حضنت أطفالي، وظهري مواجهٌ للباب لتوفير أقصى حماية لهم من شظايا الزجاج، محاولةً تهدئتهم وإلهاءهم بوعودي لهم بالمشاوير الجميلة والهدايا الثمينة.
تذكرتُ أنّ رامي أخبرني أنه في حال عودتهم، علينا أن نخرج إلى الشرفة ونصرخ طالبين المساعدة. طلع بابا وماما وأختي وبدأوا بالصراخ، وأختي تصيح: هناك من يريد اغتصابي. أختي مهندسة معمارية ومغنّية في قناة سيبستون، ولديها فرقة مميزة، يجب أن تكون الحياة أمامها أفضل ممّا رأته.
في المبنى المقابل يوجد حوالي خمسين عنصرًا مسلّحًا، أحدهم قال لها: اخرسي وعودي إلى الداخل، وآخر سألها عن هوية المعتدي: (هل هو منّا أم درزي؟) فأجابته: منكم. فصمتوا، وكأنّه إن كان منهم، فالأمر طبيعي.
في هذه الأثناء، نزل عنصر من الطابق الرابع يسمع صراخنا، ولكن لم يعلم بأي طابق نحن. قال: احكيني يا أختي، أنا بالمنور، وسألنا عن الطابق، فأجبناه إننا في الطابق الثاني. دقّ الباب، ولكن لم نجرؤ على فتحه. أختي تحاول الاتصال بصديقها مهندس العمارة من دمشق، لاحقًا تطوّع في الأمن.
العنصر الذي نزل عن السطح استمر في طرق الباب، قائلاً: افتحوا لي، ثقوا بي، حتى أستطيع مساعدتكم، أنتن أعراضنا، وإن مسّكم أحدهم بسوء، فكأنّه مسّ أختي. نحن أتينا بمهمة عسكرية فقط. رفضنا أن نفتح. أختي تصرخ: ماذا لو كنت مثلهم؟ فاستمر في الإلحاح لوقت طويل. قالت له أختي: أتحدث مع صديقي، وهو متطوع في الأمن العام. فقال لها: أخبريه باسمي وبأنني متطوع بكتائب خالد.
فتحنا الباب ليتحدث معه عبر الهاتف، مؤكّدًا لصديق أختي أنّه سيحمينا ولن يسمح لأيّ شخص بالاقتراب منّا، موضحًا أن من دخل إلى منزلنا — حسب ما وصفنا له — كان من العشائر، وأنه شخصيًا ليس من العناصر التي تسرق أو تعتدي على المدنيين. هو ذاته كان على سطح البناء يقصف المشفى ويقنص الأطباء (شيزوفرينيا)، وكأن قصف المشفى لا علاقة له بقتل المدنيين. إنّهم مزيج ٌ من سلوكيات مختلفة: بعضهم يقتل، وبعضهم يقوم بالنهب والحرق، وبعضهم يهاجم المباني ويعتدي على المدنيين، مما زاد من شعورنا بالخطر وعدم الأمان.
وبعدما غادر العنصر الذي تكفّل بحمايتنا، حاولتُ التخفيف من حدّة الأذى النفسي الذي طال أطفالي، وبدأت أقول لهم إنّ هؤلاء يهجمون للدفاع عن محالّ الشوكولا في السويداء التي تتعرض للسرقة. كانت طفلتي الكبرى تنظر إليّ باستغراب، وشعرت أنّها لم تُصدّق روايتي.
لاحقًا، عاد هذا العنصر ليطرق الباب، قائلًا لغزل: «أخبروني أن لديكم أطفال، خذوا مني هذا الكيس». إنّ كيسٌ معبّأٌ بقطع الشوكولا، كان هذا الفعل بمثابة راحة نفسية مؤقتة لأطفالي. أعطيتهم الكيس وقلت: أترون؟ لم أكذب عليكم. شعرتُ حينها أنّ الله يقف معي.
تحطّم كل زجاج النوافذ بسبب القصف، وأصبحنا نسمع أحاديث العناصر أسفل المنزل. كانت نيّتهم، بعد السيطرة على السويداء، التوجّه نحو صلخد وعرمان، لكنّ ما أعاق تقدّمهم هو قصف أرتالهم على طريق دمشق.
طلب صديق أختي من العنصر الذي ساعدنا أن يؤمّن لنا طريقًا إلى دمشق. أخبرني العنصر أنّه سيأتي لاصطحابنا بعد أن تتم سيطرتهم على مدينة صلخد. قمتُ أنا وأهلي بجمع حاجياتنا الضرورية، وأخبرت زوجي، لكنّه رفض الأمر كليًا، وقال لي: إن كنتِ تأمنين لهذا العنصر، فكيف ستضمنين سلامة الطريق وألّا يُقتل هو نفسه إن لم يُسلّمكم؟
عند الساعة الواحدة والنصف، بدأت أرتالهم بالانسحاب، وصرنا نرى السيارات تأتي لتحميل العناصر. عاد العنصر ليخبرنا أنّ لديهم أمرًا بالانسحاب باتجاه دمشق، ولن يستطيع اصطحابنا معه لأنّ في سيارته اثني عشر عنصرًا آخر. قُصفت أرتالهم وهي عائدة إلى دمشق، وحمدنا الله أننا لم نتورّط في النزول معهم، فلو لم نمت على أيديهم، كنّا سنموت بالقصف.
عند الساعة الثانية بعد الظهر، انسحبت جميع أرتالهم من المدينة. عدتُ إلى منزلي أخيرًا. كان والداي قد أقاما معي فترة من الزمن بعد أن قرّرا مغادرة منزلهما بسبب شعورهما بالنفور الشديد منه، إلا أنّهما عادا إليه لاحقًا، وكأنّ الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي. وعندما علمتُ بهول المجازر التي ارتكبت في السويداء وريفها، حمدت الله أنّ أهلي وأطفالي لم يُصَب أحد منهم بأذًى ملموس أو بخسارة مادية.
ومع ذلك، فإن الأثر النفسي الذي مررنا به لا يقلّ قسوةً أو عمقاً عن أي أذى آخر قد يصيب الإنسان، ما عشناه تجربة بالغة الصعوبة، تركت ندوباً داخلية يصعب التئامها، لا أدري إن كنّا سنشفى منها.
نهى سويد