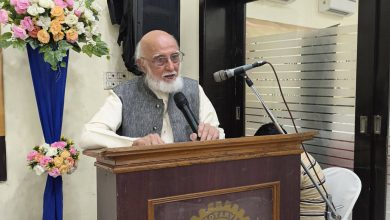في لوحات محمد عبدالله عتيبي يتقاطع الحلم مع الذاكرة، ويشدو اللون كقصيدة لا تُقرأ بالكلمات بل بالعيون. فمنذ ميلاده في مدينة الدويم عام 1948، تشبع هذا الفنان بحساسية خاصة تجاه الأشياء والرموز، وصاغ من دراسته في كلية الفنون بالخرطوم طريقًا لم يكتف بالتقاليد الأكاديمية، بل فتح أفقًا شخصيًا، يزاوج فيه بين الحرف العربي والأقنعة الإفريقية، بين طقوس الصوفية وأهازيج القرى، ليؤسس خطابًا بصريًا يتجاوز اللوحة إلى معنى أرحب: معنى الانتماء.
في لوحات محمد عبدالله عتيبي يتقاطع الحلم مع الذاكرة، ويشدو اللون كقصيدة لا تُقرأ بالكلمات بل بالعيون. فمنذ ميلاده في مدينة الدويم عام 1948، تشبع هذا الفنان بحساسية خاصة تجاه الأشياء والرموز، وصاغ من دراسته في كلية الفنون بالخرطوم طريقًا لم يكتف بالتقاليد الأكاديمية، بل فتح أفقًا شخصيًا، يزاوج فيه بين الحرف العربي والأقنعة الإفريقية، بين طقوس الصوفية وأهازيج القرى، ليؤسس خطابًا بصريًا يتجاوز اللوحة إلى معنى أرحب: معنى الانتماء.
في أعماله، تنبض عناصر الحياة السودانية ببهاء جديد؛ الجِمال والنساء والنخيل ليست مجرد صور، بل رموز تتجاوز حدودها لتغدو علامات على هوية جماعية. ألوانه هي انفعالات حيّة: كثيفة حينًا، موحدة حينًا آخر، كأنها تجسد التناقض الأبدي بين الفرح والحزن، بين الحياة والموت. المرأة عنده هي قلب اللوحة، رمزًا للخصب والذاكرة والجمال، تارةً تقف في ثنائية مع الطبيعة، وتارةً تتوحد مع الفضاء اللوني لتصبح أيقونة للوجود ذاته.

حين يميل عتيبي إلى الأبيض والأسود، يفعل ذلك ليعلن أن التناقضات ليست عيبًا في الحياة، بل سرها الأعمق؛ فالظلال والنور عنده يكتبان تاريخًا بصريًا موازٍ لتاريخ السودان. أما حين يندمج الحرف العربي مع الأقنعة الإفريقية، فإن اللوحة تتحول إلى ساحة لقاء بين العوالم، حيث لا تنفصل الأصالة عن الحداثة، ولا المحلي عن الكوني.

تجربته الفنية لم تكن حبيسة الجماليات وحدها، بل انفتحت على المعنى الإنساني؛ فبينما أحرقت الحروب ذاكرة المؤسسات الثقافية، ظل عتيبي يرسم، مؤكدًا أن اللوحة يمكن أن تكون فعل مقاومة ورسالة سلام.
وليس أجمل من لحظة اللقاء المباشر مع الفنان. فقبل أكثر من عقدين من الزمان، في معرض بمتحف السودان القومي، مدّ يده بابتسامة عريضة بعد أن باغتني مازحًا بقوله: “تصوروا ساكت؟”. ومنذ تلك المصادفة، صارت متابعة معارضه عادةً تملؤني بالدهشة والحنين معًا. حتى بعد الحرب واللجوء إلى القاهرة، ظل عتيبي يحمل روحه ذاتها، يرسم أمام النيل بطمأنينة العارف، يضع اللون فوق اللون كمن يبني عالمًا جديدًا. جلوسي إلى جواره في ورشة بالقاهرة كان أشبه بالجلوس إلى شاعر يكتب قصيدة، لكن باللون لا بالكلمة.
محمد عبدالله عتيبي ليس مجرد تشكيلي مبدع، بل شاهد على أن الفن يمكن أن يكون سيرة شعب، وحارسًا لذاكرة، وشاعرًا للون يجعل من التراث المعاش جماليات معاصرة، ومن السودان نافذة مفتوحة على العالم.
كمال هاشم
اغسطس 2025