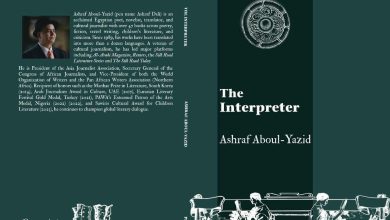تألّق النجم العالمي جورج كلوني برفقة زوجته المحامية الدولية أمل علم الدين على منصّة مهرجان فينيسيا السينمائي مؤخرًا. لن أتناول بريق إطلالتهما التي اعتدنا عليها، سأكتب عن وجعٍ أخذني بعيدًا عن السجادة الحمراء، إنّ صورة أمل علم الدين كلوني، ابنة الطائفة الدرزية، أعادت إلى ذهني فكرة أحاول جاهدةً الهروب من تصديقها، وهي أنّ الدفاع عن حق الأقليات في حياة آمنة يأتي غالبًا من أبناء هذه الأقليات أنفسهم، رغم كل الجهود الفردية العظيمة لأولئك المختلفين الذين يرفعون أصواتهم ضد الظلم أينما وقع. إنّ رؤية هذه الحقيقة جعلتني أرتدّ لداخلي وأجبرتني على مساءلة أعمق لكلّ ما كنت أعتبره بديهيًا، ما معنى الانتماء إلى الوطن؟ وأي معنى لوجود الإنسان ضمن هذه الرقعة الجغرافية؟ هل نملك الجرأة لمواجهة ذواتنا وتاريخنا ولإخضاع كلّ ما ورثناه من مبادئ، وما تشبّعنا به من مفاهيم إلى محكّ النقد؟ إنّ هذه المواجهة تصدم حدّ الانهيار، فهي تتطلب شجاعة وجرأة تفوق بكثير نضالاتنا الوطنية ضد الاستبداد، لأنها تهدم أوهامًا وأحلامًا عشنا لأجلها وناضلنا لتحقيقها، لتتركنا وجهًا لوجه أمام خرافة الوطن الجامع، وهشاشة العقد الاجتماعي، وانسلاخ الفرد عن ذاته، وكأنّ التاريخ كلّه يُسحب من تحت أقدامنا ليتركنا معلّقين في فراغ كئيب من الغربة والانفصال النفسي.
ولعلّ ما يجعل هذه الرؤية أكثر إيلامًا ووضوحًا أن أمل كلوني ابنة الأقلّية، جعلت الدفاع عن حقوق الأقلّيات محور عملها القانوني، لتجسيد مبادئ العدالة في الواقع المعاش، فقد تولّت الدفاع عن ضحايا داعش من اليزيدين، ورافعت باسم نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مطالبة بالعدالة وإنصاف الضحايا، وخاضت قضايا إنسانية أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تتعلّق بحرية التعبير وحقوق الأقليات والمجموعات المهمشة. من أبرز هذه القضايا قضية الإبادة الجماعية للأرمن على يد السلطات التركية، حيث مثلّت أمل علم الدين أرمينيا في قضية ضد السياسي التركي دوغو بيرينجيك أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، وبعد أن تمّ إلغاء حكم سابق يدين إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، أعربت عن قلقها من سجل تركيا في حرية التعبير، معتبرةً أنّ الموقف التركي يتسم بالرّياء.
إنّ اهتمامها بحقوق الأقلّيات لم يثنيها عن دعم فلسطيني غزة، في أيّار 2024 شاركت أمل علم الدين في لجنة خبراء استشارية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قامت بتقييم الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة وإسرائيل. ساهمت هذه اللجنة في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
حين اجتاحت داعش جبل سنجار في العراق، ارتكبت جرائم وحشية بحق اليزيدين، قتل جماعي، تهجير قسري، وبيع للنساء في سوق النخاسة، انتهاك صارخ لكلّ معايير الكرامة البشريّة، مع ذلك لم نشهد في العواصم العربيّة أيّ ردّ فعل أو وقفات احتجاجية جماعية تندّد بهذا الفعل المشين. عاش المجتمع العربي حالة نكران للجريمة والتقليل منها حتّى ظهرت نائبة يزيدية في البرلمان العراقي تصرخ وتبكي وتروي ما حدث منددة بالصّمت والتخاذل في نجدة قومها. ذلك الصمت الممتد عبر الزمن جزءٌ من تاريخ طويل من الخذلان، تاريخ من المجازر التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن والأشوريين في شمال شرقي سوريا في مطلع القرن الماضي، مرورًا بمجازر استهدفت الأكراد في العراق وسوريا، وصولًا إلى المآسي التي عصفت بالعلويين والدروز واليزيدين، ولا ننسى هجمات داعش على الطائفة الإسماعيلية، والتي باركتها آن ذاك أصوات كثيرة ممن اعتلوا كراسي السلطة الجديدة الآن.
في كلّ محطّة تاريخيّة ظالمة، كانت الأقلية تُترَك وحيدة في مواجهة مصيرها، الأكثرية تصمت، أو تشترط الطاعة للبقاء، أو تتواطأ مع الجلاد. الوطن في مفهومه السائد بُني على قاعدة الأكثرية، وأصبح الاختلاف الديني أو الفكري معها خطرًا قاتلًا، أصبح كلّ صوت يطالب بالعدالة أو يرفض الظلم يُوصم بالخيانة، وكل مطلب بالكرامة الإنسانية يُعدُّ تجاوز للحدود الوطنية، فالصمت والانصياع هما المقياس الوحيد للوفاء.
مأساة الأكثرية دائماً عظيمة، ويُطلَب من الجميع الانحناء أمامها، أما مأساة الأقليّات ينكرونها ويحاولون طمسها بكل ما استطاعوا من كذب وتضليل.
هذا الألم تحوّل لألم وجوديّ، شعور بأنَّ الذات تتفتت في مواجهة واقع لا يعرف الرحمة، فالانتماء للوطن أصبح كذبة، وعبء ثقيل يحاصر أنفاسنا، كل لحظة صمت أو تواطؤ تعزّز الانفصال بين الفرد وهويته، بين الذات والوطن.
اليوم وأنا أعيش ما يجري في السويداء لحظة بلحظة، أرى التاريخ يصفعني بقسوة. السلطة السورية المدججة بميليشياتها تهاجم السويداء وترتكب أبشع المجازر، فيما يقابل السوريون هذا المشهد إمّا بصمت، أو بتواطؤ وتأييد يضاعف الألم. محدودة هي الأصوات الحرّة المعترضة على هذا من السوريين.
هنا يتحوّل السؤال من سياسي إلى وجودي، ما معنى الوطن إذا كان يسلخ أبناءه ويتركهم فرائس للخوف والخذلان؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحتفظ بذاكرته الوطنية وهو يشعر بأن انتماءه صار لعنة أكثر من كونه ميزة؟
الدروز دافعوا بشراسة عن سوريّتهم، ساندوا إخوتهم في الوطن، وقادوا معارك كبرى ضدّ الحكم العثماني وبعده الفرنسي، شاركوا في الانتفاضات الوطنية، وحافظوا تاريخيّا على استقلال البلاد. كانوا الصوت الوطني النقي، الملاذ الآمن للجميع في زمن المحن. لكنهم اليوم يجدون أنفسهم في مواجهة قدر غريب، تُركوا وحيدين في مستنقع دموي، فارتفعت أصواتهم تطالب بالانفصال معبرة عن إحساس عميق بأن “الوطن” لا يتسع للمختلفين.
هذا هو وجعي اليوم مع سوريا التي أحببتها حتّى الفناء، غير أنّها ارتدت علينا وخذلت أهلها وناسها. وإذ أقف أمام هول المجازر وما خلّفته من خراب، لا يمكن أن يعلو رأيّ على أصوات الذين عاشوا المأساة بكلّ تفاصيلها، وشاهدوا الرعب والدمار عن كثب، وحملوا الوطن في دمائهم وهو يتفتّت أمام أعينهم، فكلّ شارع، كلّ جدار، وكل زاوية من أرض السويداء صدى لآلاف الضحايا الذين لم يسمعهم أحد، صوتي مخنوق أمام صرخاتهم.
إن انشطار الروح ومواجهة الذات تبدأ بجرأة قراءة التاريخ ونقده، وبسؤال
 واضح من نحن؟ ومن هم؟
واضح من نحن؟ ومن هم؟
استهدفت المجازر الأقليات بسبب هويتها الدينية أو العرقية، وليس لأفعال ارتُكبت، فأي محاولة لتجاوز هذه الحقيقة باسم الوحدة الوطنية، مهما بدت النوايا صافية، تمثل تعاليًا على جراح الآخرين وإغفالًا للواقع، العمق الوطني الحقيقي يظهر حين نعترف بالحقائق كما هي.
الشجاعة اليوم تكمن في مواجهة الوجه الحقيقي للوطن، والاعتراف بما أُخذ، وما ضاع، وما أُهمل، والسعي الجاد لإعادة بناء عقد اجتماعي يحمي الأقلية ويمنع الأكثرية من احتكار معنى الوطنية. ذلك يتحقق من خلال مواطنة متساوية محميّة بقوانين صارمة، احترامٌ كامل للاختلاف، وحماية كرامة كل إنسان. هذا هو الضامن الوحيد لمستقبل مشترك ووطن واحد، وإلا فإنّنا ذاهبون نحو دول، حتى لو دُعمت السلطة الحاكمة من المجتمع الدولي كلّه، لن تُغيّرَ من حقيقة الانقسام والاغتراب الذي نعيشه.
هذه شهادة على ما عايشته، ربما أكون مخطئة وأعتذر في السنين القادمة لسوريا والسوريين، وربما أجد راحتي وأحلامي في وطن آخر يُشبهنا اخترناه لأنفسنا.
نهى سويد