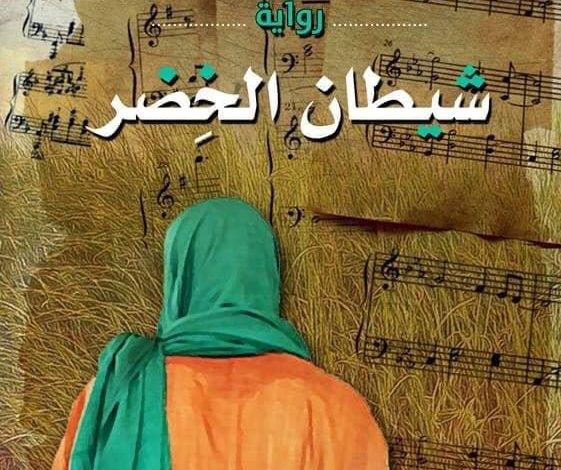

في إطار فعالياته الثقافية المستمرة، يستضيف المنتدى الثقافي المصري مساء (الأربعاء الموافق 7 مايو 2025)، ندوته التاسعة التي تنظمها لجنة الأدب والشعر، تحت عنوان “تجربتي بين الطب والأدب”، ويحاضر فيها الأديب الكبير الدكتور محمد إبراهيم طه.
وتُعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بمقر المنتدى الكائن في 1101 كورنيش النيل، جاردن سيتي، القاهرة، حيث يسلّط الدكتور طه الضوء على تجربته الفريدة التي جمعت بين ممارسة مهنة الطب وكتابة الأدب، وما وفرته له هذه الثنائية من رؤى ومعانٍ إنسانية أغنت كتاباته.
وتدير الندوة الأستاذة الكاتبة نجيبة المسلمي، عضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة الأدب والشعر، التي أكدت أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعزز الحوار بين الممارسات الإبداعية والمجالات العلمية، وتستضيف نخبة من المبدعين المصريين.
يحظى اللقاء برعاية ودعم أ.د. حاتم قابيل، رئيس مجلس الإدارة، وأ. محمد حماد، السكرتير العام وويأتي هذا النشاط ضمن رؤية المنتدى لتعزيز المشهد الثقافي في مصر، عبر استضافة رموز الفكر والإبداع وإتاحة المنصة أمامهم للحديث عن تجاربهم الملهمة.
عن الرواية الأيقونة “شيطان الخضر” للدكتور محمد إبراهيم طه ، كتب الشاعر والمترجم والروائي قراءته تحت عنوان (شيطان الخضر … رواية الطقوس )، وجاء فيها:
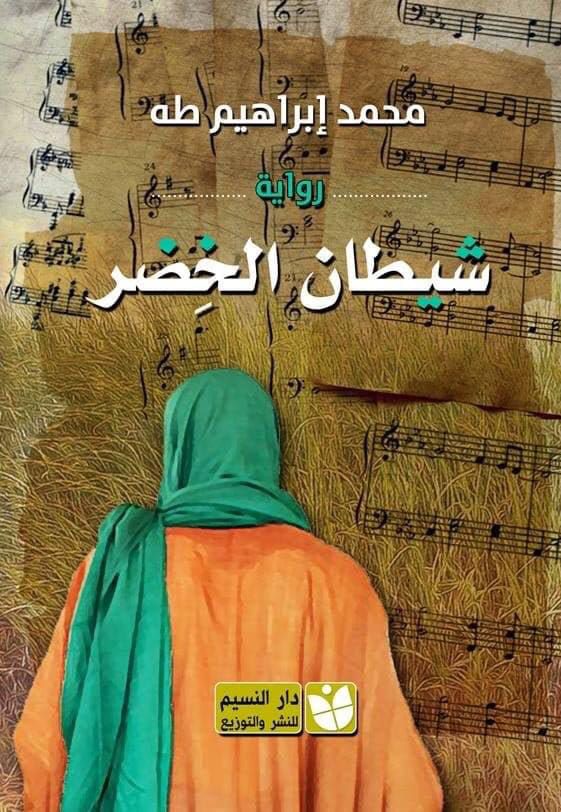 الطقوس هي كلمة السر ومفتاح الرواية البديعة (شيطان الخضر) للكاتب محمد إبراهيم طه، تلك الطقوس التي تبدأ من المشهد الأول ولا تبتعد أبدا عبر مشاهد الرواية، التي تتكيء على ذاكرة شعبية ريفية. لكن قبل الدخول للنص الروائي، علينا مساءلة العنوان، فالخضر في الوجدان الشعبي يستند في حضوره إلى القصص القرآني، في سورة الكهف، وأن تلصقه بالشيطان، فهذه مقابلة محفوفة المخاطر، وربما تستثير المخيلة، قبل إثارة الشك، في معاني النص المضمرة والظاهرة.
الطقوس هي كلمة السر ومفتاح الرواية البديعة (شيطان الخضر) للكاتب محمد إبراهيم طه، تلك الطقوس التي تبدأ من المشهد الأول ولا تبتعد أبدا عبر مشاهد الرواية، التي تتكيء على ذاكرة شعبية ريفية. لكن قبل الدخول للنص الروائي، علينا مساءلة العنوان، فالخضر في الوجدان الشعبي يستند في حضوره إلى القصص القرآني، في سورة الكهف، وأن تلصقه بالشيطان، فهذه مقابلة محفوفة المخاطر، وربما تستثير المخيلة، قبل إثارة الشك، في معاني النص المضمرة والظاهرة.
ولكن بقراءة أخرى يمكن أن يكون (الشيطان) في العنوان إشارة للجنوح والثورة والعبث، والمروق أيضا. من الجميل أن طفولتنا مرتبطة بالأماكن التي ترددت عبر الرواية، وهو ما يضفي متعة إضافية على استنطاقها في متون الأحداث. إذ تبدأ الرواية عندما يقوم “الخضر” وقرينه “المنعكش” – سنلاحظ تلك الثنائية في جذور الحكاية الأصلية – بالتحضير لصلاة الفجر بجامع البحر، حيث يسأل “الخضر” “المنعكش”- الذى لايسير بغير المسجل الصوتي، والمغرم بصوت نجاة الصغيرة وملائكيته، بأنه يميل إلى السّور التي تدور آياتها حول القصص، لذلك هو يريد منه أن يتلو الآيات التي يربطها سياق قصصي، وبعد القراءة والتجلي يتحول المنعكش إلى إنشاد : “إلهي ما أعظمك فى قدرتك وعلاك… إلهي ما أرحمك فى غضبتك ورضاك” فيتجاوب معه الخضر وينّغم بصوته معه. لكن المنعكش يفتح ماكينة الصوت ليخرج الصوت من ميكرفون الجامع إلى الناس، ويتوافد المصلون من كل فج، ويتمايل الأخرس بعينين دامعتين، وكأن النداء والنغم حركا حتى ما لم يستطع السماع أن يحركه، غير أن ذلك لم يأت على هوى المشتغلين بالدين الرسمي، فيصدر الأمر بمنع كل من “الخضر” والمنعكش” أو “يوسف” من المبيت بالجامع .
هذه الحكاية الأم؛ المواجهة بين الشعبي والرسمي، تتوالد عنها حكايات تتناثر على الطرقات والصفحات، وهكذا لن يجد القارئ سلسلة أحداث، وإنما هو حدث متناسخ، بطله ” شيطان الخضر ” الصغير أبو طالب ، ويوسف المنعكش رفيقه وصاحبه الذي يكبره بعشرين عاما، وكأنهما بحكاياتهما يدقان جرسا مسرحيا تتوالى المشاهد ويرفع ستار ويسدل آخر ، وتجد المواجهة مرة بعد أخرى، وكأننا في طقس صوفي، نتأرجح فيه برؤوسنا، مرآة لتأرجح أفكارنا، المبطنة والمعلنة.
يعاتبه صديقه الخضر : – تشغل مزيكا في بيت ربنا ؟! -لعلمك لم تُخلق الموسيقى إلا لتسمع في بيوت الله ! يقترب طقس محبة تشغيل القرآن والموسيقى من أن يكون خاصة مصرية، وصفة تجمع كل المشتغلين بالإبداع، عموما، والأدب على نحو خاص، وهكذا سترانا، مع المؤلف، نضفر أيامنا بموسيقا الحياة الدنيا والآخرة، ونصنع طقوسنا اليومية، والأبدية، ونكرر دون ملل، حالتي الاستماع والاستمتاع لنرتقي بهما ولها ووجدا في آن. وإذا كنا نرى مفتاح الرواية في طقوسها، فلعلنا أيضا نشير إن طقوسها اللغوية، التي حرصت على تدبيج آيات النص الديني، وأمثال الموروث الشعبي، وكلمات الأغنيات المختارة، ودعابات الروح الساخرة، وكأن ذلك الطقس اللغوي جزء أصيل من كتابة الرواية لدى محمد إبراهيم طه.
ولعل قدرة الكاتب على أن يكون ذلك كله مزيجا متجانسا، يأتي من حرصه على أن يكون صوت ذاته المبدعة، فهو لا يقلد أسلوبا، وإنما ينشيء أسلوبه الخاص، الذي تتسلل له العامية بشكل ساحر، لا تكاد تشعر إلا بفصاحتها الشعبية. وهكذا أعادني شيطان الخضر إلى مسقط رأسي، بنها، وربما نكش الذاكرة لأفتش عن الأماكن الباهتة في فضاءات المخيلة، والشخوص المنسية في مسارات الحياة، فكان كمن يرسم بماء سحري، تظهر خطوطة حينما تلتهب الأحداث. فخلتني أعرف الشخصيات، وكأنني قابلتهم مرة أو أكثر، ولعلي اسمتعت إلى رواياتهم، أم أن الرواية نفسها هي طقوسنا نحن نوزعها على مدار السنوات، أعاد الكاتب صياغتها، ومنحها من روحه مثلما أسبغ عليها اسقاطات معاصرة، وكأن الطقوس الهادئة ترسم بإيقاعها موزاييك ثورة ما، ستنطلق حين تكتمل اللوحة، ثورة بدأت بمواءمة بين الديني والدنيوي، وربما تصل لمطابقة بين الحلم والواقع.
أما الطقس الأكثر حضورا، فهو استخدام الموسيقا، ليس فقط باستدعاء الألحان والأغنيات والأصوات والكلمات، وإنما بأن تكون الموسيقا، تلك اللغة، تعريفا لكل شيء، للأشخاص، لمشاعرهم، لأحوالهم، ولمقاماتهم كذلك. المقام العربي هو نظام من السلالم الموسيقية المألوفة والعبارات والانتقالات المألوفة والزخارف التقليدية والجماليات المتفق عليها التي تشكل معاً تقليداً وتراثاً فنياً ثرياً. في هذه الرواية يكتب المؤلف وهو يترجم المقامات العربية: “ما الفرق بين راحة النفوس والحجاز؟”
يقول: “الأول مقدمة الصحراء، والثاني قلبها، عدت إلى راحة الأرواح، فصاحبني متمتما بهدوء كأنه يهمس إلى نفسه، ودخل في مناجاة هادئة وشفيفة ومُتَمَنِّعة مع تقاسيم تروح وتجيء دون أن ترتفع مناجاته إلى درجة البوح الصريح أو تخفت إلى درجة الصمت ظللنا في راحة الأرواح حتى تناهى إلى مسامعي: ادخلوها بسلام آمنین، نظرتُ إلى ملامحه، فرأيتها ساكنة، فانتقلت سبابتي تلقائيا إلى مقام الصبا. ظللت في الصبا” أروح وأجيء بين بُكاء صريح ورثاء أليم حتى أشرقت الأرض بنور ربها، ورأيت زهرة بابونج صفراء تنبت في موضعه، فخلعتُ الريشة والكستبان وقبل أن أنحي “القانون” جانبًا رأيت محفورًا على جانبه من الداخل: راحة الأرواح، لسان الفقير إلى عفو ربه حسن الجوخ.”
يبدو أننا أمام حقيقتين روائيتين؛ إما أن المنعكش هو المؤلف نفسه، أو أنه مجرد شخصية خيالية تم إدخالها للشك في شخصية القصة الأصلية؛ الخضر. “حين أخبرني المنعكش باسمه قبل سنوات، لم أعوّل عليه، وظلت روايته وحيدة بلا سند لأن جميع من سألتهم عنه بعد لقائي الأول به نفوا انطباق ما أقول من أوصاف على أحدٍ في الناحية؛ خالي الحسيني أبو راس خريج كلية الدعوة بالأزهر، والشيخ فتح الباب” الذي يعرف طوب الأرض، والشيخ شمس الدين أحمد رئيس فرقة “أهل الله”، وجمعة أبو الجود التربي، وكامل الحلاق الذي يعج دكانه بالزبائن، وإبراهيم المناخلي الذي كل يوم في سوق.
كنت أسأل بحرقة ولا جواب عن رجل طاعن في السن كنت معه، حتى “خنوفة” الذي وقف بيني وبينه بالسيارة على المزلقان قال: كنت لوحدك، فانتابني الكدر، وقطعت الطريق التي التقيته فيها لأول مرة من المدينة إلى البلدة عشرات المرات، ومن المزلقان إلى المقابر دون جدوى، جبت المدقات ورافقت الجداول حتى أوقفني المنعكش في ملتقى خليجين: – بتدور على حد يا أخينا؟ – أيوه – من البلد وللا غريب؟ – غريب – كبير وللا صغير ؟ – كبير وابتسامته هادئة ومطمئنة ومحدش دلني. – إنت سألتني ؟ قلت: “سألت الجميع إلا أنت، فاعتدل وكان مضطجعا تحت نخلة وأطفأ الراديو، وقال: اجلس فجلستُ طلب أن أكرر عليه بهدوء ملامح الرجل، فأعدتُها وهو يحدق في الأفق بعينين ضيقتين.




