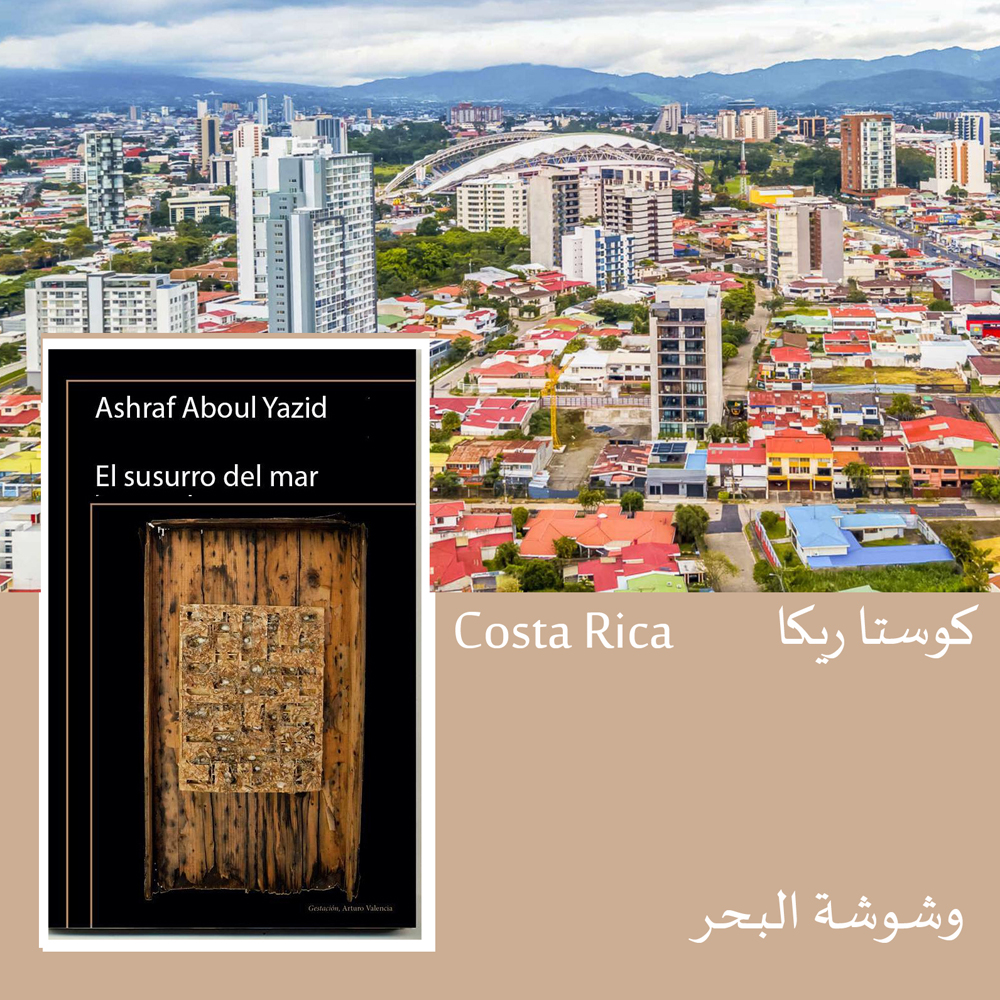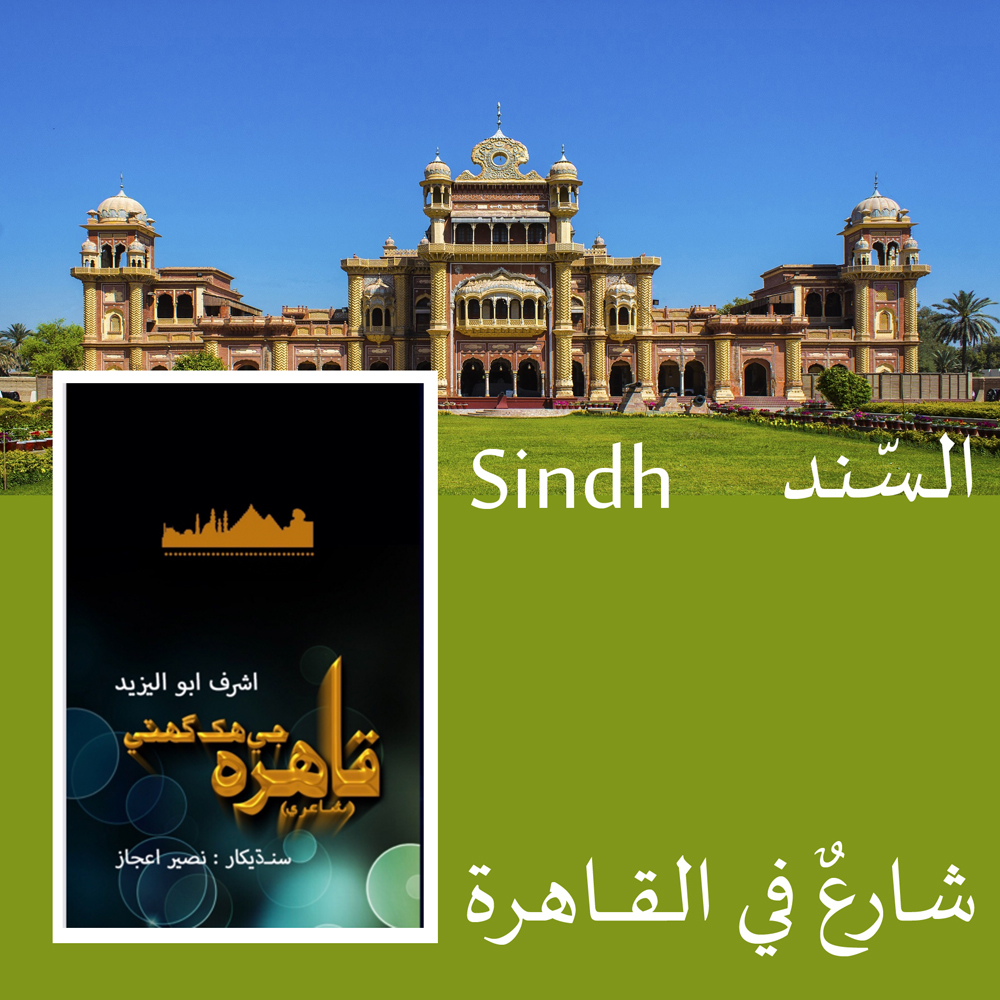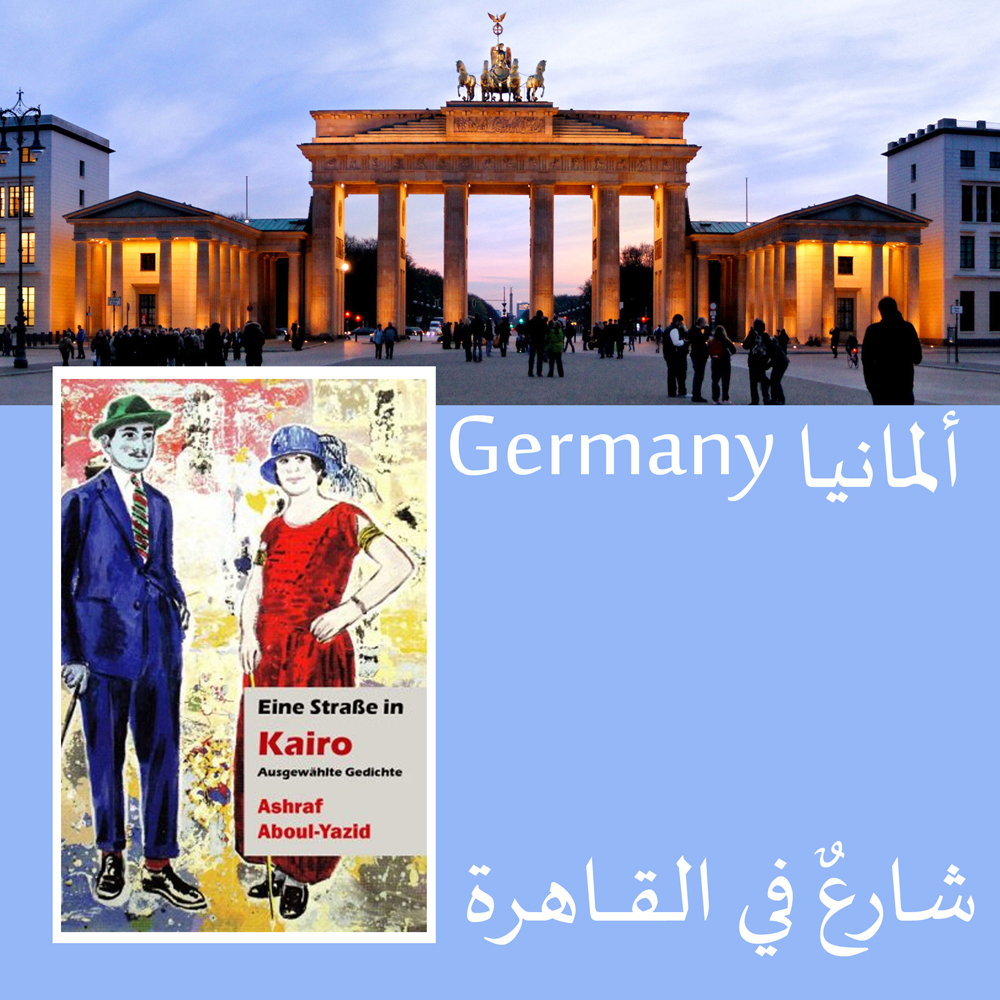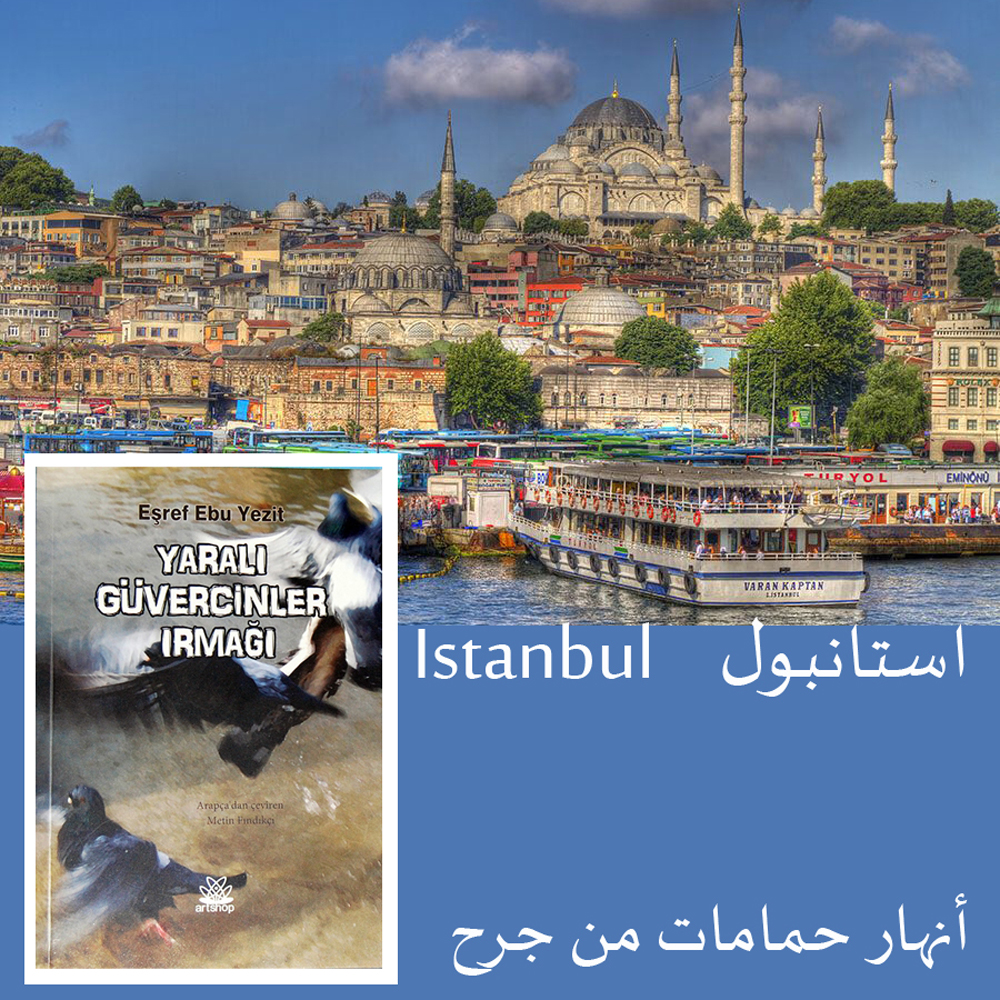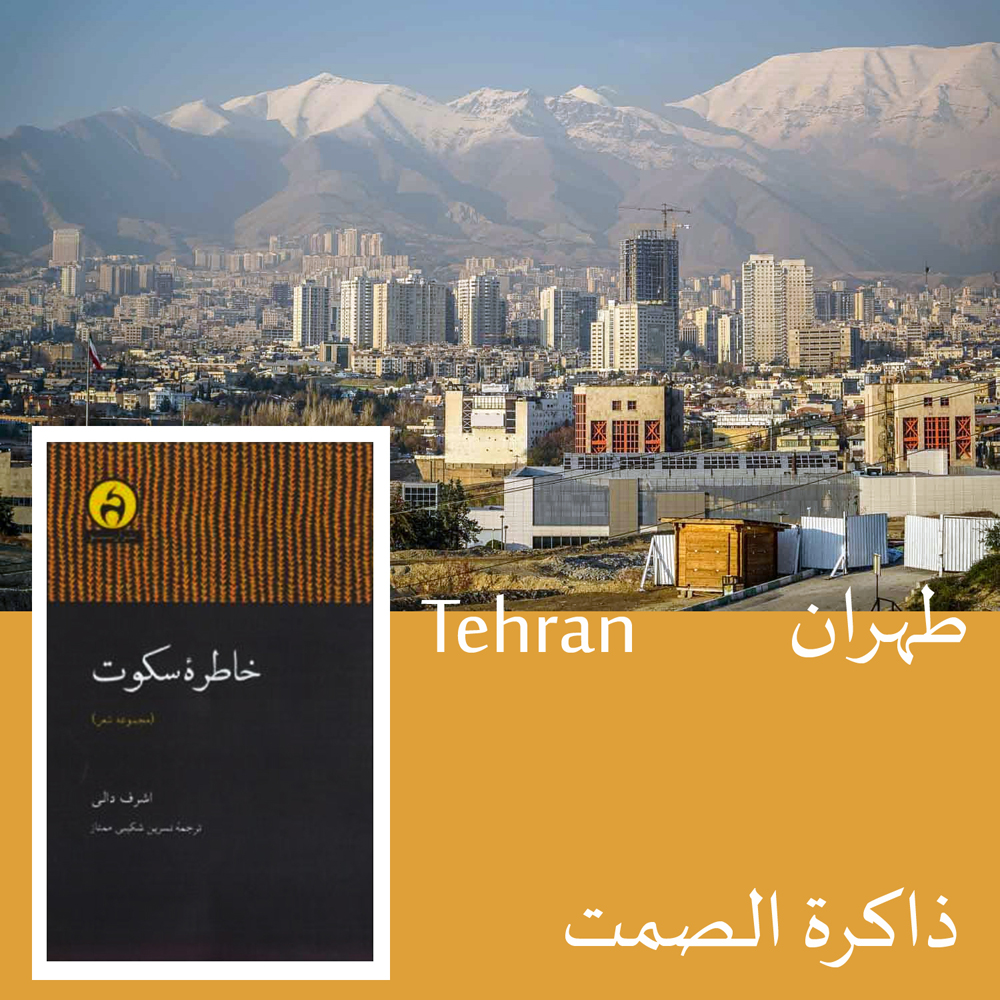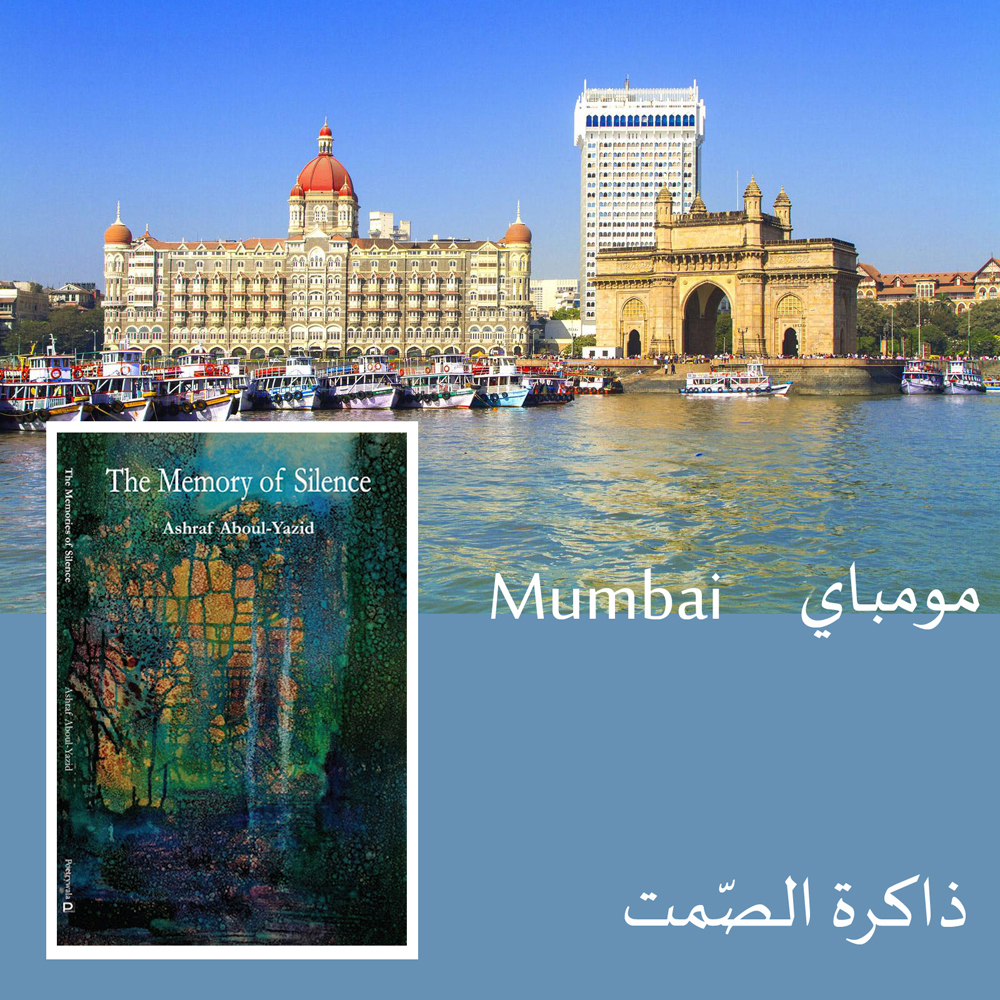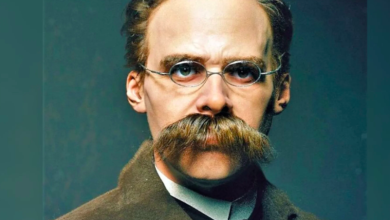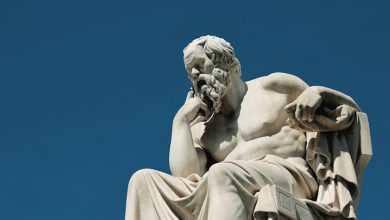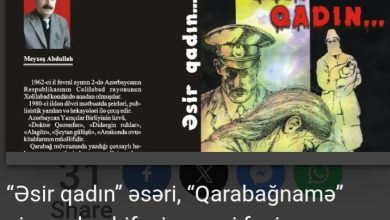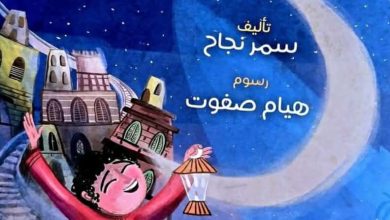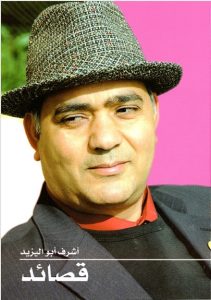
اختار الشاعر والكاتب أشرف أبو اليزيد مجموعة من قصائده التي كتبها على مدار أربعين عامًا، وجمعها في مختارات شعرية بعنوان “قصائد“، قسمها إلى سبعة أجزاء حسب سنة النشر، بداية من 1988م حتى 2024م، ليضع بين يدي القارئ ملامح تجربته الشعرية وتحولاتها على مدار أربعين عامًا. وفي هذه القراءة أسعى إلى رصد ما تيسر لي من ملامح وتحولات تجربة أشرف أبو اليزيد الشعرية على مستوى الرؤيا، والتشكيل الجمالي، والسمات الأسلوبية التي تميزها.
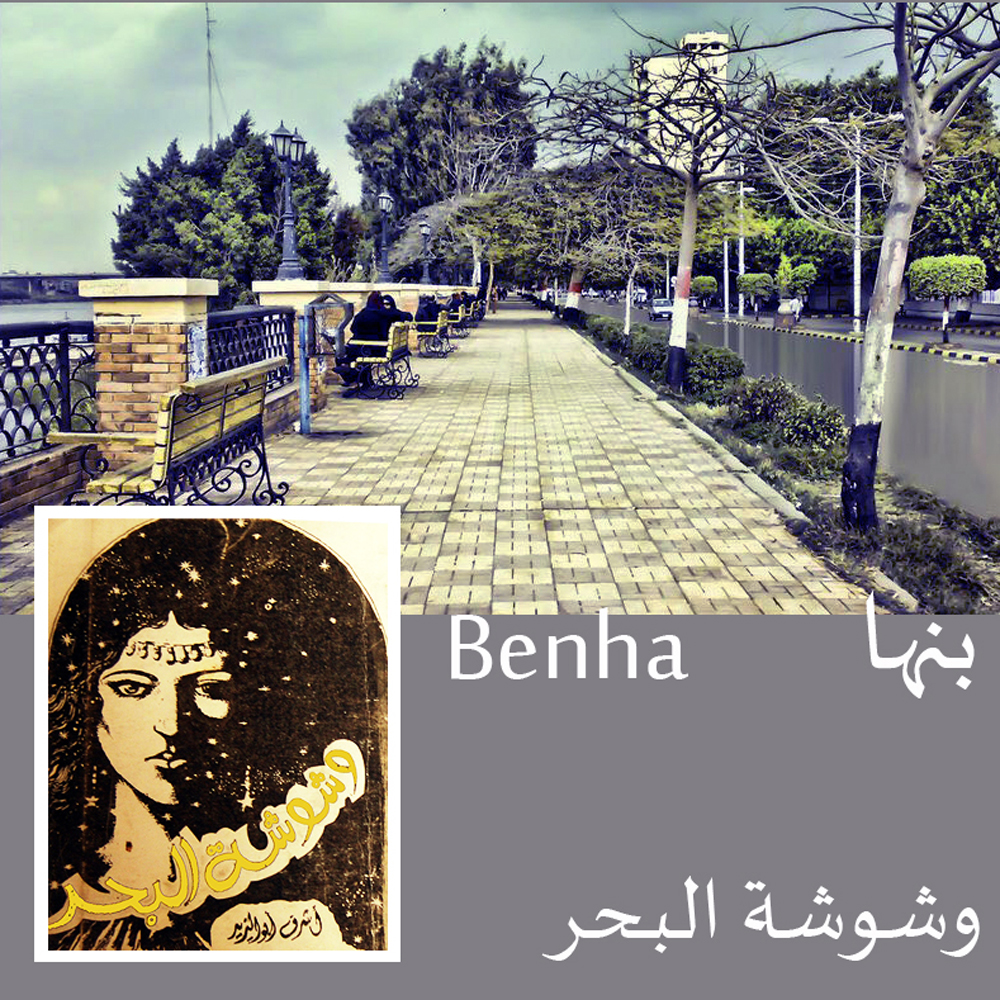 (1) “وشوشة البحر“
(1) “وشوشة البحر“
مجموعة قصائد نُشرت في سنة 1988م، وتتوزع قصائد هذه المجموعة بين القصائد التي تتناول السرديات الكبرى، والقصائد التي تميل إلى استخدام الرمز، وقصائد الإبيجراما.
السرديات الكبرى
من أمثلة القصائد التي يتناول فيها الشاعر السرديات الكبرى قصيدة “المدائن“، حيث يتناول الشاعر سردية الفارس العربي وخيباته الكبرى بحس قومي، فيقول في ص9:
الفارس العربي يخلع عن
ملابسه الدروع وينحني بعد الحدود
يشق قبرا بالأظافر والدم
قصائد الإبيجراما
من أمثلة قصائد الإبيجراما قصيدة “مسافر“ في ص16:
حين عدت من السفر
كان وجهك بارداً كدمائهم
كان كفك قاتماً كأكفهم
كانت الأحضان سداً
ـ لا ممر ـ
حين عدت من السفر
كنت قد سرت بطاقة
لم تعد أبداً بشر
الإبيجراما قصيدة قصيرة، مكثفة، تعتمد على المفارقة، التي تبدو في نهاية القصيدة عندما يتحول الشاعر إلى بطاقة بعد عودته من السفر. وسنجد أن السفر والترحال سيصبح ثيمة رئيسية مركزية في قصائد أشرف أبو اليزيد فيما بعد.
المشهدية اليومية
وقصيدة “صور ملغومة“ هي قصيدة محورية تنبئ بمرتكزات سيوظفها الشاعر في أعماله القادمة، من حيث المشهدية ورسم صورة حسية في مخيلة القارئ، وكأنه يشاهد القصيدة ممثلة على خشبة مسرح أو شاشة عرض. فالقصيدة مكونة من مجموعة من المشاهد الشعرية تقوم على الانطلاق من الهامش وشعرية اليومي والمعيش، وتحويل اليومي والمعيش إلى بؤرة ينبثق منها الشعر، عبر نزعه من حقل الإدراك العادي وتوظيفه في سياق شعري يمنحه دلالات جديدة.
ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في ص8:
في الميدان رأيت على الأرصفة الملساء ككف بحيرتنا
طفلاً نزعوا منه فتيل برائته
فتناثر شحاذاً مهوساً منبوذاً
في الميدان العام
كانت سيدة تدخل حانوتاً
خطوات تسبق نبض الريح
تتحدث لبائع
فيناولها من أحد الأرفف طفلاً
ـ في المهد يصيح ـ
فتجلس ترضعه
والبائع ينظر للساعة، يخطف منها الطفل
فتخرج ما معها من مال
كي تستكمل إرضاع الطفل، فيأبى
في الميدان العام الأكبر:
الطفل المنبوذ يسير، تهرول سيدة
يصدمان فينفجران
فتغمر أرصفة الميدان دماء ساخنة
ما تلبث أن تتجمد
في المشهد الأول، صورة الطفل الذي لا يجد أمًّا وتحول إلى شحاذ مهووس، وفي المشهد الثاني، صورة أم تبحث عن طفل تمنحه أمومتها. ويربط التضاد بين الصورتين الملغومتين. وفي المشهد الثالث، الميدان الكبير يصطدم الطفل بهذه السيدة فيحدث الانفجار. ويمكن أن نعتبر هذه القصيدة إبيجراما، فالأم والطفل، بدلاً من أن يجد كل منهما في الآخر ضالته، تحدث المفارقة الموقفية التي تجمع بين المتوقع واللا متوقع في موقف واحد. وستكون المفارقة فيما بعد أحد أدوات بناء النص عند الشاعر أشرف أبو اليزيد، إلى جانب أن قصيدة الإبيجراما ستستمر موجودة في أعماله التالية مع القصائد الطويلة.
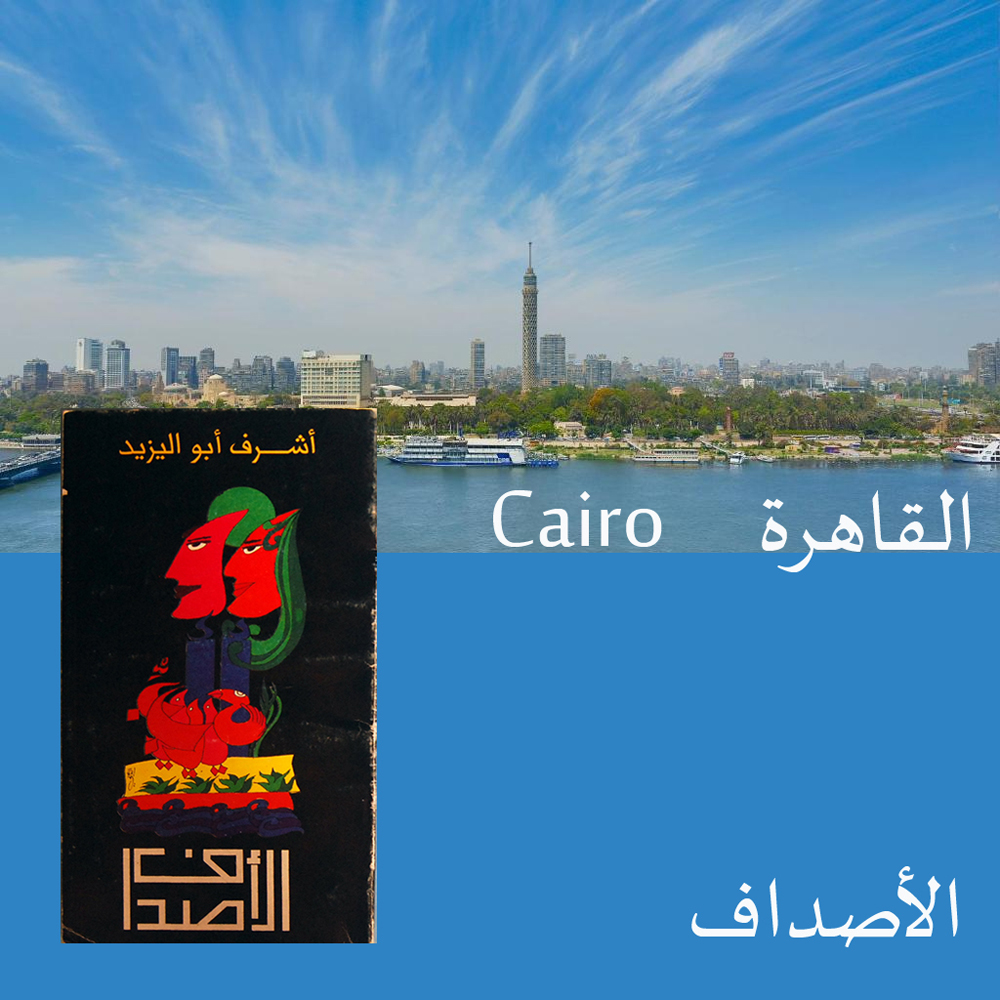
(2) “الأصداف“
قصيدتان هما “البحر“ و*”الأرض الغضب”* يعود تاريخ نشرهما إلى سنة 1996م، وتبدو فيهما شعرية التمرد والترميز؛ تحويل الكائنات والأشياء إلى رموز شعرية عبر شحنها بالطاقة الإيحائية وتوظيفها في سياق شعري. وسيصبح الترميز فيما بعد أحد السمات الفنية في شعر أشرف أبو اليزيد.
في قصيدة “البحر“ ص30، يقول الشاعر:
هو البحر
أنت العروس
فإن همَّ: همّي به أنتِ لا تنكصي
وشقي قميصه
فمن روَّض البحر غير الشواطئ
وشقي بنور الفنارات ليل المرافئ
ففي غفلة البحر أو غفلتك
تباح الموانئ
عروس البحر هي رمز المحبوبة أو الحلم أو الوطن، والبحر هنا رمز للسفر والغربة. حوله الشاعر إلى كائن يبدو متوحشًا، لا تروضه الشواطئ التي تكبح جماحه وتمثل حدودًا صارمة لا يتخطاها. وعندما يشق نور الفنارات الليل في غفلة البحر، تكون الموانئ مباحة للغرباء المسافرين.
 (3) “ذاكرة الصمت”
(3) “ذاكرة الصمت”
مجموعة قصائد نُشرت سنة 2000م، ترتكز قصائد هذه المجموعة على شعرية الذاتي والخاص، وتذويت مرجعيات وقضايا الواقع المعيش، أي صبغها بالرؤية الذاتية، فتتحول من سردية كبرى “عامة” إلى سردية خاصة بالذات الشاعرة. وبذلك تبلورت ملامح ما بعد الحداثة بشكل كبير في هذه القصائد، من مشهدية، وشعرية اليومي والمعيش والخاص، وتفكيك السرديات والقضايا والمفاهيم الكبرى، والتمرد والشك وإثارة الأسئلة.
إلى جانب ذلك، تميزت شعرية أشرف أبو اليزيد الخاصة بـ:
- ترميز الأشياء والكائنات،
- التناص مع التراث العربي والعالمي،
- النزعة التأملية التي يتماهي فيها الوجداني بالفلسفي والمعرفي في سبيكة شعرية واحدة،
- بروز ثيمة الترحال والسفر كثيمة محورية في شعره.
ومن أمثلة شعرية الذاتي والخاص، والنبش في الذاكرة بحثًا عن نقطة البداية وإثارة الأسئلة، وأنسنة الأشياء وتشيؤ الإنسان في مشهدية شعرية، قول الشاعر في قصيدة “حب“ ص41:
لما زرت مدرستي القديمة
ودخلت صالة الدرس القديمة
كان الولد الجالس فوق مقعدي القديم
لا يشبهني أبدًا
لكنّي أحببته
الولد الجالس على مقعد الشاعر القديم لا يشبهه، إلا أنه أحبه لأنه يذكره بنقطة البداية. فالأماكن القديمة ليست صامتة بل كائنات حية تلقي بظلال الذكرى على وجوه المارة في الطرقات التي عبرناها ذات يوم. وقد يكون هذا الولد هو الشاعر نفسه وقد تغيرت ملامحه بفعل الزمن، أو قد يكون ولداً آخر يجلس في مكانه.
وعن الذاكرة والاغتراب يقول الشاعر في قصيدة “ذاكرة الصمت“ ص44:
ما عادت أحلام الأمس تهرول فوق وسائدك
وفي نفس القصيدة ص47:
للأحياء مسوح الموتى
للموتى رائحة الأحياء
وأنا أتوزع بينهما
يبدو هنا تشظي الذات وتبعثرها ليس بين الأمكنة والأزمنة فقط، بل هو تشظٍ وجودي، فالذات تتوزع بين الأحياء والأموات، تبحث لنفسها عن موضع قدم.
الشكل الفني للنص
في مجموعة قصائد “ذاكرة الصمت“ تظهر سمة شكلية تتعلق بالشكل الفني للنص، وهي التجاور والتنوع بين قصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر، وقصيدة الشعر الحر. وستظل هذه السمة ملازمة للشاعر أشرف أبو اليزيد.
قصيدة النثر، كما هو معروف، شكل شعري يقوم على كتابة الشعر بخامة النثر المغايرة لخامة النظم العروضي، بآليات ورؤى فنية جديدة. وقد أحدثت نازك الملائكة خلطًا كبيرًا عندما أطلقت على شعر التفعيلة مسمى الشعر الحر، بينما الفرق بين الشعر الحر وشعر التفعيلة من ناحية البنية الموسيقية كبير. فشعر التفعيلة يعتمد في موسيقاه على تكرار تفعيله واحدة لا تتغير طوال النص الواحد، أما الشعر الحر فموسيقاه حرة قائمة على اعتصار موسيقى اللغة والمزج بين التفعيلات الموسيقية إذا تطلبت الضرورة.
ومن أوائل من وضحوا هذا المفهوم للثقافة العربية، وإن لم يكن الأول، الشاعر أمين الريحاني في مقدمة ديوانه “هتاف الأودية“ عام 1910م، حيث قال:
شكسبير أطلق الشعر الإنجليزي من قيود القافية، و”والت وايتمان” قد أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية والأبحر العرفية، على أن لهذا الشعر الطليق وزناً جديداً مخصوصاً، وقد تأتي القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة.
وربما يكون خلط نازك الملائكة بين التفعيلية والحر هو السبب في عدم تشكيل تيار شعر حر بمفهومه عند “والت وايتمان” في الأدب العربي، إلا في قصيدة العامية وتجارب معدودة على الأصابع في شعر الفصحى، مثل بعض قصائد محمد الماغوط، ومن الشعراء المعاصرين: رفعت سلام، وأشرف أبو اليزيد. ولعل ذلك يعود إلى دراية رفعت سلام بالشعر الحر الفرنسي الذي كتبه رامبو في ديوان “إشراقات“ سنة 1868م، وهو مختلف عن قصيدة النثر التي كان رامبو من روادها، ودراية أشرف أبو اليزيد بمفهوم الشعر الحر عند “والت وايتمان” في ديوان “أوراق العشب“ 1855م، وهو أول ديوان شعر حر في تاريخ الأدب.
مثال للشعر الحر
في مجموعة قصائد “ذاكرة الصمت“، قصيدة “قطار يعبر الصحراء“:
البلاد التي تشبه قطار يعبر الصحراء
ساحباً وراءه
توابيته المكيفة
تلون نهديها الشمس
وتصيغ جسدها بالمروج التالفة
تصرخ بين محطتين من السراب
ووهم من الأرصفة
يبدو في هذا المثال الشعري حسٌّ موسيقي واضح، لا يخضع لنظام وحدة التفعيلة، بل تنبثق موسيقاه من داخل التجربة، تقوم على الدمج بين الوحدات الموسيقية كما يقوم العازف بتركيب وتوليف النغمات في لحن واحد.
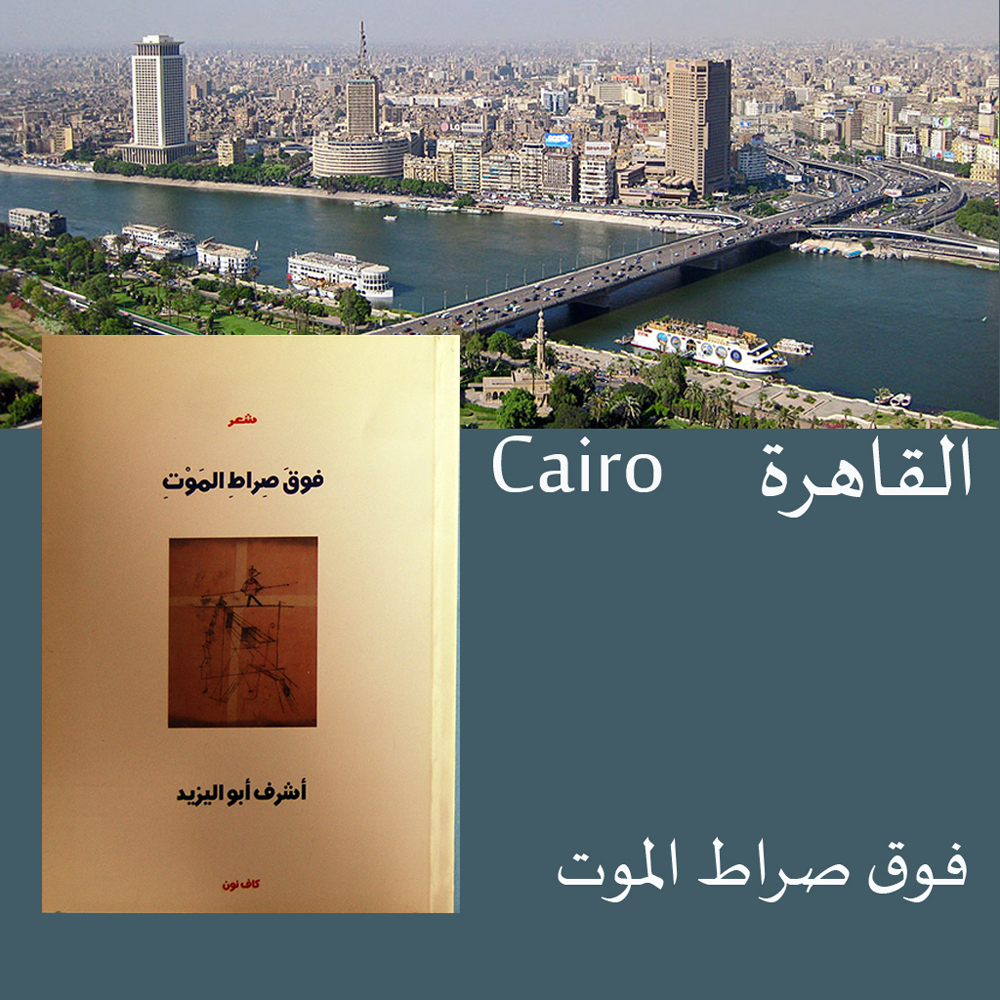
(4) “فوق صراط الموت”
مختارات من قصائد نُشرت سنة 2001م، وتتسم شعرية هذه القصائد بالدمج بين اليومي والمعيش والرمزي.
في قصيدة “حافلات“ يقول الشاعر أشرف أبو اليزيد في ص56:
الحافلة التي وقفنا طويلاً بانتظارها
ابتلعتنا في حشرجة ملوثة
ومضت تعبر الطريق
وتدوس الزمن
محطة.. محطة
ترش النهار بالدخان
وتبدو الرمزية واضحة من خلال تحويل الحافلة إلى رمز عبر شحنها بالطاقة الإيحائية، فقد تكون هذه الحافلة الحياة ذاتها من وجهة نظر شاعر رحالة يتجول بين الأزمنة والأمكنة.
ثم يقوم الشاعر بالدمج بين هذه المشاهد الرمزية ومشاهد من الحياة اليومية:
أتأمل امرأة
تحمل عبء أمومتها
على نهدين انسدلا
كأسيرين
وأرى رجل يعبث بمؤخرة مترهلة
أو جندي يكمل نومه بفم مفتوح كحذاء مهترئ
وقاطع الطريق والتذاكر
ـ ما محطتك؟ ـ القادمة
الحافلة التي سكبنا أيامنا فوق مقاعدها لم تبصقنا أبدًا حيث نريد، وكان علينا حين نغادرها أن نبحث عن حافلة أخرى. هكذا يدمج الشاعر بين اليومي والمعيش والرمزي: الرجل الذي يعبث بمؤخرة امرأة مترهلة في الزحام، والجندي النائم وفمه مفتوح مثل حذاء مهترئ، ورمزية قاطع الطريق والتذاكر، والحافلة التي تمثل رمز الحياة من منظور شاعر رحالة.
تجول الحافلة بين الأمكنة والأزمنة، ولا تلفظنا من فمها كما نريد، ولذلك علينا قبل أن نتركها أن نبحث عن حافلة أخرى، أو نظل كما نحن، يتفاذفنا موج الغربة والترحال دون العثور على ميناء يشبه أرواحنا.
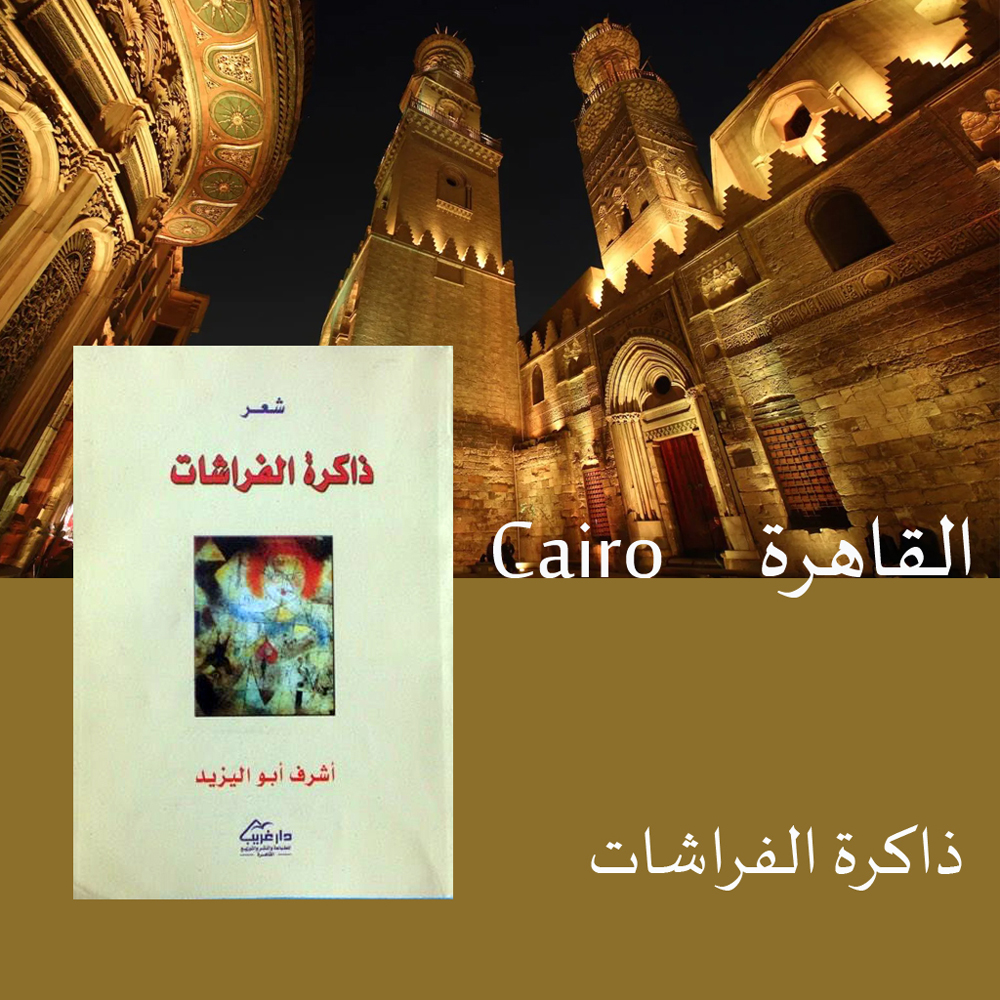 (5) “ذاكرة الفراشات“
(5) “ذاكرة الفراشات“
مختارات من قصائد نُشرت سنة 2014م، بعد أربع سنوات من صدور “ذاكرة الصمت“ التي تقوم على النبش في المسكوت عنه لتعبر عن حالات الذات وتشظّيها.
فإن ذاكرة الفراشات تعبر عن تحولات الذات ورؤيتها للبدايات والنهايات والغربة بشكل جديد، حيث يقول الشاعر أشرف أبو اليزيد في قصيدة “شارع في القاهرة“ (ص60):
الرجل العائد في إجازته القصيرة
ليس لديه سوى يومان
يوم يصل
يوم يتهيأ للرحيل
يوم يراها فتبكي
يوم يبكي وهو يودعها
يوم يفتح للأصدقاء ذراعيه
يوم يضم السراب
بين العودة والرحيل تتقلص المسافة الزمنية، وتتبدل فيها الأحوال والمواقف بإيقاع سريع لاهث، وتكثر الجمل الفعلية المعبرة عن تحولات الذات في هذه القصيدة. كما أن الشاعر لم يقم باستخدام أداة عطف للربط بين السطور الشعرية، وبوجه عام تقل أدوات العطف كرابط لغوي في قصائد هذه المجموعة، مما يسهم في التعبير عن سرعة إيقاع التحولات وخفة تحليق الفراشة التي ترمز للذات الشاعرة.
بين غربة الحلم وغربة الجسد، وغربة الزمن، يدمج الشاعر أشرف أبو اليزيد بين الحلمي والكابوسي والرمزي واليومي والمعيش، ويقدم رؤيته الخاصة للعلاقة بين البدايات والنهايات، حيث يقول في قصيدة “رحلة أولى.. رحلة أخيرة“ (ص64):
يمضغ أذنيك الصوت الحادي من بعيد:
الرحلة الأولى
هي الرحلة الأخيرة
يستدعي الشاعر رمز الحادي الذي يقود العير في الصحراء من التراث العربي، ليربط بين البدايات البعيدة والنهايات، وكأن النهاية هي وجه آخر للبداية في صحراء الغربة والاغتراب طوال سنوات العمر التي قضاها الشاعر الرحَّالة.
وفي قصيدة “مائة رسالة إليها“ (ص86) يقول الشاعر أشرف أبو اليزيد:
لا يعنيني أن أبدل التاريخ
أو أغير العهود القديمة
وأحرقها
جئتك كي نكتب تاريخاً آخر
أو نكونه
التحولات هنا لا تتمثل فقط في تحولات المواقف والأحلام، بل تطال المفاهيم الكبرى كالتاريخ. فالشاعر لا يبحث عن التاريخ القديم ليبدله أو يحرقه، بل يبحث عن تاريخ آخر يعيشه.
(6) “خرائط السراب“
مختارات من قصائد نُشرت سنة 2013م، تنتمي قصائد هذه المجموعة إلى قصيدة الإبيجراما، مع الدمج بين اليومي والمعيش والرمزي. أغلبها على وزن تفعيلة بحر المتدارك “فعلن”، وهي تفعيلة بسيطة شبهها العرب قديمًا بإيقاع صوت حوافر الخيول، ومن أكثر التفعيلات التي تتناسب مع الحوار، ولذلك كثر استخدامها في المسرح الشعري. وقد أشرت سابقًا إلى وجود قصيدة الإبيجراما بشكل ملحوظ في شعر أشرف أبو اليزيد، فلا تخلو مجموعة شعرية لديه من عدة إبيجرامات.
قصائد “خرائط السراب“ عبارة عن حالات شعرية للذات الرحّالة بين الأمكنة والأزمنة، كما في قصيدة “خريطة لمدينة ودعها“، حيث يبحث الروح عن فردوسها القديم فتتحول في النهاية إلى تمثال في أسطورة، حيث يقول (ص90):
خريطة لمدينة ودعها
سيعود صبي يبحث عن بيت الجارة
لن يبصر في الشرفة غير الواردات
سيدق فلا يخرج
غير الخفاش النائم
يبحث عن بدعة الموت
رغم ظلال الغابات الأسمنتية
سيفتش في الطرقات حوالين البيت
لعل إشارات الحب
- نحتها فوق الأشجار –
ستبقى
وينام اليأس بعينيه على العتبات المهجورة
يبحث عن بوابات تخرجه من هذا التيه
لكن يبحث عن كلمة سر تحيه
ثم يشيخ
يتحول تمثالًا في أسطورة
تبدو اللغة مكثفة وتعتمد القصيدة على المفارقة في نهايتها، وهي مفارقة موقفية تجمع بين المتوقع واللامتوقع، وهذا النوع من المفارقات يعتمد عليه أشرف أبو اليزيد في كثير من قصائده.
ومن ناحية المساحة النصية للإبيجراما، فقد تبدأ من عدة أسطر وتصل أحيانًا إلى عشرين سطرًا مثل قصيدة “خريطة لمدينة ودعها“. ومن الإبيجرامات التي لا تتعدى مساحتها النصية جزءًا من صفحة، قصيدة “خريطة بيت هناك“، وهي مكونة من ثمان أسطر، حيث يقول الشاعر (ص94):
بيت أسكنه هناك
يشهق كطواحين الدون كيشوت
يبدو من بُعد “شاهد قبر”
تقترب تراني
مصلوبًا في شرفته
أراقب أسراب النورس
أتحسس جنحي الضامر
تبدو هنا المفارقة الموقفية التي تجمع بين المتوقع واللا متوقع. فالشاعر يقيم في بيت بعيد يرمز للغربة، ويبدو للناظر من بعيد كأنه شاهد قبر والشاعر مصلوب في شرفته يراقب أسراب النورس. وتأتي المفاجأة غير المتوقعة في أن هذا الشاعر المصلوب لديه جناح ضامر، وأنه كان مثل الطيور في يوم من الأيام، وتحسسه لهذا الجناح ليس لقطة عابرة، بل يرمز إلى دلالات عدة قد توحي بالنبش في الذاكرة، أو الحزن والحسرة على حال هذا الجناح الضامر من قلة الطيران أو أسباب أخرى، وربما يوحي هذا التحسس برغبة الشاعر في إيقاظ هذا الجناح ليعود إلى الطيران مرة أخرى.
(7) “راهب رأس الجبل الأشيب”
مختارات من قصائد نُشرت سنة 2023م، يدمج الشاعر أشرف أبو اليزيد في قصائد هذه المجموعة بين اليومي والمعيش والذاتي والرمزي والأسطوري، حيث يقول في قصيدة “كيف الحال“ (ص102):
سألتني أمي
وهي تلف الكفين على كفي
كجناح حر
كيف الحال؟
قلت ـ وألثم كفيها عشقًا ـ
أن أحلى مما فيه المرء جدال وسجال
فأنا أفطر فوق سحاب
وعشائي في الغاب
ونهاري محض محض خيال
في هذا المقطع يربط الشاعر بين سؤال الأم عن الأحوال، وهو سؤال عادي نسمعه كثيرًا في حياتنا اليومية، وبين أسطرة الذات، أي: تلوينها بملامح خارقة تبدو أسطورية. ثم يقول:
كي أرتاح وضعت العقل على الرف
بين كتاب وعقال
وتركت القلب الثائر نعاسًا
كالجرو بباب الكهف
قالت: ومتى يرجع نهر أدمنه السفر
فيكون نزالًا
قلت: الأرض معلمتي الأولى
بركان قد يخمده مطر حِينًا
ودوام الحين محال
في أسطرة القصيدة، أي تحويلها إلى شبه أسطورة، ترك الشاعر قلبه وعقله وعاش بروحه وخياله كالنهر المتدفق ملتحمًا بظواهر الطبيعة. النهر الذي أدمنه السفر من منظور الأم هو الشاعر، والأرض هي التي علمت الشاعر صياغة الأساطير لتحل محل الواقع المعيش، الذي تمرد عليه.

وفي مجموعة “راهب رأس الجبل الأشيب“ يستدعي الشاعر رموزًا من الثقافة الإنسانية ويجري حوارًا معها، حيث يوجد رابط بين الذات الشاعرة وهذه الرموز، مثل الشاعر التايواني “كاوشيونج”، ومن أبرز موضوعات شعره الحنين إلى البر الرئيسي للصين بعد الحرب الأهلية وانفصال تايوان عن الصين سنة 1949م. وهو من شعراء المنفى الثقافي، حيث كتب عن الوطن المفقود والتجربة الممزقة بين الصين وتايوان، وعاش فترة من حياته مغتربًا متنقلًا بين أمريكا ودول أوروبا.
ويقول الشاعر أشرف أبو اليزيد في قصيدة “نوافذ كاوشيونج“، وهي مكونة من مقاطع مرقمة، في المقاطع رقم 6، 7 و8 عن تجربة الغربة والوحدة (ص98):
(6)
عاش ثري في هذا الدار
في شرفته أضاء الشمع
واشتبكت في القلب جذوة نار البعد
(7)
كم كف دقت هذا الباب
كم أذن أصغت للصوت
وحدي أصغى لصدى الخطوات في البيت الخالي
(8)
سأضئ شموعًا، وسأشعل عود بخور
وأصلي لسلام غاب طويلًا
واللوحة تبكي
ضوء الشموع في شرفة البيت يشعل في القلب جذوة نار الغربة، ورغم أن البيت خالٍ، إلا أن الشاعر في غربته ينتظر سماع صدى خطوات تؤنس وحدته وتقطع صمت الوحدة. وفي النهاية يصلي للسلام الغائب، واللوحة التي رسمها لحلمه تبكي.
تُرجمت قصيدة “راهب رأس الجبل الأشيب“ إلى عشر لغات، ويدمج الشاعر في هذه القصيدة بين الواقعي المعيش والأسطوري والرمزي، وبين الذاتي والكوني، وبين الرؤية كوجهة نظر والرؤيا الصوفية في لحظة الكشف. حيث يقول الشاعر (ص104):
كالوعل الهارب
أبحث بين سحابات سابحة فوق حقول الأمل
أتمنى أن تسحرني نجمة
كي أسقط مطرًا
أصل لرأس الجبل الأشيب
كان الراهب ينتظر
بمعبده الذي يشبه غيمه
تُعمم ناطحة سحاب
وبعد أن يتحول الشاعر إلى نجم يمطر ضوءًا فوق الجبل الأشيب، الذي يوجد في قمته معبد راهب يشبع غيمة تُعمم ناطحة سحاب، يسأله هذا الراهب (ص104-105):
يسألني الراهب عما صادفني:
سبع فراشات ترقص وهي تعانق شرنقة توشك أن تتحول؟
وردات عشر كانت تدمع عطرًا من مسك وكروم؟
بركة ماء تحمل صورة طائر بجناحي تنين؟
جيش من عشر سناجب؟
شجرات خمس تثمر تفاحًا من نور؟
كوكبة من عشرين مجرة؟
فيل يرفع هودجه الذهبي؟
أو ضفدعة مطّت شفتيها لأمير هارب؟
رمق الراهب قربة الماء التي أحملها، لم تحتفظ بقطرة، وكانت تسقي خطواتي التائهة. انشغل الراهب بقربة الماء الخالية أكثر من انشغاله بما حكاه الشاعر عن الكائنات والأشياء التي رأها في رحلته وما تحمله من رمزية.
بعد ذلك يتأمل الراهب وجه الشاعر الرحّالة (ص105):
يتأمل وجهي اليائس من رؤية شيء ما
في درب ختمت عينيه القسوة
وأثناء ذلك التأمل يسأل الشاعر نفسه في نهاية القصيدة:
تذكرة ذهاب كانت معي
هل يمنحني تذكرة إياب لأفتش ثانية؟
هنا يصل الشاعر المتصوف إلى لحظة الكشف، وهو في حضرة راهب رأس الجبل الأشيب، لتظل النهاية مفتوحة بلا حسم. فالحكمة هنا هي أنك عندما تذهب إلى مكان ما وتظن أنك ستجد فيه ضالتك المنشودة، لا بد أن تعلم كيف تعود من هذا المكان، فربما تكون هناك أشياء يمكنك البحث عنها في أماكن أخرى.

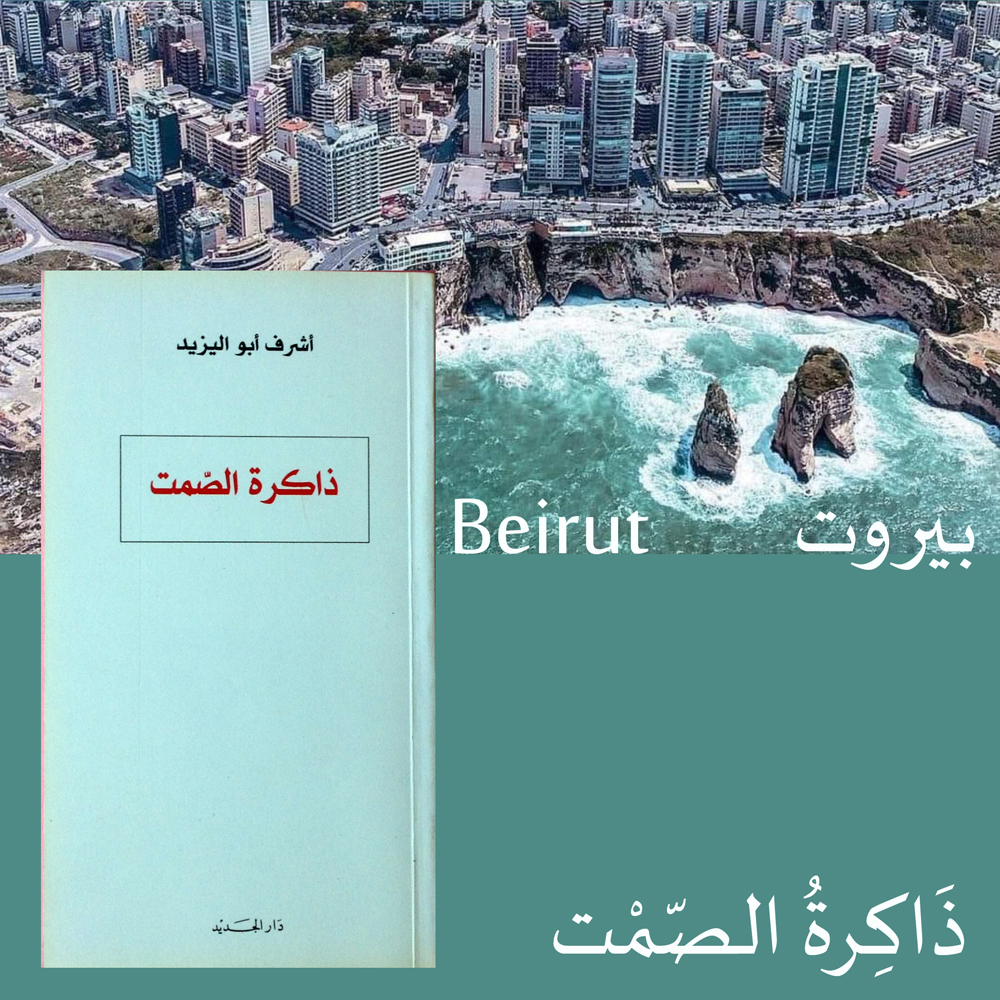 (3) “ذاكرة الصمت”
(3) “ذاكرة الصمت”