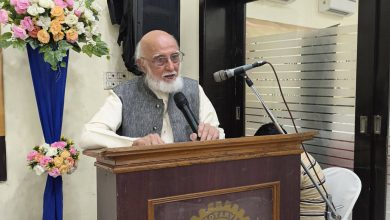بين مرسميه، الأول في متحف دارنا على شاطيء نيل القاهرة، والثاني في باريس على مرمى بصر من نهر السين، رسم الفنان التشكيلي والروائي عبد الرازق عكاشة مجموعة أعماله (ملحمة غزة)، وهكذا بين نهرين سالت الألوان، وحلقت الأفكار، وعلا نبض الريشة وهي تضرب الباليتة، ليسمع العالم صوت الألم والغضب. فلسطين ليست بعيدة عن عالم عكاشة، فقد كانت وستظل في القلب، ليس فقط عبر لوحاته السابقة والحالية واللاحقة، وإنما بآرائه التي نادى فيها بعودة الحقوق إلى أصحابها، واحترام إنسانية الشعب التاريخي لأرض فلسطين؛ الفلسطينيين.
سأشير إلى بعض الأعمال المؤسسة للملحمة، التي واكبت أحداثا جساما مر بها سكان غزة على مدى عامين، عانى فيها أهل الأرض من الإبادة، وفي وسط صمت مريب من البعض كان صوت ألوان عكاشة عاليا.
اللوحة الأولى، والمندرجة ضمن مجموعة “ملحمة غزة” للفنان والروائي عبد الرازق عكاشة، تمثل لحظة درامية كثيفة بالوجع والتمرد في آن واحد.
تبدو الكتل البشرية المرسومة بخطوط عريضة، داكنة، وملامحها ذائبة في العتمة، وكأنها أرواح تائهة بين الدخان والغبار. اللون الأسود المهيمن ليس مجرد خلفية بل هو بطل المشهد، يقابله ضوء رمادي أبيض يلمع كأمل ضئيل أو كوميض انفجار، لا يُعرف أهو فجر الحرية أم نار الخراب.
من الناحية التكوينية، اعتمد الفنان على حركة دائرية تصاعدية، تبدأ من الأسفل حيث تتشابك الأجساد وتلتف الظلال، ثم تتجه نحو الأعلى كصرخة جماعية أو دعاء يرتفع وسط الركام. هذا البناء البصري يمنح اللوحة طاقة داخلية تشبه لحنًا جنائزيًا يتصاعد في فضاء الحرب.
في هذا العمل، يمكن قراءة رمزية مزدوجة؛ السواد الكثيف وهو ليس موتًا بل شهادة، والفراغات البيضاء وهي ليست ضوءًا بل ذاكرة من بقي ليشهد. ومع غياب التفاصيل الدقيقة يتحرر المشهد من فرديته، ليصبح تعبيرًا عن الألم الجمعي، عن غزة بوصفها رمزًا لا مكانًا. ويمكننا القول إن هذه اللوحة لا توثّق لحظة من الحرب فحسب، بل تكشف عن وعي فنان يرى في المأساة طاقة تشكيلية وروحية، تصوغ من الدمار جمالًا مقاومًا، وتحوّل الصراخ إلى صمت بصري يتكلم.
 أما اللوحة “غزّة تحترق” (زيت على قماش، ٢٢٠×٢٠٠ سم) فهي عمل تعبيري كثيف يستند إلى طاقة اللون والحركة لتجسيد مأساة إنسانية وسياسية، تتجاوز الحدث إلى بعدٍ كونيّ. يهيمن الأحمر القاني والبنفسجي الداكن والبني المائل إلى الاحتراق، وهي ألوان النار والدم والرماد، بينما تتخللها ومضات من الأزرق والأصفر الذهبي تمثل الأمل أو بقايا الحياة وسط الخراب. هذا التناوب بين حرارة الألوان وبرودتها يخلق توتراً درامياً يشبه صراع البقاء نفسه. أما الخطوط فهي متموجة وسريعة، تندفع من الأعلى نحو المركز، كأنها لهبٌ صاعد أو أرواحٌ تهيم في سماء الحريق. هذا الاتجاه التصاعدي يوحي بانفجار داخلي، وبأن المدينة (غزّة) لم تعد ثابتة على الأرض، بل صارت تتطاير رماداً وصرخات.
أما اللوحة “غزّة تحترق” (زيت على قماش، ٢٢٠×٢٠٠ سم) فهي عمل تعبيري كثيف يستند إلى طاقة اللون والحركة لتجسيد مأساة إنسانية وسياسية، تتجاوز الحدث إلى بعدٍ كونيّ. يهيمن الأحمر القاني والبنفسجي الداكن والبني المائل إلى الاحتراق، وهي ألوان النار والدم والرماد، بينما تتخللها ومضات من الأزرق والأصفر الذهبي تمثل الأمل أو بقايا الحياة وسط الخراب. هذا التناوب بين حرارة الألوان وبرودتها يخلق توتراً درامياً يشبه صراع البقاء نفسه. أما الخطوط فهي متموجة وسريعة، تندفع من الأعلى نحو المركز، كأنها لهبٌ صاعد أو أرواحٌ تهيم في سماء الحريق. هذا الاتجاه التصاعدي يوحي بانفجار داخلي، وبأن المدينة (غزّة) لم تعد ثابتة على الأرض، بل صارت تتطاير رماداً وصرخات.
تتوسط اللوحة قنطرة أو قوس معماري، كأنها باب المدينة أو مدخل بيت مهدّم، وقد غمرته النيران. حوله تتشكل وجوه وأجساد شبه طيفية، مشوهة الملامح، تتداخل مع النسيج اللوني في وحدة مأساوية. الوجوه ليست محددة، لكنها حاضرة، شاهدة، تصرخ أو تصلّي.
المدينة كجسد محترق:
القوس المعماري قد يرمز إلى بوابة غزّة أو أحد مساجدها، لكنه هنا يبدو كجسدٍ يذوب، كأن العمارة تحترق مثل الإنسان. وكأن الوجوه المذابة في اللهب تذكّر بأيقونات القيامة أو المذابح؛ الفنان يجعل من النار مجازًا للذاكرة، لا للدمار فقط.
رغم هيمنة الألوان النارية، فإن الأزرق في الزوايا العليا يمنح بُعدًا روحياً، كأن السماء ما زالت تراقب، أو كأن الأمل يطلّ من رماد المأساة.
استخدام عكاشة الألوان الزيتية بحرية كاملة مما يجعل الملمس سميكاً وخشناً، أقرب إلى جدرانٍ مشتعلة. ولم يعتمد الفنان على تفاصيل دقيقة أو واقعية، بل على انفعال لوني وحركي يتجاوز التمثيل إلى التعبير الكلّي عن الألم.
لا يريد ولا يحب الفنان أن نصنف أعماله، أو نلحقها بمدرسة ما، فهو يتجاوز التعبير المدرسي، ولكن يمكن إضافة العمل ضمن سقف التعبيرية الرمزية المعاصرة، حيث تتخذ المأساة الفلسطينية بُعداً إنسانياً يتصل بكل ما هو محترق في عالمنا.
اللوحة ليست مجرد تسجيل بصري للحرب، بل صرخة روحية، تجعل من النار لغةً ومن اللون صلاةً. هي مرثية بصرية لغزّة، لكنها أيضاً مرآة للعالم الذي يشهد ولا يطفئ الحريق.
في ليلةٍ من أكثر ليالي غزة ظلمة، دوّى انفجار جديد ليُضاف إلى سجل طويل من الجرائم التي تستهدف الإنسان والمكان. كان ذلك في مستشفى المعمداني، أو كما يُعرف أيضًا بـ مستشفى الأهلي العربي الإنجيلي، أحد أقدم وأهم المؤسسات الطبية في القطاع، الذي تأسس عام 1882 على يد الكنيسة الإنجيلية في القدس، ليكون ملاذًا للجرحى والفقراء والمشرّدين.
في الساعات الأولى من يوم الأحد، الثالث عشر من أبريل 2025، تلقّى العاملون في المستشفى مكالمة هاتفية من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط في الجيش الإسرائيلي، طالبًا منهم إخلاء المكان فورًا تحذيرًا من قصفٍ وشيك. كان التحذير بمثابة إنذار بالموت، فشرع الطاقم الطبي في نقل المرضى والمصابين إلى الخارج وسط ظلامٍ خانق ونقصٍ في الوسائل، فيما كانت السماء تتهيأ لصوتٍ آخر غير صوت اللهفة والخوف.
لم تمضِ سوى ثلاثين دقيقة حتى وقعت الضربتان الجويتان اللتان دمّرتا أجزاءً واسعة من المستشفى. احترق قسم الطوارئ بالكامل، وتحوّل المختبر والصيدلية إلى أنقاض، بينما تعطّلت أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية (CT) التي كانت من القلائل العاملة في غزة. امتدت ألسنة النار لتصيب مبنى الكنيسة القديمة داخل المجمع، في مشهدٍ بدا كأنه استهدافٌ مزدوج للجسد والروح. لم تكن الخسائر البشرية ضخمة هذه المرة بسبب الإخلاء المبكر، لكن المأساة تجسدت في رحيل الطفل حاتم طه غازي النبيح، البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، الذي فقد حياته بعد انقطاع علاجه الضروري في أثناء الإخلاء القسري.
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانًا دان فيه الهجوم، واعتبره جريمة جديدة ضد المنشآت المدنية والطبية، مؤكّدًا أن قصف المستشفيات يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. لم يكن المعمداني مجرد مستشفى، بل رمزًا لتاريخٍ طويل من الصمود الطبي في وجه الحصار والحروب. ومع قصفه، تعطّلت آخر خطوط الإغاثة الممكنة في شمال غزة، ووجد آلاف المدنيين أنفسهم بلا مأوى علاجي، فيما كان العالم يكتفي بالبيانات المترددة.
بهذا القصف، تحوّل المستشفى الذي كان يرمز إلى الحياة إلى أيقونة للألم الفلسطيني؛ فالمبنى الذي صمد لأكثر من قرن لم يسقط تحت القنابل وحدها، بل تحت صمت العالم أيضًا. وهكذا أصبح “المعمداني” علامة دامغة على تحوّل الرعاية الإنسانية إلى ساحة حرب، وعلى أن المشهد في غزة تجاوز حدود السياسة والعقاب الجماعي ليغدو مواجهة مفتوحة مع فكرة الوجود الإنساني ذاته.

اللوحة الأخيرة في هذه القراءة لأعمال الفنان عبد الرازق عكاشة عن غزة تحمل اسم “مستشفى المعمداني”، وسواء كانت ضمن سلسلة «غزّة تحترق» أو عملاً مستقلاً، تمثل ذروة التعبير الإنساني في مواجهة أحد أكثر المشاهد قسوة في الذاكرة الفلسطينية المعاصرة — قصف مستشفىٍ يُفترض أن يكون ملاذاً للجرحى، فتحوّل إلى جرحٍ أكبر.
الألوان في هذا العمل (وفق ما يوحي به العنوان وسياق التجربة الفنية) تتوزع بين القرمزي الداكن والبني المحروق والرمادي المعتم، في إشارة إلى النار والرماد والأنقاض.
لكن ما يلفت هو استخدام بقع من الضوء الأصفر أو الأبيض الباهت، كأنها تومض فوق الركام مثل بقايا مصابيح أو أرواح لم تغادر المكان.
هنا يتحول اللون من مجرد عنصر تشكيلي إلى لغة سردية تروي الحكاية بصمت.
الظلال ليست خلفية كما في الأعمال الكلاسيكية، بل هي جزء من الحدث نفسه. الضوء لا يأتي من مصدر خارجي، بل ينبعث من داخل الجرح، من قلب الانفجار، ما يمنح اللوحة بعداً ميتافيزيقياً يوحي بأن الألم نفسه صار منبعاً للنور.
أما البناء compositional structure فيعتمد غالباً على محورٍ مركزي، ربما يمثّل مبنى المستشفى أو قاعة الإسعاف الكبرى، بينما تتوزع حوله شظايا وأجساد وظلال في حركة دائرية. هذه الدائرة توحي بأن الموت ليس نهاية، بل دورة تتكرر كل يوم، ما يجعل اللوحة تتجاوز التوثيق إلى رمزية الاستمرار المأساوي.
إذا كان “المستشفى” في المخيال الإنساني رمز للنجاة والرعاية والشفاء، سنراه في اللوحة يتحوّل إلى مكان للموت الجماعي، وكأن الفنان يوظّفه كأقسى مفارقة ممكنة في اللغة البصرية — انهيار المعنى نفسه. إنّ قصف المستشفى لا يدمّر جدراناً فحسب، بل يهدم فكرة الإنسانية.
الإنسان الغائب الحاضر
في كثير من اللوحات التي تتناول الكارثة، يغيب الجسد الإنساني كمحورٍ واضح، لكنه يحضر كأثر، كبصمة، كظلٍ باقٍ على الجدار. الفنان هنا يعبّر عن الضحايا لا من خلال رسمهم، بل من خلال فراغهم، ما يمنح المشهد قوةً مضاعفة.
عنوان اللوحة «المعمداني» يفتح فضاءً مزدوجاً بين الرمز الديني والمشهد الإنساني. فالمعمدان، في الموروث المسيحي، هو رمز الطهارة والماء، لكن في هذه اللوحة نرى ماءً تحوّل إلى دمّ، وسماءً إلى لهب. وكأن الفنان يعيد قراءة المأساة على مستوى كوني، حيث المقدّس نفسه يتألم.
تمنح تقنية ألوان الزيت على القماش هذه اللوحة وأخواتها عمقاً ملمسياً يضاعف أثر الانفعال. ضربات الفرشاة العنيفة والسريعة تعكس الإيقاع الفوري للكارثة، وكأن الفنان يرسم بيدٍ مرتجفة في لحظة صدمة. واللوحة لا تبحث عن الجمال بقدر ما تفضح قسوته، فهي تقف في منطقة ما بعد الجماليات (post-aesthetic)، حيث الجمال يولد من التعرية والصدق.
إن لوحات عُكاشة قد تُستقبل بصرياً، لكنها تُسمع شعورياً: أصوات الإسعاف، الصراخ، الأجساد التي تُرفع من تحت الركام — كل ذلك يتجسد في حركة اللون والضوء. هي ليست لوحة عن حدثٍ فلسطيني فقط، بل عن انهيار الضمير الإنساني في زمن الصورة. فالفنان هنا لا يصور الجريمة، بل ينحت صرخة.
مثل جيرنيكا بيكاسو تأتي مستشفى المعمداني لعكاشة، فهي ليست لوحة وثائقية، بل أيقونة مقاومة تكتب المأساة بلغة اللون لا بالدم، وتتسم بصدقٍ انفعالي نادر، وقدرة على تحويل الألم إلى طاقة تشكيلية تضع المتلقي في مواجهة ذاته وسؤاله الأخلاقي. إنها عملٌ يجعل الفن شهادةً، ويجعل من الفرشاة ضميراً بصرياً يرفض الصمت.

 بين مرسميه، الأول في متحف دارنا على شاطيء نيل القاهرة، والثاني في باريس على مرمى بصر من نهر السين، رسم الفنان التشكيلي والروائي عبد الرازق عكاشة مجموعة أعماله (ملحمة غزة)، وهكذا بين نهرين سالت الألوان، وحلقت الأفكار، وعلا نبض الريشة وهي تضرب الباليتة، ليسمع العالم صوت الألم والغضب. فلسطين ليست بعيدة عن عالم عكاشة، فقد كانت وستظل في القلب، ليس فقط عبر لوحاته السابقة والحالية واللاحقة، وإنما بآرائه التي نادى فيها بعودة الحقوق إلى أصحابها، واحترام إنسانية الشعب التاريخي لأرض فلسطين؛ الفلسطينيين.
بين مرسميه، الأول في متحف دارنا على شاطيء نيل القاهرة، والثاني في باريس على مرمى بصر من نهر السين، رسم الفنان التشكيلي والروائي عبد الرازق عكاشة مجموعة أعماله (ملحمة غزة)، وهكذا بين نهرين سالت الألوان، وحلقت الأفكار، وعلا نبض الريشة وهي تضرب الباليتة، ليسمع العالم صوت الألم والغضب. فلسطين ليست بعيدة عن عالم عكاشة، فقد كانت وستظل في القلب، ليس فقط عبر لوحاته السابقة والحالية واللاحقة، وإنما بآرائه التي نادى فيها بعودة الحقوق إلى أصحابها، واحترام إنسانية الشعب التاريخي لأرض فلسطين؛ الفلسطينيين.