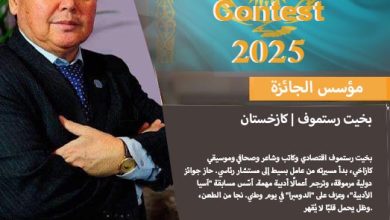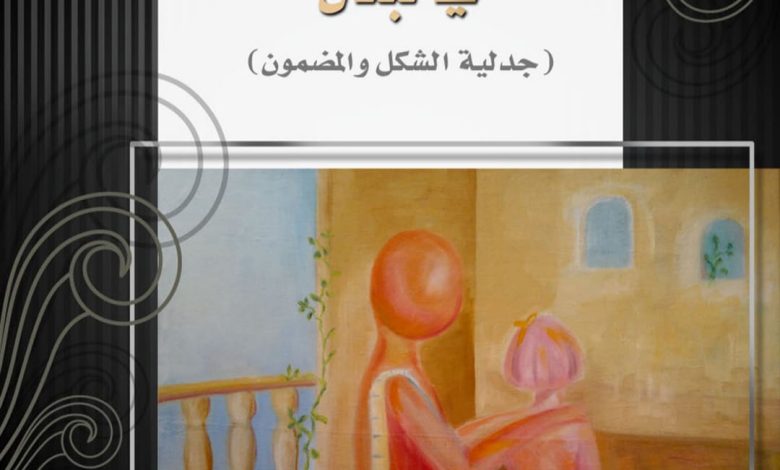
الطفولة كفضاء للمعرفة والجمال
قراءة في كتاب: «قصة الأطفال والناشئة في لبنان» للدكتورة إيمان بقاعي
بقلم:
يبدو أن الدكتورة إيمان بقاعي في كتابها «قصة الأطفال والناشئة في لبنان» قد اختارت أن تدخل ميدانًا لم يُستوفَ بحثًا بعد في النقد العربي الحديث، وهو ميدان أدب الأطفال في تجلّيه اللبناني، بما يحمله من ثقل اجتماعي وثقافي وتاريخي. فالحديث عن أدب الطفل في لبنان ليس مجرد بحث في جنس أدبيٍّ أو نوعٍ تعبيري، بل هو في جوهره بحث في تصوّر المجتمع لذاته ولأجياله القادمة، أي في صورة المستقبل التي تتكوّن في رحم اللغة والخيال.
ولذلك فإنّ قراءة هذا الكتاب ليست مجرّد تلخيصٍ أو متابعةٍ منهجية لمحتوياته، بل هي بالضرورة تأمل في المشروع الفكري والتربوي الذي تنطوي عليه رؤيته، وفي الخلفيات المعرفية التي تنسج خيوطه الخفية.
الطفل في نظر المؤلفة، ليس كائنًا بسيطًا ينتظر التشكيل، بل هو مركز إدراكٍ وتلقٍّ له منطقه الخاص في الفهم والتأويل. ومن هنا تتبدّى أهمية العنوان: «قصة الأطفال والناشئة»؛ فالقصّة ليست مجرّد وسيلة ترفيهية بل أداة تكوين، والناشئة ليسوا امتدادًا بيولوجيًا للراشدين بل كينوناتٌ معرفية متمايزة. إننا أمام مشروعٍ يُعيد تعريف العلاقة بين الأدب والتربية من زاويةٍ لبنانيةٍ مشدودةٍ إلى سياقها التاريخي المتأزم: حروب أهلية وتهجير وذاكرة جماعية ممزّقة، وبحثٌ عن هوية.
تبدو المؤلفة، في هذا الأفق، أقرب إلى أن تكون شاهدةً على تشكّل وعي جماعيٍّ من خلال النصوص الموجّهة للأطفال؛ فحين نقرأ تحليلها للقصص اللبنانية، لا نقرأ مجرّد نقدٍ أدبي، بل نقرأ في العمق تاريخًا رمزيًا للبنان ذاته، كما يُعاد تمثيله في وعي الطفولة.
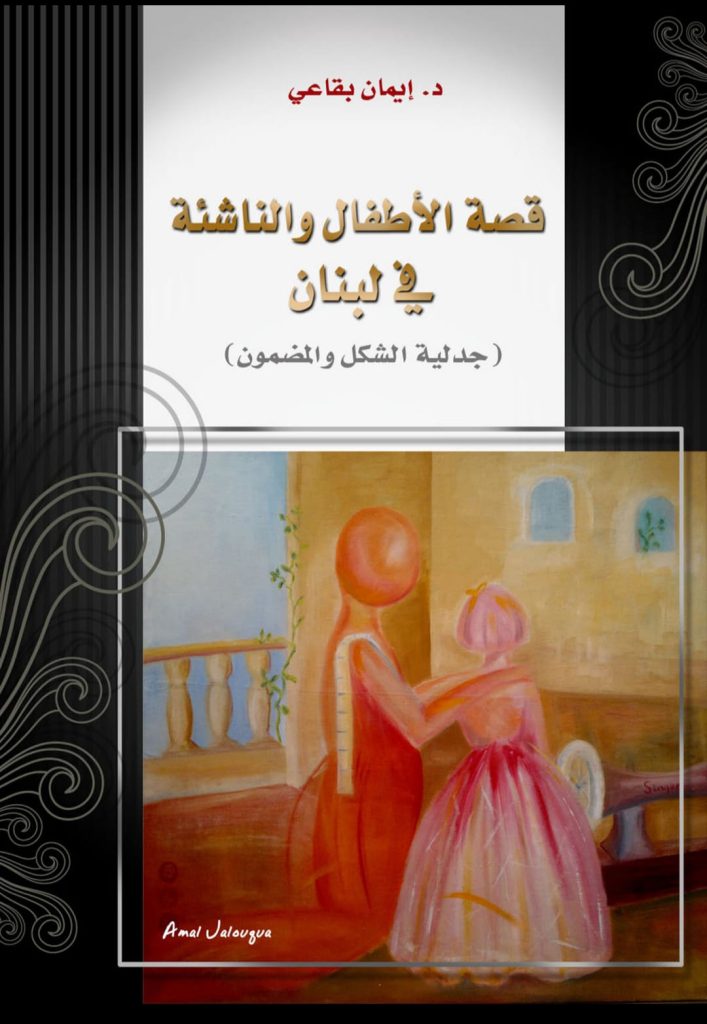 منذ الصفحات الأولى، تضع بقاعي عملها ضمن أفق علمي واضح: تصف نفسها بأنها تشتغل على تحليل فني وتربوي نفسي لعينة واسعة من القصص اللبنانية الموجّهة للأطفال والناشئة، مستندة إلى أدوات النقد الأدبي والتحليل التربوي. غير أن هذا الإطار المنهجي لا يظلّ محصورًا في الجانب التطبيقي؛ فالمؤلفة تحاول أيضًا أن تُحدِّد موقع هذا الأدب ضمن الثقافة العربية عامة، فتسائل طبيعة اللغة السردية الموجّهة للطفل، ومدى استجابتها لمراحل النموّ العقلي والانفعالي.
منذ الصفحات الأولى، تضع بقاعي عملها ضمن أفق علمي واضح: تصف نفسها بأنها تشتغل على تحليل فني وتربوي نفسي لعينة واسعة من القصص اللبنانية الموجّهة للأطفال والناشئة، مستندة إلى أدوات النقد الأدبي والتحليل التربوي. غير أن هذا الإطار المنهجي لا يظلّ محصورًا في الجانب التطبيقي؛ فالمؤلفة تحاول أيضًا أن تُحدِّد موقع هذا الأدب ضمن الثقافة العربية عامة، فتسائل طبيعة اللغة السردية الموجّهة للطفل، ومدى استجابتها لمراحل النموّ العقلي والانفعالي.
إنّها إذن تكتب من موقع الوعي النقدي المزدوج: وعي الباحثة بالأدب كفن، ووعي المربية بالطفل كمتلقٍّ مميّزٍ يحتاج إلى خطابٍ مخصوص.
ولعلّ القيمة الكبرى في مشروعها تكمن في التوليف بين المنهج الوصفي والتحليل الجمالي، فهي لا تكتفي بإحصاء الموضوعات أو تصنيف القصص وفق قيمها التربوية، بل تحاول أن تكشف البنية الجمالية الداخلية للنصوص: اللغة والإيقاع والبنية السردية ورمزية الشخصيات، توظيف الصورة واللوحة، والبعد النفسي للحدث الحكائي.
بهذا التوجّه تذكّرنا بقاعي بنماذج نقدية عالمية حاولت أن تزاوج بين الفن والتربية، مثل جهود الفرنسية مادلين لوبرتون في دراساتها حول الخيال الطفولي، أو أعمال برونو بيتلهيم الذي رأى في الحكاية الخرافية تعبيرًا عن لاوعي الجماعة الإنسانية وعن مسار النضوج النفسي للطفل.
لكن بقاعي بخلاف هؤلاء، تنطلق من سياق عربي لبناني مشحون بالتاريخ وبالرموز الجماعية، حيث تغدو القصة وسيلة لترميم صورة الوطن، قبل أن تكون أداة تربية جمالية.
إنّ القارئ المتأمّل في هذا الكتاب يلحظ أن المؤلفة تتعامل مع النصوص القصصية للأطفال بوصفها وثائق ثقافية أكثر منها كائنات لغوية فحسب. وهذا التحوّل من القراءة الشكلية إلى القراءة الثقافية يُعيدنا إلى مدرسة ريمون ويليامز في النقد الثقافي، التي ترى أنّ الأدب انعكاسٌ لشروط الإنتاج الرمزي في المجتمع.
ومن هنا، فإنّ تحليل بقاعي للمضامين — مثل موضوع الحرب، الهجرة، الفقر، الانتماء، الخوف، أو صورة الأسرة — ليس غاية في ذاته، بل مدخل لتفكيك العلاقة بين البنية الاجتماعية اللبنانية وبين تمثيلاتها الرمزية في خطاب الطفولة.
وهي حين تدرس كيف تُقدّم القصص للأطفال صورة “الآخر”، أو صورة “الوطن”، فهي تُسائل ضمنيًا كيف يبني المجتمع تصوّره عن ذاته من خلال أدبه الصغير.
منهجها إذن هو التحليل الثقافي للأدب الطفولي، وإنْ لم تُسمّه بهذا الاسم مباشرة.
فهي تستعير من علم النفس التربوي أدواته لتقدير مدى ملاءمة اللغة والمضمون لمراحل النموّ، وتستعير من النقد الأدبي آلياته لتفكيك البنية السردية، وتستعير من علم الاجتماع حدسه في فهم العلاقة بين الأدب والسلطة والمعنى.
هذا التداخل المنهجي (interdisciplinarity) هو ما يمنح الكتاب ثراءه وقيمته العلمية، ويجعله أقرب إلى موسوعةٍ تطبيقيةٍ لأدب الأطفال اللبنانيين، دون أن يفقد طابعه الجمالي.
غير أنّ القارئ لا يلبث أن يكتشف في طيّات هذا الجهد العلمي حسًّا وجوديًا عميقًا بالطفولة.
فالمؤلفة لا تنظر إلى الطفل ككائنٍ يجب “تصحيحه” عبر الأدب، بل كذاتٍ مبدعة قادرة على إنتاج المعنى.
وهنا يلتقي فكرها مع ما طرحه الفيلسوف الألماني فيلهلم دلتاي حين قال إن “الإنسان لا يُربَّى بالتلقين بل بالخبرة الحيّة”، ومع تصوّر جون ديوي للتربية بوصفها تفاعلًا دائمًا بين الفرد والبيئة.
فالقصّة الجيدة عند بقاعي ليست درسًا أخلاقيًا مغلقًا، بل تجربة تخييلية تُدرّب الطفل على ممارسة الحرية ضمن اللغة، وتُنمّي لديه القدرة على التساؤل.
في هذا السياق، يصبح السؤال الجوهري هو: كيف يتجلّى “لبنان” في قصص الأطفال اللبنانية؟
إنّ الإجابة التي توحي بها المؤلفة — وإن لم تصغها صراحةً — هي أنّ لبنان في هذه القصص ليس جغرافيا محدودة، بل رمزٌ لهويةٍ متحرّكةٍ تعيش بين الألم والأمل.
فالطفل اللبناني كما تصوّره القصص، يُولَد في وطنٍ لم يشفَ من حروبه بعد، لذلك فإنّ الأدب الموجّه إليه لا يمكن أن يكون بريئًا من التاريخ، بل عليه أن يكون لغةً للمصالحة الرمزية مع الذاكرة.
وهذا ما يجعل المشروع برمّته ذا بعدٍ سياسي ثقافي غير مباشر: فالقصة هنا ليست فقط أداة تنشئة، بل محاولة لشفاء جماعيٍّ من جروح الماضي.
وقد أحسنت المؤلفة في اختيارها عيّنة واسعة من القصص اللبنانية المنشورة خلال العقود الأخيرة، إذ جعلت منها مختبرًا لقراءة تحوّلات المجتمع اللبناني من خلال إنتاجه الموجّه لأطفاله.
ففي القصص التي تلت الحرب الأهلية، نجد حضورًا لافتًا لموضوعات السلام والتسامح والمواطنة والبحث عن الهوية، في مقابل تراجع موضوعات البطولة أو البطولة القتالية التي كانت تهيمن في مراحل سابقة.
وهذا التحوّل في رأيها، يعكس رغبة المجتمع اللبناني في إعادة بناء الذات المدنية عبر خطاب الطفولة، بعد أن جرّب لغة السلاح والانقسام.
وهنا يظهر الحسّ التاريخي في قراءة بقاعي، فهي لا تفصل النصّ عن سياقه، بل تراه امتدادًا لحياة الناس ومعاناتهم وتطلّعاتهم.
وفي أثناء قراءتها للقصص، لا تغفل المؤلفة دور الرسوم والألوان والإخراج الفني، فتدرسها بوصفها جزءًا من البنية السردية، لا مجرّد زينة.
وهذا الوعي بسلطة الصورة في خطاب الطفولة يُبرز إدراكًا عميقًا لتغيّر وسائط التلقّي في العصر الحديث، حيث أصبحت الصورة تنافس الكلمة في تشكيل الوعي.
إنّها بهذا المعنى، تتبنى رؤية قريبة من رؤية رولان بارت حين تحدّث عن “بلاغة الصورة”، ومن تنظيرات غاستون باشلار الذي رأى في الصورة “بيت الوجود الخيالي”.
فالرسوم في القصة ليست فقط مكمّلاً بصريًا للنص، بل هي لغة رمزية تكشف عن خيال الجماعة، وتُعيد للطفل قدرته على التمثّل الح