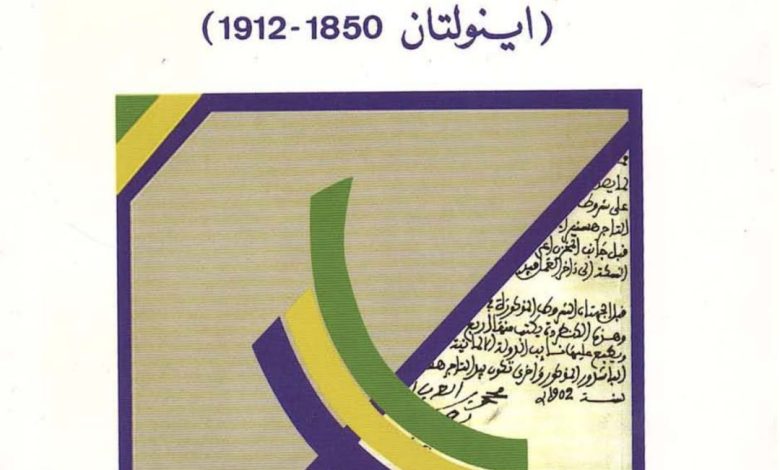
الكتابة التاريخية من الهامش:
من المنظور المجهري إلى التحليل البنيوي،
قراءة في منهجية أحمد التوفيق بين الأرشيف والميدان من خلال كتاب
“المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: إينولتان 1850-1912”
بقلم: د. حمزة مولخنيف، المغرب
يُعد كتاب “المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: إينولتان 1850-1912” لأحمد التوفيق عملاً تأسيسياً في حقل التاريخ الاجتماعي المغربي، لا بل مرجعاً أساسياً في دراسة البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات المحلية في المغرب ما قبل الاستعمار. يأتي هذا العمل ثمرة جهد بحثي استثنائي، جمع بين التمحيص الأرشيفي الدقيق والعمل الميداني، محاولاً رصد تحولات مجتمع قبيلة إينولتان في فترة حاسمة من تاريخ المغرب، وهي النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى بداية الاستعمار الفرنسي. لا يكتفي التوفيق بسرد الأحداث أو رصد الوقائع، بل يغوص في أعماق البنى الاجتماعية والاقتصادية، محاولاً فهم الآليات الداخلية التي حكمت تطور هذا المجتمع وانخراطه في سياق تاريخي أوسع.
يتميز الكتاب بمنهجية دقيقة تجمع بين التاريخ المحلي المجهري والتحليل البنيوي، مما يجعله نموذجاً رفيعاً للبحث التاريخي الذي يتجاوز السرد التقليدي إلى فهم الديناميات الداخلية للمجتمعات. فاختيار قبيلة إينولتان كوحدة للدراسة ليس اعتباطياً، بل يأتي في إطار سعي التوفيق لتجنب التعميمات الواسعة التي طالما سيطرت على الدراسات التاريخية المغربية، والتي غالباً ما تغفل الخصوصيات المحلية. من هنا، يمكن اعتبار هذا العمل محاولة جريئة لكتابة تاريخ “من الأسفل”، تاريخ يلامس حياة الناس العاديين، ويرصد تفاعلاتهم اليومية مع محيطهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
يعتمد التوفيق على تنوع مصادره بشكل لافت، فهو لا يقتصر على الوثائق الرسمية المخزنية فحسب، بل يمتد إلى الوثائق الخاصة، والأوراق العائلية، والسجلات المحلية، والروايات الشفوية، بل وحتى النوازل الفقهية. هذا التعدد في المصادر يمكنه من بناء رؤية متكاملة عن المجتمع المدروس، متجنباً الوقوع في فخ الاعتماد على رواية واحدة قد تكون مشوهة أو ناقصة. فوثيقة “الترتيب” الجبائية، على سبيل المثال، لم تكن مجرد سجل ضريبي، بل أصبحت في يد التوفيق أداة لفك شفرة البنية الاقتصادية والاجتماعية لإينولتان، حيث قدمت بيانات دقيقة عن ملكية الأرض والمواشي والأشجار، وعكست التمايزات الطبقية داخل المجتمع.

ولعل أحد أبرز إنجازات التوفيق في الكتاب هو نجاحه في التوفيق بين المنهج التاريخي والمنظور الأنثروبولوجي. فالتوفيق لا يكتفي برصد الأحداث، بل يحاول فهم البنى العميقة التي تحكمت في سلوك الأفراد والجماعات. من هنا، نراه يستعين بأدوات التحليل البنيوي لفهم التنظيم الاجتماعي للقبيلة، مبرزاً كيف أن العلاقات القرابية والتحالفات والصراعات، كانت تشكل إطاراً حاكماً للحياة اليومية. لكنه في نفس الوقت، يتجنب الوقوع في فخ النظريات الجاهزة، مقدماً تحليلاً مرناً يستجيب لخصوصية السياق التاريخي المغربي.
يظهر التأثر الواضح بالمدرسة التاريخية الاجتماعية، وبالأعمال الرائدة لمؤرخين مثل فرنان بروديل، في تركيز التوفيق على “الزمن الطويل” والبنى العميقة التي تتغير ببطء. فهو لا يهتم فقط بالأحداث السياسية الكبرى، بل يمعن في دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت مجتمع إينولتان، كأنماط الزراعة والرعي، وتقنيات الري، وأنظمة التبادل التجاري، والعلاقات مع الدولة المركزية. هذا الاهتمام بالجذور البنيوية يمكن القارئ من فهم استمرارية بعض الظواهر الاجتماعية رغم التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة.
كما يتجلى الطابع النقدي للكتاب في تعامله مع المصادر الاستعمارية والأنثروبولوجية الأجنبية. فالتوفيق لا يرفضها جملة وتفصيلاً، ولا يقبلها بشكل أعمى، بل يحللها نقدياً، مبرزاً سياقات إنتاجها وأهدافها الخفية. فهو يرى أن الكثير من هذه الدراسات كانت تخدم أغراضاً استعمارية، سواء في تبرير التدخل الأجنبي أو في رسم صورة نمطية للمجتمعات المحلية. لكنه في نفس الوقت، لا يتردد في الاستفادة من المعطيات القيمة التي تحتويها، خاصة فيما يتعلق بالحياة المادية والثقافية.
في الإطار النظري، يتبنى التوفيق مقاربة توفيقية بين المادية التاريخية والمنظور الانقسامي، دون أن يقع في دوغمائية أي منهما. فهو يعترف بأهمية العوامل الاقتصادية في تشكيل البنى الاجتماعية، لكنه لا يختزل كل شيء إلى الصراع الطبقي. كما يهتم بالديناميات الداخلية للقبيلة، مبرزاً كيف أن الانقسامات والتحالفات كانت تلعب دوراً في حفظ التوازن الاجتماعي، لكنه يرفض فكرة أن هذه المجتمعات كانت معزولة أو مستقلة تماماً عن الدولة المركزية.
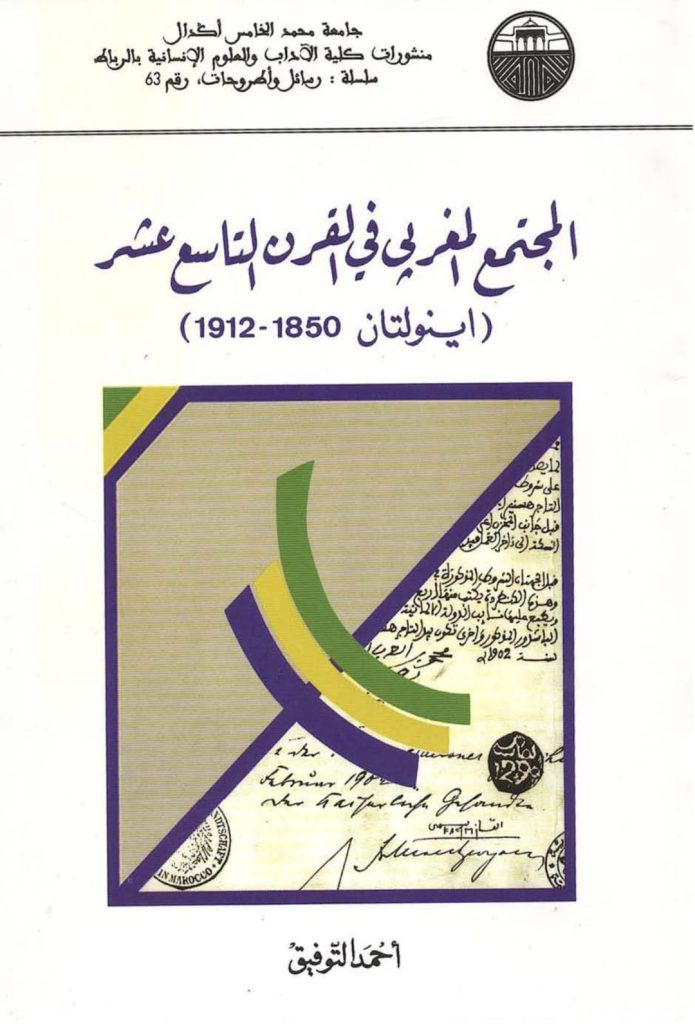
يبرز الكتاب أيضاً كيف أن مجتمع إينولتان لم يكن كتلة متجانسة، بل كان يعرف تمايزات طبقية واضحة، تتراوح بين ملاك الأراضي والمرابطين من جهة، والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين من جهة أخرى. كما يسلط الضوء على دور الزوايا والمرابطين كفاعلين مركزيين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط كوسطاء روحيين، بل أيضاً كمالكين للأراضي ومتحكمين في شبكات التبادل التجاري.
من الناحية السياسية، يقدم التوفيق تحليلاً دقيقاً لعلاقة القبيلة بالدولة المخزنية، مبرزاً كيف أن هذه العلاقة كانت تتأرجح بين الخضوع والتمرد، بين التعاون والصراع. فإينولتان رغم موقعها الجبلي النائي، لم تكن بمعزل عن سلطة المركز، بل كانت جزءاً من الشبكة الجبائية والإدارية للدولة. لكن هذا لا يعني أن سلطة المخزن كانت مطلقة، بل كانت تواجه باستمرار بمقاومة محلية، تارة سلبية عبر التهرب الضريبي، وتارة عنيفة عبر الانتفاضات المسلحة.
يعد هذا الكتاب إسهاماً مهماً في نزع الطابع “الأسطوري” عن تاريخ المغرب ما قبل الاستعمار، حيث يحل محل الصورة النمطية عن المجتمعات القبلية ككيانات جامدة ومعزولة، صورة دينامية ومعقدة، تتفاعل مع محيطها الإقليمي والوطني، وتخضع لتحولات عميقة، سواء تحت تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية. كما يمثل نقلة منهجية في دراسة التاريخ المغربي، حيث ينتقل من تاريخ “الملوك والسلاطين” إلى تاريخ “الشعوب والمجتمعات”، من التاريخ السياسي إلى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي.
ويتميز منهج أحمد التوفيق بالوعي الحاد بسياق إنتاج المعرفة التاريخية، فهو لا يقدم نفسه كمؤرخ محايد ينقل “الحقائق” المجردة، بل كفاعل في حقل تاريخي وإبيستيمولوجي متحرك. يتجلى هذا الوعي في مقدمات الكتاب المختلفة، حيث يراجع المؤلف سياق كتابة البحث الأصلي في سبعينيات القرن الماضي، ويعترف بتأثر الإطار النظري آنذاك بموجة “التاريخ الاجتماعي” والاهتمام بمسألة “الخصوصية” المغربية في مواجهة النماذج التفسيرية المستوردة. بل إنه يذهب إلى حد التأمل في مدى ارتباط أسئلة بحثه بسياق البحث عن الهوية والمشروعية في مرحلة كانت الجامعة المغربية فيها فضاء لصراع الإجابات الكبرى حول المجتمع والتاريخ. هذا الانزياح النقدي تجاه الذات ومنهجية العمل يضفي على الكتاب عمقاً فلسفياً، ويجعله ليس مجرد دراسة عن إينولتان في القرن التاسع عشر، بل أيضاً وثيقة عن تطور الفكر التاريخي والمجتمعي في المغرب.
في تعامله مع المصادر، يظهر التوفيق براعة المؤرخ المحقق الذي يفكك طبقات النص ويسائل ظروف إنتاجه. فعندما يستعرض وثيقة “الترتيب” الجبائية، لا يقتصر على استخراج البيانات الاقتصادية منها، بل يحلل شروط إنتاجها نفسها: الدوافع السياسية لمشروع الإصلاح الضريبي، وآليات جمع البيانات، وإمكانية التزوير أو التواطؤ بين المسؤولين المحليين والسكان، وحدود تمثيليتها إذ أنها لا تشمل غير المالكين. هذا التحليل النقدي للمصدر يضعه في إطاره التاريخي والسياسي، مما يمنح البيانات المستخلصة مصداقية أعلى ويجنب الباحث الوقوع في فخ المباشرة الساذجة. كما أن استخدامه للرواية الشفوية لا يقل تعقيداً، فهو يدرك هشاشتها وتحيزاتها، ويحاول تقاطعها مع المصادر المكتوبة، معترفاً بأنه يعمل مع “ذاكرة” وليس مع “أرشيف” محايد. إن هذا الحذر المنهجي المقترن بالجرأة في توظيف أنواع متعددة من الوثائق، هو ما يجعل البناء التاريخي الذي يقدمه متماسكاً وقابلاً للثقة، رغم صعوبة المادة وندرة المصادر المباشرة حول حياة القبائل.
يقدم الكتاب حواراً خفياً لكنه عميق مع النماذج السوسيولوجية المهيمنة على دراسة المجتمعات الأمازيغية، خاصة أعمال روبر مونطاني وإرنست غيلنر. فالتوفيق لا يرفض منظور “النسق الانقسامي” جملة وتفصيلاً، بل يستفيد منه في فهم الديناميات الداخلية للقبيلة وتحالفاتها. لكنه في نفس الوقت، يشير إلى حدود هذا النموذج في تفسير مجتمع إينولتان الذي كان خلافاً لنموذج غيلنر، على تماس مباشر ومستمر مع سلطة “المخزن” المركزية. فهو يظهر كيف أن البنية الاجتماعية لم تكن منغلقة على نفسها، بل كانت متشربة بعلاقات القوة التي يفرضها المركز، ومندمجة في شبكات اقتصادية وتجارية تتجاوز الإطار المحلي. بهذا المعنى، يمكن قراءة الكتاب كنقد ضمني للنزعة “الاستثنائية” التي صورت مجتمع الأطلس ككون منفصل، وإعادة تأكيد على أن تاريخ المغرب، حتى في أكثر مناطقها “هامشية”، هو تاريخ تفاعلي بين المركز والأطراف.
يبرز التوفيق أيضاً التعقيد الطبقي داخل المجتمع القبلي، متجاوزاً الصورة الرومانسية عن “المساواة” البدائية. فمن خلال تحليله لوثيقة “الترتيب” والسجلات العائلية، يكشف عن تمايزات حادة في الثروة والملكية، ليس فقط بين القبائل، بل داخل القبيلة الواحدة نفسها. فهناك العائلات الكبيرة المالكة للأراضي والأشجار والمواشي، والمرابطون الذين يجمعون بين النفوذ الروحي والاقتصادي، والفلاحون الصغار والحرفيون والأجراء الزراعيون الذين لا يملكون سوى قوة عملهم. هذه التقسيمات لم تكن جامدة، بل كانت تخضع لتحولات، وتنتج عنها صراعات حول الموارد، خاصة الأرض والماء، والتي تتجلى بوضوح في “النوازل” الفقهية التي يعتمد عليها المؤلف. إن هذه الرؤية الواقعية للمجتمع القبلي، التي ترفض اختزاله إلى نسق انقسامي مجرد، تثري النقاش حول طبيعة التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب ما قبل الاستعمار، وتفتح الباب أمام مقاربات أكثر تركيباً لمسألة “نمط الإنتاج”.
يتميز الكتاب أيضاً بأسلوب سردي يجمع بين دقة البحث الأكاديمي وعمق التأمل التاريخي. فالتوفيق لا يقدم وقائع جافة، بل يحاول أن ينقل للقارئ “نبض” الحياة اليومية في إينولتان: صعوبات الزراعة في المنحدرات الجبلية، وتقنيات الري، ودورة الرعي الموسمية، وحركة القوافل التجارية، وحيوية سوق دمنات، ودور الزوايا كمراكز للعلم والوساطة والسلطة. هذا الاهتمام بالتفاصيل الحياتية، المقترن بتحليل البنى العميقة، هو ما يجعل التاريخ الذي يكتبه “حيّاً” ومتجذراً في التجربة الإنسانية. إنه تاريخ لا يخاطب العقل فقط، بل يثير الخيال التاريخي، ويمكن القارئ من استحضار العالم الاجتماعي الذي انقضى، بكل تعقيداته وتناقضاته وأشكال مقاومته للنسيان.
يتجلى العمق التحليلي للكتاب في مقاربته لعلاقة إينولتان بالدولة المغربية، والتي يرفض فيها التوفيق القراءة الثنائية المبسطة التي ترى إما خضوعاً مطلقاً أو تمرداً دائمًا. بدلاً من ذلك، يرسم علاقة معقدة متعددة المستويات، تقوم على جدلية “الجباية والتسخير” من جهة، و”المقاومة والتفاوض” من جهة أخرى. فمن خلال تتبعه لديناميات التعيينات المخزنية للقواد، مثل علي أوحدو وابنه الجيلالي الدمناتي، يظهر كيف أن هذه الشخصيات لم تكن مجرد أدوات طيعة في يد المخزن، بل كانت فاعلاً وسيطاً له ولمصالحه الخاصة ومناوراته المحلية. فالقائد المحلي بحسب التوفيق، كان يعيش في حيز وسطي: عليه أن يضمن جباية الضرائب للدولة ليبقي على شرعيته لديها، وفي نفس الوقت عليه إدارة توترات محلية وعدم إثقال كاهل السكان بما يدفعهم للتمرد. هذه الوضعية الهشة أنتجت أشكالاً من “السياسة المحلية” تتسم بالبراغماتية والمرونة، حيث يتم تفاوض مستمر صريح وضمني، على حدود السلطة والامتيازات والواجبات.
كما يسلط التوفيق الضوء على الآليات التي استخدمها سكان إينولتان للمقاومة اليومية والحد من تغلغل السلطة المركزية. فلم تكن “السيبة” أو التمرد المسلح هو الشكل الوحيد للمقاومة، بل شملت استراتيجيات أخرى أكثر “خفاء” كالتقليل من التصريح بالممتلكات في سجلات “الترتيب”، أو الاستناد إلى الأعراف المحلية لتقويض أحكام القضاء المخزني، أو استخدام المؤسسات التقليدية كالزوايا والجماعات كفضاءات للاستقلال النسبي. هذا التعدد في أشكال المقاومة يكشف عن “فن” سياسي شعبي، قائم على المعرفة الدقيقة بحدود القوة ومساحات المناورة المتاحة. إنها دينامية لا تنفي وجود سلطة المخزن، بل تؤكد على أن هذه السلطة، حتى في ذروة محاولاتها المركزية، كانت تواجه بعملية مستمرة من “إعادة التفاوض” على الأرض من قبل المجتمعات المحلية.
في تحليله للتحولات الاقتصادية، يربط التوفيق ببراعة بين المستويين المحلي والعالمي، مظهراً كيف أن انفتاح الاقتصاد المغربي على التجارة الأوروبية في القرن التاسع عشر لم يكن ظاهرة ساحلية فقط، بل كانت له انعكاسات عميقة على اقتصاد الجبال الداخلية. فمن خلال تتبع تطور أسواق مثل دمنات، يظهر كيف أن المنتجات المحلية كالزيت والصوف والجلود أصبحت جزءاً من دوائر تجارية أوسع، وكيف أن تدفق البضائع الأوروبية، خاصة الأقمشة، بدأ يؤثر على الصناعات التقليدية المحلية. هذا الربط الدقيق بين “الاقتصاد العالمي” الناشئ و”اقتصاد القبيلة” الجبلي يقطع مع النظرة التي تعتبر هذه المجتمعات منعزلة، ويقدم نموذجاً لكيفية استيعاب التحولات الكبرى وإعادة إنتاجها على المستوى المحلي. فهو لا يصور إينولتان كضحية سلبية لهذه التحولات، بل كفاعل يتكيف ويقاوم، ويستفيد أحياناً ضمن شروط غير متكافئة.
أما على المستوى الثقافي والرمزي، فيمثل الكتاب إسهاماً مهماً في تاريخ العقليات والممارسات اليومية. فمن خلال تحليله “لنوازل” فقهاء مثل الكيكي، لا يقتصر التوفيق على الجانب القانوني، بل يغوص في العالم القيمي والذهني لسكان إينولتان. هذه النوازل، بأسئلتها عن الأرض والماء والميراث والزواج، تتحول تحت قلمه إلى نافذة على التصورات الاجتماعية للعدل والإنصاف، وعلى التوتر بين الأعراف المحلية والشريعة الإسلامية، وبين مصالح الفرد وضغوط الجماعة. إنه تاريخ للصراعات اليومية حول الموارد النادرة، وللمعاني التي يمنحها الناس لهذه الصراعات. هذا الاهتمام بالبعد الثقافي والرمزي للحياة الاجتماعية يمنح التحليل الاقتصادي والسياسي بعداً إنسانياً أعمق، ويذكرنا بأن التاريخ الاجتماعي لا يقتصر على البنى المادية، بل يشمل أيضاً عوالم المعنى التي تمنح الحياة شرعيتها وتفسيرها.
من خلال هذا التركيب المتقن بين التحليل الاقتصادي والتاريخ السياسي وأنثروبولوجيا الممارسات اليومية، ينجح التوفيق في تقديم رؤية شاملة لا تجزئ الواقع الاجتماعي. بحيث أن مجتمع إينولتان في كتابه ليس مجرد وحدة إدارية أو كيان اقتصادي، بل هو نسيج معقد من العلاقات الاجتماعية، والتمثلات الثقافية، والاستراتيجيات الفردية والجماعية، التي تشكلت وتفاعلت في رحم تحولات تاريخية كبرى. هذا التصور المركب هو الذي يمنح الكتاب قيمته المستمرة، ليس فقط كمرجع عن فترة زمنية معينة، بل كنموذج منهجي لإمكانيات الكتابة التاريخية التي تحترم تعقيد الماضي وغناه.
أما على مستوى التحليل البنيوي، يقدم الكتاب قراءة متأنية للتنظيم الاجتماعي الداخلي لقبيلة إينولتان، متجاوزاً في ذلك النماذج الجاهزة التي حاولت فرض مقولاتها على واقع المجتمعات المغربية. فالتوفيق لا يتبنى نموذج “إيخص” الأسري الذي طرحه جاك بيرك في دراسة سكساوة، بل يقدم نموذج “الأسرة الكبيرة” أو “المشاعة العائلية” التي تضم عدة أجيال وتعيش في إطار اقتصادي موحد. هذا الاختلاف الجوهري ليس مجرد تباين في التسميات، بل يعكس تنوعاً حقيقياً في البنى الاجتماعية بين قبائل الأطلس، مما يحذر من تعميم النماذج التفسيرية. كما يتجنب المؤلف الوقوع في فخ التقسيمات الاصطلاحية الجاهزة، مقتصراً على وصف التنظيم الداخلي كما يتجلى من خلال الوثائق والممارسات المحلية، في حركة منهجية دالة على احترام خصوصية المادة المدروسة ونبذ للإسقاطات المفاهيمية المسبقة.
وفي تحليله للعلاقات الاجتماعية، يبرز التوفيق دور التضامنات الأفقية والعمودية في تشكيل النسيج الاجتماعي. فإلى جانب الروابط القرابية التقليدية، كانت هناك أشكال أخرى من التضامن القائم على الجوار، والمصلحة المشتركة، والانتماء إلى نفس الجماعة السكنية أو نفس وحدة الاستغلال الزراعي. كما يظهر كيف أن هذه التضامنات لم تكن تمنع من وجود صراعات داخلية حول الموارد، خاصة الأرض والماء، والتي كانت تتفجر في فترات القحط والمجاعات. هذا الاهتمام بالتفاعل بين التضامن والصراع يمنح الصورة الاجتماعية عمقاً واقعياً، بعيداً عن أي مثالية رومانسية للحياة القبلية.
يمعن التوفيق في تحليل دور الزوايا والمرابطين، ليس فقط كوسطاء بين القبيلة والدولة، بل كلاعبين مركزيين في تشكيل الحقل الديني والرمزي المحلي. من خلال التركيز على زوايا كالزاوية الدرقاوية والتيجانية والرحالية وغيرها، يظهر كيف أن هذه المؤسسات كانت تمتلك سلطة روحية متجذرة في الاعتقاد الشعبي، وتتمتع بنفوذ اقتصادي كبير من خلال أملاكها الواسعة، وتلعب دوراً سياسياً كوسيط في النزاعات الداخلية والخارجية. هذا التحليل المتعدد الأبعاد للزاوية يخرجها من الإطار الديني الضيق إلى الفضاء الاجتماعي الشامل، حيث يتداخل الاقتصادي بالروحي والسياسي.
كما يقدم الكتاب إسهاماً مهماً في تاريخ الذهنية والممارسات اليومية من خلال اهتمامه بالأدب الشفوي والحكايات والأمثال والأشعار التي حفظتها ذاكرة السكان. فالتوفيق لا يعتبر هذه المواد مجرد “تراث فولكلوري”، بل يقاربها كمصادر تاريخية تكشف عن التصورات الجمعية للعدالة، والسلطة، والعلاقات بين الجنسين، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. فالمثل القائل “تاغولت من تاغولت او ليحر” (بقعة إلى بقعة حتى البحر)، الذي ارتبط بالقائد علي أوحدو عن تملك الأرض، ليس مجرد قولة عابرة، بل هو تعبير عن نظام قيمي خاص، وربما شكل من أشكال النقد الخفي لسلوكيات النخب المحلية.
من الناحية الأسلوبية، يجمع الكتاب بين دقة البحث الأكاديمي وجمالية التعبير الأدبي. فالسرد التاريخي عند التوفيق لا يقتصر على تحليل الجفاف والجردان، بل يتخلله وصف حي للمشاهد الطبيعية، ولحظات الحياة اليومية، مما ينقل القارئ إلى عالم إينولتان في القرن التاسع عشر. هذا الاهتمام بالصورة والتشبيه لا يضفي على النص متعة جمالية فحسب، بل يعمق الفهم التاريخي من خلال استحضار الأجواء والإحساس بالزمن والمكان. إنه تاريخ يكتب بعين المؤرخ وقلب الروائي الأديب، في توازن نادر يعكس سعة ثقافة المؤلف وعمق تأثره بالمدرسة التاريخية التي تهتم بإعادة بناء الأجواء العامة للعصور الماضية.
يمكن اعتبار “المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: إينولتان 1850-1912” أكثر من مجرد كتاب في التاريخ الاجتماعي، بل هو مشروع فكري طموح ومتكامل، يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ المغربي من منظور جديد، أكثر شمولية وعمقاً، ويجسد منعطفاً إبستيمولوجيا في الكتابة التاريخية المغربية. فهو ينتقل من تاريخ الأحداث إلى تاريخ البنى، ومن تاريخ النخب إلى تاريخ الناس العاديين، ومن المركز إلى الهامش، دون أن يقع في فخ التبسيط أو الانزياح الأيديولوجي.
عمل التوفيق يؤسس لوعي تاريخي نقدي، قادر على تفكيك الصور النمطية واستكناه الجذور البنيوية للإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تأثيراتها ماثلة حتى اليوم.
إنه عمل يذكرنا بأن مهمة المؤرخ ليست مجرد جمع الوقائع وسرد الأحداث، بل فهم المنطق الخفي الذي يحكم تحولات المجتمعات، واستنطاق الصمت الذي يلف حياة من لم يتركوا أرشيفاً مكتوباً. بهذا المعنى، فإن إسهام أحمد التوفيق يتجاوز حدود حالة إينولتان، ليشكل إضافة نوعية لتاريخ المغرب الكلي، ويظل مرجعاً أساسياً لأي باحث يطمح إلى فهم التعقيدات الاجتماعية والثقافية التي شكلت المغرب الحديث.
يحق لهذا الكتاب أن يكون علامة فارقة في التأريخ الاجتماعي ليس فقط في المغرب، بل في العالم العربي ككل.




