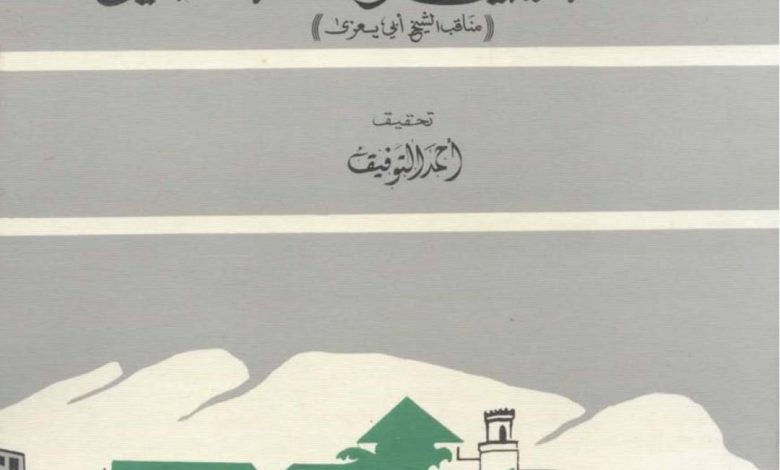
أنطولوجيا الولاية وإبستمولوجيا اليقين في المغرب الوسيط:
قراءة في الأسس المعرفية لنص العزفي
ومنهج أحمد التوفيق في تحقيقه لكتاب
دعامة اليقين في زعامة المتقين
بقلم: د. حمزة مولخنيف، المغرب
يحتلّ أبو العباس أحمد بن أحمد العزفي موقعًا فريدًا في تاريخ الثقافة الروحية بالمغرب الوسيط، ليس فقط لكونه أحد الكتّاب الذين خلدوا سيرة الشيخ أبي يعزى، بل لأن خطابه يعكس بجلاء مسارًا معرفياً وروحياً تشكّل في قلب تحولات عميقة مست المجتمع المغربي خلال القرون التي سبقت وصول النص إلينا. فالعزفي ليس مؤلفاً منعزلاً عن زمنه، بل هو ابن بيئة مشدودة إلى مخيال الولاية، وإلى شبكات الطرق والزوايا في مرحلة اتسمت فيها البنيات السياسية بالتماوج واللااستقرار، بينما حافظت البنيات الروحية على نوعٍ من الانسجام الوظيفي أدى دورًا محورياً في تهدئة الأعصاب الجماعية للمجتمع المغربي.

من ينظر في طبيعة العصور التي عاش فيها العزفي يدرك بسرعة أنّ الغرب الإسلامي كان يعيش حالة تحوّل دائم، سواء من حيث تقلّب السلطان السياسي، أو من حيث احتدام النزاعات القبلية، أو من حيث اتساع الهوّة بين المركز السياسي والبوادي ذات الكثافة الروحية والصوفية، وهي بوادي تُنتج أولياءها وتبني ذاكرتها الروحية بطريقتها الخاصة. هذا الإيقاع التاريخي المضطرب جعل الكتابة المناقبية، بوصفها وسيلةً لإنتاج المعنى، نوعاً من “حماية رمزية” للمجتمع، حيث تتحول سيرة الولي إلى نموذج يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والقدر، وبين الجماعة والمقدس، وبين اليومي والميتافيزيقي.
في هذا السياق، كتب العزفي كتابه دعامة اليقين في زعامة المتقين، وهو عنوان يشي بوضوح بمشروعه المعرفي. فاليقين عند العزفي ليس مجرد حالة وجدانية أو مقام صوفي، بل هو أساسٌ للزعامة الروحية وللقيادة الأخلاقية التي يحتاجها المجتمع في لحظات الاضطراب. إن مفهوم “زعامة المتيقن” يبدو محاولةً لإعادة صياغة نموذج القيادة المثالية التي لا تقوم على السيف ولا على الغلبة، بل على صفاء البصيرة وعمق التجربة الروحية وقدرة الولي على تمثّل الحقيقة المطلقة في حياته اليومية. وبهذا المعنى، فإن العزفي يُقدّم مشروعاً فكرياً يتجاوز تسجيل مناقب أبي يعزى إلى بناء فلسفة روحية للوجود الإنساني كما يتصوره هو.
وإذا كانت الولاية في البيئة المغربية قد شكّلت محوراً مركزياً في هندسة الوعي الجمعي، فإن شخصية أبي يعزى بالذات تمثل أحد الأعمدة الكبرى في هذه الولاية، باعتباره من أشهر أولياء الجنوب المغربي وأكثرهم حضوراً في الذاكرة الشعبية. لقد نجح العزفي في التقاط هذه الهالة الروحية حول شخصية الشيخ، وتحويلها إلى نصّ يجمع بين السيرة والتعليم الروحي وترميم الذاكرة. هذا الاختيار لم يكن محايدًا، بل هو استجابة لاحتياجات ثقافية واجتماعية حقيقية: حاجة المجتمع إلى نموذج روحي يقاوم الفوضى، وحاجة الخطاب الديني إلى استعادة توازنه في وجه موجة عقلانية فقهية كانت تحاول في أحيان كثيرة تقليص حضور الكرامة والولاية في المجال العام.
والحق أن العزفي كان واعياً بأن الكتابة المناقبية لا يمكن أن تُختزل في تسجيل الغرائب والعجائب، بل هي نوع من التفسير الوجودي للعالم. لذلك نجد أن البناء العام للكتاب – كما يظهر من فصوله التي تتضمن “جواز الكرامة”، و“حقيقة الكرامة”، و“ذكر الولاية والولي”، و“ذكر الخضر”، و“ذكر إلياس واليسع” – يشتغل على تأسيس منظومة معرفية تُعيد الربط بين العالم المرئي والعالم المتعالي. ومن ثَمّ فالكاتب لا يقدّم كرامات أبي يعزى باعتبارها أخباراً منفصلة، بل يقدّمها باعتبارها حلقات في مشروع روحي يهدف إلى إزالة الغشاوة عن عيون القارئ، ودفعه إلى رؤية أعمق لِما وراء الظاهر.
هذا التوظيف للكرامة ليس بريئاً، لأنه جزء من محاولة لترسيخ اليقين في نفوس المتلقين. فاليقين كما يتبدى في الكتاب، ليس استدلالاً عقلياً بقدر ما هو تجربة وجودية متجذرة، والولي هو الدليل العملي على إمكان تحقق هذا اليقين. ولذلك جاءت شخصية أبي يعزى في الكتاب لا بوصفها فرداً له خصوصيته، بل بوصفها تجسيداً لمثال روحي، أي لِما يسميه العزفي “الزعامة”، حيث تتحول السيرة إلى وسيلة لبناء نموذج يُحتذى، لا لتسجيل حياة رجل فحسب.
من جهة أخرى، ينتمي العزفي إلى تقليد فقهاء ومؤرخين مغاربة عاشوا على حافة التصوف، فلم يكونوا صوفية بالنشأة، لكنهم لم يستطيعوا تجاهل الوزن الروحي والاجتماعي للمجال الصوفي. هذا التوتر بين العالم الفقهي وبين روح التصوف واضح في طريقة بناء الكتاب: لغة تجمع بين النصوص الشرعية وبين الحكايات الروحية، بين دقة الرواية وبين حرية التخييل الرمزي. النص يُزاوج بين العقل والنقل، بين الخبر وتأويله، بين التاريخ وبين الذاكرة؛ وهو بذلك يعكس حالة التفكير في الغرب الإسلامي الذي كان يعيش على إيقاع جدل دائم بين الفقهاء والصوفية.
ولعلّ من أهم ما يميز مشروع العزفي أن كتابته ليست كتابة فلسفية صريحة، لكنها تنطوي – في العمق – على رؤية فلسفية للوجود تخصّ الغرب المغربي الوسيط. فهي رؤية تجعل العالم محكوماً بتداخل عميق بين المرئي واللامرئي، وبين الإنسان وقدره، وبين الطبيعة وقواها الغيبية. شخصية الولي في هذا السياق، ليست مجرد شخصية تاريخية، بل هي كائن ينتمي إلى نقطة تماس بين العالَمين، ولهذا السبب تُدرج في الكتاب أسماء مثل الخضر وإلياس واليسع باعتبارهم رموزاً للمعرفة الباطنية واستمرارية الإلهام الإلهي في عالم الناس.
بناء على هذا، يصبح نص دعامة اليقين وثيقة أنثروبولوجية قبل أن يكون وثيقة تاريخية. إنه يُقدّم لنا تمثّلات الناس للعالم في المغرب الوسيط: كيف يفهمون الزمن، وكيف يفهمون السلطان، وكيف يقاومون الفوضى، وكيف يبنون معنى لحياتهم. فالكرامة ليست مجرد حدث فيزيائي خارق، بل هي لغة رمزية وأداة لإعادة بناء الثقة بين الإنسان والعالم، بين الفرد والجماعة، بين الأرض والسماء. ومهما بدا النص بعيداً عن المعايير التاريخية الحديثة، فإنه يقدم مادة لا غنى عنها لفهم “تاريخ العقل الروحي” في المغرب، وهو تاريخ لا يمكن قراءته إلا عبر مثل هذه النصوص.
ومن خلال هذا المعطى، لا يمكن التعامل مع العزفي باعتباره كاتباً لمناقب أبي يعزى فقط، بل يجب اعتباره مؤرخاً للروح الصوفية المغربية، وواحداً من الذين نجحوا في تسجيل البنية الرمزية التي كانت تُنظم حياة القبائل والمجتمعات. لقد رأى العزفي في سيرة أبي يعزى أكثر من إرث فردي، بل مرآة تعكس علاقة الإنسان المغربي بقيم التقوى والزهد واليقين. ولذلك يصبح نصه هذا نصا تأسيسياً لا لإعادة بناء سيرة شيخ فحسب، بل لإعادة بناء الخيال الاجتماعي لمرحلة كاملة.
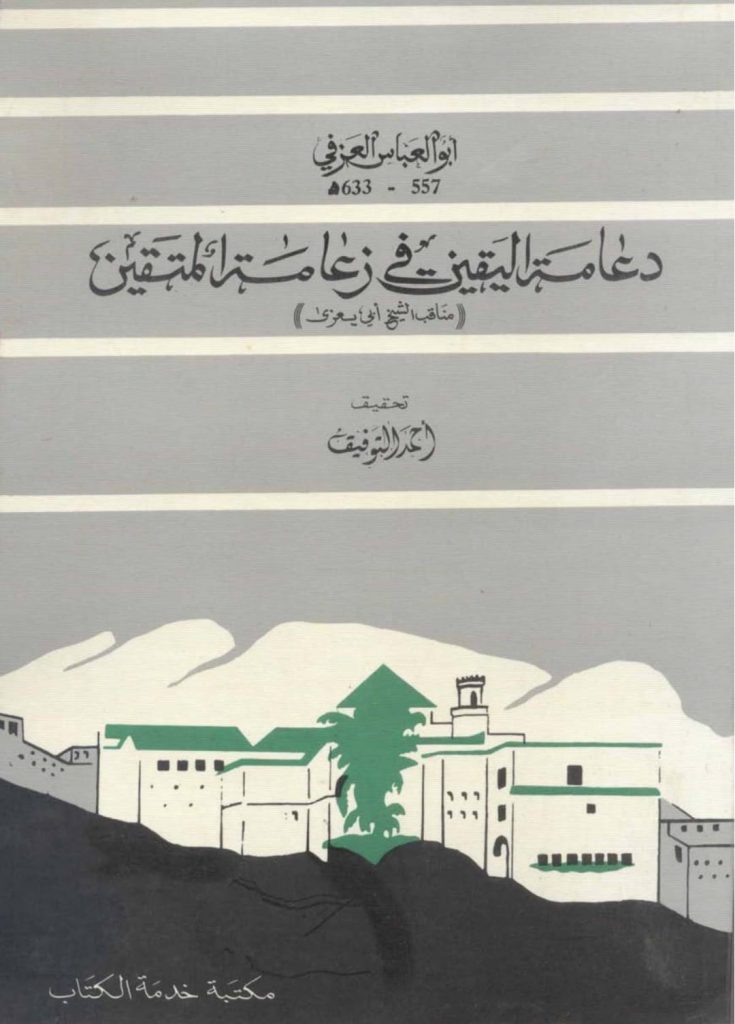
إنّنا أمام كاتب واعٍ بمهمته، قادر على تحويل التجربة الروحية إلى مشروع معرفي، وعلى جعل السيرة الذاتية أداة لترميم الذات الجماعية. ومن خلال قراءتنا المتواضعة هذه، نفهم لماذا ظل دعامة اليقين نصاً مؤثراً في الوعي المغربي، ولماذا استحق أن يُعاد تحقيقه وتقديمه للباحثين في الزمن الحديث.
إنّ دعامة اليقين في زعامة المتقين ليس مجرد “كتاب مناقب” بالمعنى الشائع لهذا اللون من التأليف، بل هو بناء معرفي وروحي بالغ التركيب، يندرج ضمن تقليد طويل سعى إلى ترسيخ موقع مركزي للولاية في تشكيل المخيال الجمعي للمغاربة، وفي إعادة إنتاج معنى الوجود داخل فضاء عربي-إسلامي كان يمرّ بتحوّلات سياسية وروحية عميقة.
وعندما نتأمّل فصول الكتاب وبنيته المفهومية – كما تكشف عنها قائمة محتوياته وتقسيماته الداخلية، التي تضم مباحث حول جواز الكرامة وحقيقتها، وكرامات الشيخ، والولاية والولي، ثم فصولاً عن الخضر وإلياس واليسع – ندرك أننا لا نقف أمام نصّ توثيقي يُعنى برصد الوقائع والأعلام فحسب، بل أمام مشروع يشتغل على نحت بنية رمزية للقداسة، وعلى تشييد “ميتافيزيقا لليقين” تمكّن القارئ من استعادة رؤية للعالم تتجاوز حدود المقاربة العقلانية-الوضعية، وتعيد وصل الإنسان بأفق روحي ينهض على الخبرة الوجدانية والمعنى الكوني للولاية.
ينطلق الكتاب من سؤال جوهري: ما معنى الولاية؟ وما معنى أن يكون للشيخ أبي يعزى منزلة مخصوصة تجعل كراماته دليلاً على يقينه؟ هذا السؤال، وإن بدا بسيطاً، فهو في العمق سؤالٌ عن طبيعة الإنسان وعن حدود معرفته، وعن علاقة الظاهر بالباطن. لذلك يأتي فصل “جواز الكرامة” في مقدمة النص، كما تكشف قائمة المحتويات، باعتباره تأسيسًا نظريًّا لمنطق الخطاب. العزفي لا يريد أن يدخل مباشرة في سرد مناقب أبي يعزى، بل يضع قبل ذلك إطاراً معرفياً يُقنع به القارئ بأن الكرامة ليست خرقاً للناموس الطبيعي فحسب، بل هي علامة على حضور الله في تفاصيل الحياة الإنسانية، وعلى أن العالم ليس مغلقاً على سببيته المادية.
هذا التأسيس النظري للكرامة يشكل مفتاحاً أساسياً لفهم المشروع الذي ينتمي إليه الكتاب. فالكرامة هنا ليست رواية عجائبية، بل دليل معرفي على طبيعة العلاقة بين الولي والحق. ومن هنا نفهم لماذا يفرد العزفي فصلاً خاصاً لـ“حقيقة الكرامة”، فالكرامة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي تجلٍ لمعنى اليقين، ونتيجة طبيعية لتصفية النفس وتهذيبها. وبذلك، فإن الكرامة تحضر في الكتاب كعنصر تربوي، لا كعنصر دعائي، كوسيلة لبلورة مفهوم معين للإنسان المؤمن، لا كطريقة لإبهار المتلقي.
ثم يأتي العمود الفقري للنص: “كرامات الشيخ الصالح أبي يعزى”. وهنا ينتقل العزفي من التنظير إلى التطبيق، ومن إقامة البرهان على إمكان الكرامة إلى سرد تجلياتها في حياة ولي بعينه. لكن من الضروري الانتباه إلى أن هذه الكرامات ليست مرتبة ترتيبًا زمنياً ولا منهجياً بالمعنى العلمي الحديث؛ بل إن ترتيبها يخضع لمنطق آخر، هو منطق الوظيفة الروحية التي تخدمها. فالعزفي يقدّم الكرامة باعتبارها رسالة وإشارة ودليلاً وأحيانًا تأديبًا، وأحياناً رحمة، فهي متعددة الوظائف، شأنها شأن الولي نفسه الذي يجمع في شخصيته عناصر الانجذاب إلى عالم الغيب، والرسوخ في واقع الناس.
إن النظرة النقدية لطبيعة الكرامات في الكتاب تكشف أنها تُبنى على مستويين: المستوى السردي، وهو ما يقدمه العزفي من أخبار وروايات؛ والمستوى الرمزي، وهو ما تشير إليه هذه الأخبار من رؤى للعالم. فعلى المستوى السردي، نجد تعدداً وثراءً في القصص، من شفاء المرضى، إلى كشف المغيبات، إلى حضور الخضر، إلى التحولات الروحية التي تصيب المريدين عند لقاء الشيخ. وهذه الأخبار ليست مجرد سرديات؛ إنها تمثّل طريقة لفهم العالم خارج حدود السببية الضيقة، وتعيد إلى العالم بعده العجائبي الذي كانت الثقافة الإسلامية ترى فيه حضورًا للمعنى.
أما المستوى الرمزي، فهو الأكثر أهمية. فالكرامة هنا رمز لسلامة الباطن، وعلامة على صفاء القلب، ودليل على اتحاد الولي بعالم المثال. والعزفي، وهو يعرض هذه الكرامات، يعمل في العمق على بناء مفهوم “الإنسان اليقيني”، أو الإنسان الذي يعيش في العالم وهو في الآن ذاته متصل بالعالم المتعالي. وهذا المفهوم يعكس رؤية صوفية-فلسفية للإنسان باعتباره جسراً بين الطبيعتين: طبيعة ترابية وطبيعة نورانية. وتأكيد العزفي على الحضور الروحي للخضر وإلياس واليسع، كما يظهر في لائحة المحتويات، هو في الحقيقة استحضار لرموز الحكمة الباطنية التي تُمثّل استمرار الوحي في التاريخ، واستمرار التربية الروحية في حياة الأولياء.
ويمتد البناء الدلالي للكتاب ليشمل موضوع المكان. فوجود “خريطة للمواقع المذكورة” في بنية العمل المحقق يشير إلى أن جغرافيا الولاية عنصر مركزي في تصور العزفي لمقام الشيخ. فأبو يعزى ليس ولياً عابراً للفضاء، بل هو وليّ مرتبط بأرض وبقبائل، وبطرق ومسالك. وهذا الارتباط بين الروح والمكان يفتح أمامنا باباً لفهم أنساق الولاية في المغرب الوسيط: فالولي هو أيضاً حارس الأرض، وحارس القيم، وقطبٌ روحي يعمل على حفظ توازن الجماعة. لذلك فإن كثيراً من الكرامات في الكتاب تدور حول حماية الناس، وحول ضبط النظام الاجتماعي، وحول استعادة الحقوق، وهو ما يكشف الوظيفة الاجتماعية للولي إلى جانب وظيفته الروحية.
وإذا ما انتقلنا إلى مستوى اللغة، فإن خطاب العزفي في هذا الكتاب يجمع بين الصرامة الفقهية في عرض الأدلة المتعلقة بالكرامة، وبين الانسيابية الروحية في سرد النموذج الأعلى للإنسان الصالح. فهو لا يُسقط من حسابه المشروعية الشرعية للولاية، لكنه في الآن ذاته لا يكتفي بالمنهج الفقهي، بل يستعمل لغة تشبه لغة الحكماء، لغة تزاوج بين القصة والموعظة، بين الرمز والواقع، بين ظاهر السرد وباطنه. وهذه اللغة ليست مصادفة، بل هي جزء من استراتيجية خطابية تهدف إلى إقناع القارئ لا بالعقل وحده، بل بالقلب أيضاً، باعتبار أن المعرفة الروحية تتجاوز مجرد الاستدلال العقلي.
ومن أهم ما يميز بنية الكتاب حضور البعد التربوي. فالكتاب كله من المقدمة إلى الخاتمة، شبيه بسفر روحي، يتعلم منه القارئ كيف يكون اليقين، وكيف يتدرج في المقامات الروحية، وكيف يرى العالم بعين الولاية لا بعين الحسّ وحده. حتى حين يعرض العزفي لبعض المفاهيم كـ“الولي” و“الولاية”، فإنه لا يفعل ذلك بطريقة تجريدية، بل برؤية تربط هذه المفاهيم بالحياة اليومية وبالسلوك، ليؤكد أن الولاية ليست مقاماً ميتافيزيقياً فحسب، بل هي ممارسة أخلاقية، سلوك في الناس واعتدال في الظاهر وصفاء في الباطن.
كما يتضح من النص أن العزفي لا يقدّم الكرامات أو الولاية باعتبارها معطيات جاهزة، بل باعتبارها صيرورة. فالولي لا يولد ولياً، بل يصير كذلك عبر مجاهدة النفس، وعبر تدرج في مقامات المعرفة والسلوك. وهذا التصور الصيروري ينسجم مع الرؤية الصوفية التي ترى في الإنسان كائناً قابلاً للكمال، قادراً على أن يتحول من إنسان عادي إلى إنسان ربّاني إذا تدرّب وتطهّر وسعى في طريق الحق.
لكن الأهم من ذلك هو أن دعامة اليقين لا يقدم نموذج الولاية بشكل منغلق أو منعزل عن العالم. فالعزفي يجعل من أبي يعزى إنساناً يعيش بين الناس، يجيب أسئلتهم، يعالج أمراضهم، يسافر، يتفاعل مع الأحداث اليومية، ويُظهر كراماته في سياق اجتماعي واضح. وهذا الانغراس في الواقع يكشف أن الولاية كما يتصورها العزفي، ليست انسحاباً من العالم، بل انخراطاً فيه. الولي ليس راهباً، بل مصلحاً، ليس متعبداً في صومعته فقط، بل فاعلاً في مجتمعه، حاملاً لعبء الناس. وهذا التصور يُسهم في جعل الولي نموذجاً اجتماعياً، لا مجرد شخصية روحية.
إن الصورة التي يبنيها العزفي عن أبي يعزى ليست فقط صورة شيخ صالح، بل صورة “قطب روحي” يحتل موقعاً مركزياً في بنية المخيال المغربي. وبهذا، يصبح الكتاب وثيقة لفهم علاقة المغاربة بالمقدس وبالزمن وبالأرض وبالآخر. فكل كرامة وكل قصة وكل إشارة في النص، هي في الحقيقة نافذة تطل منها الذهنيات المغربية في القرون الوسطى، بكل ما فيها من عمق ووظائف وتعقيد.
إن كتاب دعامة اليقين يقدّم تجسيداً كاملاً للمفهوم المغربي للولاية: ولاية تجمع بين الزهد والعلم، بين الروح والمجتمع، بين البساطة الظاهرة والعمق الباطني. وهو بهذا يُعدّ واحداً من النصوص الأساسية لفهم بنية التصوف المغربي وفلسفته وتاريخه، والوظائف الاجتماعية والسياسية التي يؤديها.
منهج أحمد التوفيق في تحقيق دعامة اليقين : لمحة وجيزة حول الأسس المعرفية وخلفياتها العلمية
يمثل تحقيق أحمد التوفيق لكتاب دعامة اليقين في زعامة المتيقن مرحلة جديدة في مسار تلقي هذا النص المناقبي، إذ لم يقتصر عمله على إخراج المخطوط إخراجاً مادياً، بل سعى إلى إعادة بناء النص علمياً، وتحويله إلى مادة بحثية قابلة للتداول الأكاديمي. ومعروفٌ أن التوفيق ليس محققاً عادياً، ولا يمكن فصل منهجه في التحقيق عن خلفيته الفكرية وتكوينه العلمي في التاريخ الاجتماعي للمغرب، وهو تكوين جعله ينظر إلى النصوص الصوفية لا باعتبارها سجلات روحية فقط، بل باعتبارها وثائق اجتماعية تكشف أنماط العيش ورؤى الناس للعالم، وطرائق بناء السلطة الروحية داخل البنى القبلية.
إن أول خصيصة يمكن الوقوف عندها في منهج التوفيق هو صرامته الفيلولوجية. فقد أثبتت مقدمة التحقيق – كما يظهر من بنية الكتاب والاعتماد على “النسخ المعتمدة” – أنّ التوفيق التزم بمنهج المقارنة بين النسخ، وهو منهج لا يستقيم بدونه تحقيق نصوص مثل المناقب، لأن هذا الصنف من الكتابة يُعرف بتعرضه لإضافات شعبية، وتوسعات تفرضها طبيعة التلقي الشفوي، وتداخل الرواية العالِمة بالرواية الشعبية. فالمناقب بخلاف النصوص الفقهية أو اللغوية، نصوصٌ حيّة تتفاعل مع الناس وتُعاد كتابتها، وتُنقل بطرق متعددة لا تخضع بالضرورة لمنطق الضبط الصارم. لذلك كان لزاماً على التوفيق أن يعتمد أكثر من نسخة، وأن يعيد تركيب النص وفق معايير النقد النصي الحديث، مع الحرص على ضبط المواضع المختلف فيها.
ولعل أبرز ما يميز هذا المنهج أن التوفيق لا يتعامل مع اختلافات النسخ باعتبارها انزياحات عرضية، بل بوصفها عناصر دلالية تتيح فهم تطور النص وتداولِه. فالفروق بين النسخ فرصة لفهم كيف تلقى الناس النص، وما هي الإضافات التي رأوا أنها تخدم صورة الشيخ أو تخدم الغرض التربوي للولاية. وهذا الحس التاريخي الدقيق جعل تحقيق التوفيق عملاً نقدياً، لا عملاً ميكانيكياً.
ومن جهة ثانية، يتضح من مقدمته – بالنظر إلى منهج التوفيق في أعماله الأخرى – أنه اشتغل على وضع النص في سياقه التاريخي والاجتماعي والثقافي. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن نصوص المناقب لا يمكن فهمها بالانفصال عن بيئتها. فالولاية في المغرب ليست ظاهرة دينية فقط، بل ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضاً. والزوايا لعبت دوراً مركزياً في التوازن بين المركز السلطاني وبين البوادي، وفي حفظ الأمن الروحي والثقافي. لذلك كان من الطبيعي أن يقدّم التوفيق في مقدمته عرضاً للمجال الجغرافي الذي عاش فيه أبو يعزى، ولطبيعة العلاقات القبلية، وللشروط الثقافية التي أنتجت هذه الولاية.
ومما يؤكد هذا البعد السياقي أنّ التوفيق أرفق النص بخرائط للأماكن الواردة فيه، وفق ما تُظهر قائمة المحتويات ، وهو أمر يكشف عن رغبة في ربط الولاية بالمجال، وفي تأكيد أن الكرامة ليست تجربة فوق-جغرافية، بل هي متجذرة في الأرض والناس. إن استعمال الخريطة في التحقيق ليس اعتباطاً، بل هو ممارسة ابستمولوجية حديثة تنقل النص من فضاء الذاكرة الغيبية إلى فضاء التاريخ الموقّع بالمعالم والمواقع.
ويبرز بعدٌ آخر لا يقل أهمية في منهج التوفيق وهو البعد الدلالي. فالنص، كما هو ظاهر من فصوله، حافل بمصطلحات تحتاج إلى شرح وتأصيل: الكرامة والولاية والخضر واليسع وإلياس. وهي مصطلحات قد تبدو واضحة للقارئ التقليدي، لكنها في سياق البحث الأكاديمي تحتاج إلى تفكيك. ومن المعروف أن التوفيق – بحكم تكوينه الفلسفي الضمني واطلاعه الواسع على التراث الصوفي – يقدم في تحقيقاته شروحاً مختصرة لكنها عميقة للمفاهيم، دون أن يسقط في التفسير العقلي الجاف، ودون أن يتحول إلى شارح صوفي متعصب للرمز. إنه يوازن بين القراءة التاريخية وبين الحساسية الروحية للنص، فيوضح المفهوم ويحدد أصله اللغوي والاصطلاحي، ويشير إلى تطوره في التراث، ثم يبين استعماله عند العزفي.
ومن عناصر القوة التي تُحسب لمنهج التوفيق، أنه لا يتورط في إصدار أحكام على المفردات الروحية للنص، فلا ينفي الكرامات بشكل نقدي مادي، ولا يثبتها بشكل إيماني مقرّر. بل يلتزم بما يمكن تسميته “تعليق الحكم”، وهو منهج قريب من الممارسة الأنثروبولوجية التي ترى في الرواية الروحية ظاهرة ثقافية يجب تفسيرها لا نفيها ولا إثباتها. وهذا الموقف النقدي المعتدل يجعل تحقيقه مثالياً للباحثين، لأنه يسمح بقراءة علمية للنص دون الإضرار بجوهره الروحي.
ويظهر كذلك في منهج التوفيق وعيٌ بأن النص المناقبي يتضمن تداخلاً بين ثلاثة مستويات: مستوى الخبر التاريخي، مستوى السرد الرمزي، ومستوى الوظيفة الاجتماعية. ومن هنا نراه – في هوامشه وفي طريقة تعليقه – يفرّق بين ما يمكن اعتباره تاريخاً، وبين ما يمكن اعتباره رمزًا، وبين ما يمكن قراءته باعتباره وظيفة اجتماعية للولي. فالولي في الثقافة المغربية ليس فقط رجلاً صالحاً، بل هو مركز سلطة رمزية، ومصدر حماية، وعقدة ربط بين الجماعات. وهذا الوعي يتجلى في طرق الشرح التي يعتمدها التوفيق، حيث يشرح مثلاً الأعلام البشرية، ويعرّف بالأماكن، ويضعها في سياقها، ويشير إلى دور الزوايا، ويربط بين بعض الكرامات وبين طبيعة السلطة في تلك المرحلة.
ولم يكن التوفيق يكتفي في منهجه بالمقارنة بين النسخ أو بشرح المفاهيم، بل حرص على توفير أدوات بحثية كاملة للباحثين، وهو ما يتجلى في الفهارس التفصيلية الموجودة في النسخة المحققة: فهارس الأشخاص والأماكن والكتب والطعام والنبات والحيوان. وهي فهارس تكشف أن تحقيق التوفيق لم يكن موجهاً للقارئ العادي، بل للباحث الأكاديمي وللمؤرخ الاجتماعي وللمختص في التصوف. ومن المعروف أن مثل هذه الفهارس تفتح الطريق أمام دراسات جديدة تتخذ النص مجالاً للرصد المجهري للثقافة الشعبية ولتاريخ الذهنيات وللتصورات الدقيقة للكون والطبيعة.
إنّ هذه الفهارس ليست مجرد قائمة ملاحق، بل هي ممارسة علمية تُمكّن القارئ من تتبع حضور مفهوم ما عبر النص، ومن فهم شبكة العلاقات داخل الرواية، ومن بناء صورة دقيقة للعالم الذي عاش فيه الشيخ. وهذا يضع التحقيق في مصاف الأعمال المرجعية التي لا تكتفي بإخراج النص، بل تُعيد إنتاج بنيته المعرفية.
وإضافة إلى ذلك، يكشف منهج التوفيق عن توجه علمي يهدف إلى “تفكيك سلطة السرد” دون هدمها. فهو يوضح للقارئ عبر الهامش والتحقيق من أين جاءت الرواية، وما علاقتها بالبيئة وكيف تلقّاها الناس، وفي أي سياق وظيفي وردت. لكنه لا يجرّد الرواية من قدسيتها ولا يحوّلها إلى مادة باردة. وهذه القدرة على الموازنة بين النقد والاحترام هي ما يجعل منهجه مثالياً في تحقيق النصوص الروحية.
ومن حيث الجانب المنهجي المحض، يُلاحظ أنّ التوفيق يختار عادةً أسلوب “التحقيق التفسيري” لا “التحقيق الحرفي”. فهو لا يكتفي بإيراد النص مضبوطاً، بل يقدّم إشارات دلالية وتاريخية تُعين على فهم النص وتفسيره. هذا النوع من التحقيق يتناسب مع طبيعة نصوص المناقب التي تتداخل فيها الرواية التاريخية بالرمزية، والتي تحتاج إلى قدر من التفسير لكي يستوعبها القارئ المعاصر.
ونجد كذلك أن التوفيق في منهجه لا يتعامل مع النص ككتلة واحدة، بل كطبقات معرفية: طبقة لغوية تحتاج إلى ضبط، طبقة سردية تحتاج إلى تحليل، طبقة اجتماعية تحتاج إلى تفسير، وطبقة روحية تحتاج إلى احترام. وهذا الوعي الطبقي يجعل تحقيقه نموذجاً يقترب من مناهج النقد التاريخي الغربي، دون أن ينفصل عن تقديره للتراث الصوفي المغربي.
وبالنظر إلى مجموع العناصر التي ذكرناها، يمكن القول إن منهج التوفيق في التحقيق يقوم على أربعة أركان رئيسة:
1- الصرامة الفيلولوجية: مقارنة النسخ وضبط الفروق.
2- التحليل التاريخي-الاجتماعي: فهم النص في سياقه الجغرافي والقبلي والصوفي.
3- التفسير الدلالي: تفكيك المصطلحات والمفاهيم الروحية.
4- البناء البحثي: وضع فهارس وآليات علمية تجعل النص قابلاً للدرس الأكاديمي.
وبهذا، فإن تحقيق التوفيق لا يقدّم لنا نص العزفي في شكله الأصلي فحسب، بل يقدّمه في شكله العلمي، كوثيقة معرفية قادرة على الإسهام في تاريخ التصوف المغربي، وفي تاريخ الذهنيات، وفي الدراسات حول الولاية والكرامة في الغرب الإسلامي.
مثل تحقيق أحمد التوفيق لكتاب دعامة اليقين في زعامة المتيقن لحظة مفصلية في إعادة تقديم النصوص المناقبية للمجال العلمي. فالتوفيق لم يكتف بتصحيح النص وإخراجه، بل أعاد موقع الكتاب داخل المدونة الصوفية، ونقله من دائرة التداول الشعبي والشفوي إلى فضاء البحث الأكاديمي، حيث تُقرأ النصوص قراءة متعددة المستويات، وتُستثمر في فهم تاريخ الذهنيات والسلطة الروحية في المغرب. ومن هذا المنظور، نرى أن عمله شكّل جسرًا بين زمنين: زمن الرواية التقليدية، وزمن التاريخ النقدي.
إن من أبرز إنجازات تحقيق التوفيق أنه أعاد الاعتبار لنصّ مناقبي تُعدّ قيمته الأساسية في عمقه الروحي والاجتماعي. فالكتابة المناقبية كثيراً ما وُضعت في الترتيب العلمي التقليدي، في مرتبة أقل من مرتبة النصوص الفقهية أو الحديثية، بسبب اعتمادها على السرد وتضمّنها لكرامات ورموز. غير أنّ التوفيق من خلال منهجه التحقيقي، أعاد للنصّ مكانته باعتباره وثيقة معرفية تكشف بنية الذهنيات، وتوضح كيف كان المجتمع المغربي يبني معناه الروحي، ويؤثث عالمه بالمثاليات الأخلاقية التي تشكل جزءاً من نظامه الاجتماعي.
وقد أظهر التحقيق أنّ النصوص المناقبية ليست هامشاً، بل هي قلب الثقافة الروحية المغربية، لأنها تعبّر عن تمثّل الناس للقداسة، وعن حاجتهم إلى نموذج روحي يُعيد للمجتمع توازنه، ويضبط سلوك الأفراد. ومن خلال إخراج الكتاب بهذه الطريقة، أكّد التوفيق أنّ المناقب ليست مجرد سرديات عجائبية، بل وثائق ثقافية غنية، تحتاج فقط إلى تحقيق علمي يُبرز قيمتها.
ومن وجوه التميز في عمل التوفيق أنه أتاح للباحثين أدوات دقيقة لقراءة الكتاب وفق مناهج متعددة: المنهج التاريخي والمنهج الأنثروبولوجي والمنهج الفيلولوجي والمنهج المقارن. فالفهارس التفصيلية التي أدرجها في التحقيق – والتي تشمل الأشخاص والأماكن والجماعات والكتب والنبات والحيوان والطعام، كما يُظهر محتوى النسخة المحققة – جعلت من الكتاب مرجعاً قابلاً للدرس على مستويات عديدة. يمكن للمؤرخ أن يتتبّع من خلالها انتشار شبكة الولاية؛ ويمكن للأنثروبولوجي أن يدرس بنية الرموز؛ ويمكن للباحث اللغوي أن يكتشف المصطلحات الصوفية وكيفية استخدامها؛ ويمكن للفيلولوجي أن يتابع الفروق الدقيقة بين النسخ.
إنّ مثل هذه الأدوات تُعدّ ثمرة لوعي أكاديمي عميق بوظيفة التحقيق. فالنصّ المحقق ليس مجرد نص، بل هو “إعادة بنائه” بطريقة تجعل كل تفاصيله قابلة للتحليل. وهذا ما فعله التوفيق: جعل نصّ العزفي بنية شفافة، تسمح للقارئ بأن يرى من خلالها الملامح الدقيقة للعصر وللثقافة.
ومما يعطي للتحقيق قيمة إضافية أنه أعاد فتح الباب أمام دراسة شخصية أبي يعزى في ضوء نصّ أُعيد ضبطه، مما يتيح للباحثين إعادة تركيب ملامح الولاية المغربية دون اضطراب. فوجود نص مضبوط يساعد على استكشاف المعاني العميقة للولاية والكرامة في المخيال المغربي، وعلى فهم دور الولي في المجال القبلي، وعلى تتبع وظائف الزاوية التي تشكّلت حوله لاحقًا.
وإحدى أهم ثمار تحقيق التوفيق أنه قدّم نموذجاً للتحقيق الذي يوازن بين احترام البعد الروحي للنص وبين ضرورة التمكّن العلمي. فهو يتعامل مع الكرامات بوصفها جزءاً من ثقافة، ومع الولاية بوصفها ظاهرة اجتماعية، ومع نص العزفي بوصفه خطاباً مُركباً من عناصر رمزية وسردية ووثائقية. وهذه القراءة المتوازنة تجعل الكتاب في نسخته المحققة، نصا صالحًا للتحليل داخل حقل “تاريخ الذهنيات”، وهو حقل يكشف عن طبيعة الوعي الجمعي، وعن كيفية بناء الجماعة لمعانيها، وعن الدور الذي تلعبه التجربة الروحية في ترسيخ الاستقرار الثقافي.
ولعل من أعمق آثار عمل التوفيق أنه أعطى للنص قدرة جديدة على الحياة داخل الأوساط العلمية. فالنص بعد تحقيقه، لم يعد مجرد وثيقة محفوظة على رفّ، بل أصبح جزءاً من النقاش العلمي حول التصوف المغربي، ومصدراً يُعتمد عليه في بناء الأطروحات الجامعية، ودراسة الولاية، وفهم العلاقة بين الشيخ والمجتمع، ودراسة شبكة الأولياء في الأطلس والجنوب والشمال المغربي وغيره. بل أكثر من ذلك، يمكن القول إن عمل التوفيق أخرج نص العزفي من دائرة “التراث” إلى دائرة “المعرفة”.
وتتجلّى أهمية ذلك بشكل خاص في الطريقة التي أعاد بها التحقيق صياغة علاقة النص بالزمان. فقد كان النص قبل التحقيق مرتبطاً بزمنه الخاص، وهو زمن التلقي الشعبي. لكن التوفيق أعاد توطينه داخل الزمن الأكاديمي، فأصبح جزءاً من مسار طويل في دراسة التصوف المغربي، إلى جانب نصوص أخرى كـ«دلائل الخيرات» وإن كان في الصلوات، وكتب المناقب والتراجم وغيرها. وهذه الحركة الزمنية تعكس قدرة التحقيق العلمي على جعل النصوص التراثية قابلة للاندماج في سياقات معرفية جديدة، دون أن تفقد معناها الأصلي.
كما أن إخراج النص بخط محقق وواضح، مع ضبط الأعلام والأماكن، يساعد على إعادة بناء الجغرافيا الروحية لمرحلة بكاملها. وهذا مما يسهم في إعادة تركيب تاريخ التصوف المغربي بطرق أكثر دقة ووضوحاً، خصوصاً أن كتاب العزفي يشكل وثيقة أساسية في تاريخ أولياء المغرب.
ومن النتائج الإيجابية التي ترتبت على تحقيق التوفيق أنّ النص أصبح قابلاً للمقارنة مع نصوص مناقبية أخرى، لأن ضبطه يجعل معجمه المفاهيمي مستقراً، وبنيته الداخلية واضحة. ويمكن للباحث المقارن أن يدرس صورة الولي عند العزفي، وأن يقارنها بصورة الولي في نصوص صوفية تراثية أخرى، فيكتشف التشابهات والاختلافات، ويستخلص من ذلك طبيعة الولاية المغربية.
ولا شك أن الإدراج المنهجي للفهارس والشروح وخرائط المواقع، قد ساعد على فتح النص أمام أسئلة جديدة: مثل علاقة الكرامة بالسلطة وعلاقة الولي بالقبيلة، ووظيفة الكرامة في الضبط الاجتماعي، وغيرها من الأسئلة التي كانت ستظل مبهمة لولا التحقيق المتقن.
إن منهج التوفيق في تحقيق هذا النص يمثل نموذجاً للتحقيق الذي يدمج بين احترام النص وتطوير أدوات فهمه. إنه تحقيق يجعل التراث قابلاً للحياة، ويحول النص الصوفي إلى وثيقة بحثية ذات قيمة، ويضع بين يدي الباحثين نصا يقدم مداخل متعددة لدراسة الولاية والكرامة ولتاريخ الثقافة المغربية، ولشبكات السرد الروحي في الغرب الإسلامي.
وبذلك غدا دعامة اليقين في حلّته المحقَّقة، عملاً يتجاوز حدود الكتاب، ليرتقي إلى مرتبة المرجع المعرفي والمصدر الصوفي في بابه، والخريطة الروحية لفهم المغرب الوسيط. ولعل هذا الأثر العلمي العميق هو ما يجعل جهد التوفيق إضافةً نوعية ومعلماً بارزاً في مسار تحقيق النصوص الصوفية.




