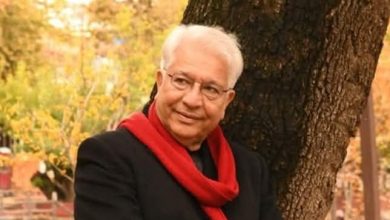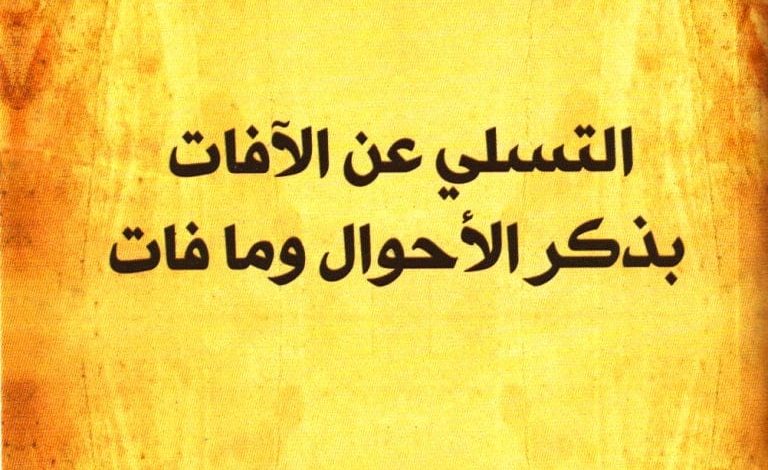
أنثروبولوجيا الآفات وتمثّلات الزمن:
قراءة فلسفية-تاريخية
في التسلي عن الآفات ومنهج تحقيقه
د. حمزة مولخنيف٫ المغرب
يقدّم كتاب التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات لمحمد الغجدامي نصّاً مركّباً لا يُشبه ما اعتاده القارئ في الكتابات التاريخية المغربية، فهو لا ينتمي تمام الانتماء إلى جنس التأريخ، ولا يستقرّ في قالب الوعظ، ولا يكتفي بمستوى الحكاية الشعبية، بل يتحرك بين هذه الطبقات جميعاً ليصوغ تجربة إنسانية تتداخل فيها الذاكرة والرؤية الأخلاقية وترسبات الواقع الاجتماعي. والاقتراب من الكتاب من داخل نصوصه يبيّن أن الغجدامي لا يكتب لأنه مؤرّخ لحقبة، بل لأنه شاهدٌ على أزمة؛ أزمة فرد عاش زمناً مضطرباً، وأزمة مجتمع يجد نفسه محكوماً بتقلبات لا يحمل عليها تفسيراً نهائياً، وأزمة معنى تتحرك في خلفية كل قصة وكل تعليق.
ولعلّ أول ما يستوقف القارئ في هذا السِّفْرالماتع هو حضوره الإنساني الكثيف. فصوت المؤلف ليس صوتاً محايداً ينقل الوقائع كما هي، ولا صوتاً مدرسياً يتوخى النظام والترتيب، بل هو صوت رجل يكتب وهو مكلوم، ممتلئ بالأسى على ما لحق زمنه من فساد، وما لحق نفسيات الناس من تشوهات. إن الكتاب لا يقدّم وصفاً عاماً للآفات، بل يصفها من الداخل، كما لو أنّ المؤلف لم يكن راوياً فحسب، بل كان أحد ضحاياها. ولذلك تظهر في لغته نبرة تململٍ وتوجّس، ونبرة حزنٍ أخلاقي على انحراف السلوك العام، وعلى استشراء الظلم، وانهيار قيم التضامن.
وتتجلّى القيمة الأدبية لهذا الكتاب حين نلاحظ أن الغجدامي لا يعرض الوقائع لذاتها، بل يعرضها بوصفها علامات على تحولات نفسية واجتماعية أعمق. فالقارئ يتابع قصصاً عن ظلم وقع على أفراد مجهولين، أو عن قاضٍ جائرٍ، أو عن رجل فقد جاهه، أو عن جماعة انقلبت أحوالها، ولكن ما يهم المؤلف ليس الحدث بقدر ما تهمه علّته؛ ليس الحكي بقدر ما يهمه ما يكشفه الحكي من بنية ذهنية. ولذلك يبدو الكتاب أشبه بمرآة حسّاسة تلتقط النوازع الداخلية: الخوف والطمعوالتفكك الأخلاقي، واستعمال السلطة في غير وجه الحق. وهذه الجوانب تجعل النص وثيقة اجتماعية قبل أن يكون وثيقة تاريخية.

ويلاحظ القارئ أن الغجدامي ينتقي من الأحداث ما يناسب التصوير الأخلاقي، لا ما يناسب البناء الزمني. فهو يقطع السرد دون تردد ليعلّق، أو يتوقف ليحاكم فعلاً أو شخصية، أو يعود ليقارن بين حال وحال. وهذا التفكك الظاهري ليس خللاً في البناء بقدر ما هو جزء من بنية النص نفسها، إذ يكشف عن طبيعة الكتابة التي ليست موجهة نحو إعادة بناء الماضي، بل نحو تفكيكه. ومن خلال هذا التفكيك تتولد حكمة، وتنكشف علّة، ويظهر الجانب المظلم في النفس البشرية. إنّ الكاتب يريد للقارئ أن يرى الفساد وهو يتشكل، لا من خلال الصور الكبرى، بل عبر الشرخ الصغير في السلوك اليومي.
وإذا كانت النصوص التاريخية التقليدية تُعنى غالباً بالمراكز: الملوك والصراع السياسي والتحولات الكبرى، فإن التسلي عن الآفات يتحرك في الهامش: في القرى وفي العلاقات اليومية وفي النزاعات الفردية الصغيرة. وهذا التركيز على الهامش يمنح الكتاب قيمة أنثروبولوجية بالغة؛ فهو يشكّل أرشيفاً دقيقاً لتصورات الناس عن السلطة، وللعلاقات الاجتماعية التي تربطهم، وللتمثّلات الأخلاقية التي تحدد نظرتهم إلى المصير والقدر. فما يرويه الغجدامي ليس التاريخ الرسمي للمغرب، بل التاريخ الخفيّ للعلاقات الإنسانية.
ويظهر من خلال قراءتنا الدقيقة للكتاب أن المؤلف يحمل تصوراً واضحاً للزمن، لا بوصفه تقدماً خطياً، بل بوصفه سلسلة دورية من الانقلاب والانحدار. فالزمن عنده لا يرحم؛ يرفع قوماً ويضع آخرين، ويمتحن الأخلاق قبل أن يمتحن القوة. ولذلك لا يستغرب القارئ أن يجد في الكتاب هواجس متكررة عن زوال النعم وعن انقلاب الأحوال، وعن المآل المحتوم لكل من انغمس في الدنيا دون تعقل. إنّ الوعي بالهشاشة هو المحرك الذي ينتظم مقاطع الكتاب، وهو ما يمنحه وحدة داخلية تتجاوز التباعد الظاهر بين فصوله.
ومن أهم ما يميز الأسلوب أن الكاتب لا يقدّم العبرة كخاتمة مفروضة على السرد، بل يتسلل إليها تدريجياً، كأنها تنبثق من الوقائع ذاتها. فهو لا يقول للقارئ ماذا يفعل، بل يعرض له كيف انتهى الآخرون حين سلكوا طريقاً معيناً. وبهذا الأسلوب، يتجنب الخطاب الوعظي المباشر، ويستعيض عنه بنوع من الحكمة السردية التي تجعل القارئ شريكاً في التفكير، لا متلقياً فقط. وهذه التقنية تجعل الكتاب أكثر قرباً من النصوص التي تنتمي إلى ما يمكن تسميته “التأمل السردي”، حيث تتكثف التجربة الإنسانية وتتحول إلى معنى.
ويكشف النص في مجموع مقاطعه عن لغة محلية مستبطنة، فصيحة في ظاهرها، لكن محمّلة بإيقاع مغربي واضح. فالغجدامي يستعمل تراكيب فصيحة، لكنه يستعير من البيئة الشعبية روحها، ومن التعبير الشفهي جماليته. وهذا المزج لا يمنح الكتاب خصوصية أسلوبية فحسب، بل يجعل من قيمه الأخلاقية جزءاً من ذهنية جماعية، لا من رؤية فرد منعزل. وهنا تكمن قيمة النص بوصفه وثيقة لِما كان المجتمع يراه “آفات” بالمعنى الوجودي، لا بالمعنى الأخلاقي الضيق.
إن التسلي عن الآفات ليس مجرد تجميع لقصص أو سرد لوقائع، بل هو مشروع لإعادة تأويل التجربة الإنسانية في لحظة تاريخية مضطربة. فالمؤلف لا يقدم الماضي كما هو، بل كما تشكّل في وعيه المتألم. وهذا التوتر بين الواقع والذاكرة هو الذي يجعل الكتاب نصاً حياً، قابلاً لأن يُقرأ خارج زمنه، لأنه يعكس شيئاً أساسياً في النفس البشرية: حاجتها إلى المعنى وسط الفوضى، وإلى الحكمة وسط الألم، وإلى التاريخ كمرآة لا كحُجّة.
يمتد المنحى السردي في التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات ليشكّل بنيةً داخلية متماسكة، تقوم على رصد لحظات الانكسار في حياة الأفراد والجماعات، وعلى تحويل تلك اللحظات إلى مدخل لقراءة أعمق للطبيعة البشرية. فالكتاب وإن بدا في ظاهره تجميعاً لمواقف وقصص، يبني مع تقدّم القراءة مشروعاً معرفياً خاصاً، لا يكتمل إلا حين نفكّك طريقة المؤلف في بناء المعنى من التفاصيل، وتحويل الجزئي إلى كلي، واليومي إلى دلالة ثقافية واسعة.
يبرز هذا المشروع بوضوح في الطريقة التي ينسج بها الغجدامي مشاهد تبدو بسيطة، لكنها تنطوي على توتر نفسي واجتماعي كثيف. فالمؤلف لا يقدّم الأحداث باعتبارها مجرد أمثلة، بل باعتبارها علامات على اختلال عميق في البنية الأخلاقية للمجتمع. وما يُروى من ظلمٍ فردي، أو تعسفٍ من قاضٍ، أو انقلاب في حظ شخصٍ بسيط، لا يقف عند حدود الحادثة، بل يتجاوزها ليكشف عن نمط من العلاقات التي كانت تحكم الناس: علاقات قائمة على الغلبة والرياء والخوف، أكثر مما كانت قائمة على العدل أو التكافل.
ويتبدى من خلال رصد هذه التفاصيل، أن الغجدامي يمتلك وعياً حاداً بالجانب النفسي للسلطة. فهو لا يصوّر السلطة في مظاهرها السياسية الكبرى، بل يصوّرها في أبسط مستوياتها: سلطة الأب وسلطة الشيخ، وسلطة القاضي وسلطة الجماعة. وهذه السلطة الصغيرة هي التي تكشف للكاتب وجهاً جديداً للآفات: آفة الإنسان حين يُبتلى بقدرٍ من القوة فيسرف، أو بقدرٍ من الضعف فيخضع، أو بقدرٍ من الحسد فيكيد. وما يجعل هذا الوعي مهماً أنه يربط بين الفساد الصغير والخراب الكبير؛ فالمجتمع، في عين المؤلف، لا ينهار دفعة واحدة، بل ينهار حين تتسرب الآفات إلى الداخل، إلى طبقات الحياة اليومية.
وفي هذا السياق ينهض السؤال: هل كان الغجدامي يسجل ما يرى فحسب، أم أنه كان يؤسس نقداً اجتماعياً مستتراً؟ يبدو من طبيعة السرد أنه لا يكتفي بوصف الظواهر، بل يميل إلى تفسيرها في ضوء رؤية ذاتية تشكلت من معايشة طويلة لتقلبات الزمن. ولذلك تعكس كثير من مقاطعه نبرة تشاؤم هادئة، تشاؤم مبني على تجربة لا على تنظير. فالمؤلف في أغلب الأحيان، لا يقول إن المجتمع فاسد، لكنه يريك الفساد، ويترك لك أن تستنتج آثاره. وهذه الطريقة تجعل السرد أقرب إلى النقد الضمني الذي لا يحتاج إلى شعارات، لأن قوته تأتي من تفاصيله لا من ادعاءاته.
وتكشف قراءة الكتاب أن الغجدامي ينحاز إلى الإنسان العادي، إلى المهمَّشين، إلى الذين لا يعرفهم التاريخ الرسمي. فهو يمنح صوتاً لمن سلبتهم السلطة الصغيرة حقهم، ويجعل من قصصهم أمثلة على آلية الظلم حين يتكرر في القرى والمدن من غير أن ينتبه إليه أحد. وهذا الانحياز لا ينطلق من موقف سياسي، بل من حسّ أخلاقي يرى في الضعف البشري إنذاراً دائماً بأن المجتمع بحاجة إلى إصلاح جذري، إصلاح يبدأ من النفوس قبل أن يصل إلى البنى.
ويتميّز الكتاب أيضاً، بقدرته على تحويل تجربة فردية إلى تجربة كلية. فالمؤلف يكتب كأنه يروي عن نفسه، ولكن القارئ يدرك سريعاً أن ما يُكتب يتجاوز حدود السيرة، لأنه يصوغ شعوراً جمعياً كان سائداً في تلك الحقبة: شعور الخوف من المستقبل ووهم الاستقرار، والإحساس بأن الإنسان واقف على أرض رخوة. وهذا الشعور ليس خاصاً بالمغرب وحده، بل هو جزء من التجربة الإنسانية في فترات الاضطراب، حيث تتراجع اليقينيات ويصبح الوعي بالزمن وعياً بالخسارة.
ومن اللافت أن الغجدامي لا يسعى إلى تجميل الواقع. فالسرد يكشف عن طبقات من القبح والظلم والأنانية، لكنه لا يقدّمها بغرض التشفي أو المبالغة، بل بوصفها حقيقة يجب النظر إليها دون مجاملة. وهذا الأسلوب يضع الكتاب في خانة الكتابات التي تسعى إلى “تعريـة المجتمع” دون أن تدعو صراحة إلى تغييره، إذ يكفي أن يَظهر الخلل حتى يستقرّ في ذهن القارئ أن الواقع بحاجة إلى مراجعة. وهذا النوع من النقد الهادئ هو ما يجعل الكتاب نصاً أخلاقياً من الداخل، دون أن يكون موعظة مباشرة أو بياناً إصلاحياً.
ومع ذلك لا يخلو النص من لحظات تنوير، من إشارات إلى الخير الممكن داخل هذا الظلام الكثيف. ففي بعض المقاطع، يبرز أشخاص نزهاء، أو مواقف تنم عن رحمة، أو لحظات ينهزم فيها الشر أمام صدفة نادرة من العدل. وهذه الإشارات الصغيرة لا تغير من سوداوية المشهد العام، لكنها تمنحه توازناً إنسانياً يجعل التجربة قابلة للفهم. فكأن المؤلف يقول إن الإنسان ليس شراً محضاً ولا خيراً محضاً، بل كائن يتأرجح بينهما، وأن سقوطه أو نجاته لا ينبعان من قهر خارجي فقط، بل من اختياراته الداخلية.
وهذا التوازن بين نقد المجتمع وتفهم أفراده يمنح الكتاب مصداقية خاصة. فالغجدامي لا يشيطن الناس ولا يقدسهم، بل ينظر إليهم نظرة من رأى وعاش، لا نظرة من ينظّر أو يحاكم من علٍ. وهذه النظرة التجريبية تجعل الكتاب وثيقة عن الوعي الأخلاقي للمجتمع المغربي في فترة تتسم بالتحول، فترة كان فيها الإنسان مأزوماً بين قوى أكبر منه: السلطةوالحاجة والزمن وقلقه الداخلي الذي لا يهدأ.
إن ما يتكشف لنا من خلال قراءتنا للكتاب أن الغجدامي لم يكن مهتماً بتسجيل أحداث بقدر اهتمامه بتسجيل أثرها. فهو يمنحنا مقياساً لمعرفة كيف استقبل الناس الظلم، وكيف فهموا العدالة، وكيف فسّروا المصائب، وكيف عاشوا هشاشتهم. وهذه الأسئلة أكثر أهمية من معرفة أسماء الحكام أو تواريخ المعارك، لأنها تكشف لنا كيف كان الإنسان المغربي يفكر في ذاته وفي العالم. ومن هنا تتجلى قيمة التسلي عن الآفات: أنه يعيد ترتيب الأولويات في كتابة التاريخ، فيجعل التجربة الإنسانية مركز الحدث، بدل أن يكون الحدث مركز التجربة.
يقدّم أحمد التوفيق، في تحقيقه لكتاب التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات، نموذجاً خاصاً في التعامل مع النصوص المغربية الهامشية؛ نموذجاً لا يكتفي بإخراج النص من عزلته المادية، بل يعمل على إعادة إدخاله في الحياة الفكرية بوصفه وثيقة لها روحها وسياقها ووظيفتها. ومن يقرأ مقدمته يدرك منذ الصفحات الأولى أنّ التوفيق لا يتعامل مع هذا الكتاب بوصفه أثراً قابلاً للتهذيب والترتيب فحسب، بل بوصفه “صوتاً” ينبغي الإنصات إليه قبل تقويمه، وإعادة إحياء بنيته قبل الحكم على قيمته.
ومن أبرز ملامح منهجه في التحقيق أنّه يبدأ من سؤالٍ بسيط في ظاهره، عميقٍ في دلالته: ما طبيعة هذا النص؟
فالتوفيق لا ينطلق من افتراضات جاهزة حول جنس الكتاب أو وظيفته، بل يحاول أولاً تحديد موقعه ضمن خارطة الكتابات المغربية: هل هو كتاب حِكمٍ أخلاقية؟ أم سجّل لتجارب فردية؟ أم وثيقة اجتماعية؟ أم مزيج من هذه العناصر؟ وهذا التحديد ليس إجراءً مقدّماً، بل شرطٌ لفهم آلية النص الداخلية، لأن التعامل معه ككتاب تاريخ سيقود إلى أخطاء، والتعامل معه ككتاب وعظ سيبتر قيمته الوثائقية، والتعامل معه كحكايات مجردة سيُغفل بعده النفسي والاجتماعي. وهكذا، يبدأ التوفيق اشتغاله بتحرير “هوية النص”، ليس بفرضها عليه، بل بإعطاء مساحة لكلام المؤلف كي يكشف خصائصه.
ويظهر هذا الحسّ بالهوية في الطريقة التي يقرأ بها التوفيق أسلوب الغجدامي. فهو يتعامل معه كما لو أنه “لغة” خاصة؛ لغة تجمع بين الفصيح الشعبي، وبين التعليق الأخلاقي، وبين الاستطراد السردي. ولذلك تراه حذِراً في التدخل على مستوى البنية اللغوية، مكتفياً بما تقتضيه الضرورة من ضبط أو شرح، دون أن يسعى إلى “تهذيب النص” أو تشذيبه. هذا الموقف يشي بنوع من الوفاء العلمي: إذ يعتبر المحقق أن تكسير خشونة العبارة هو تكسير للحقبة نفسها، وأن تليين الأصوات القديمة هو محوٌ لما تمنحه من صدق ووظيفة.
وإلى جانب هذا الحسّ النصي، يتميّز منهج التوفيق بوعي تاريخي رفيع. فهو يدرك أنّ النصوص الهامشية، بخلاف النصوص الفقهية أو السياسية، لا تُقرأ فقط بما هي مواد لغوية، بل بما هي نتاج سياقات اجتماعية. ومن هنا، فإن التوفيق لا يضع الهوامش ليشرح الكلمات أو يقدّم الترجمات الجغرافية فقط، بل لربط القصص بفضاء اجتماعي أوسع: يوضح طبيعة القضاء ومكانة الشيخ ودور القبيلة، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم. إنّ الهوامش هنا ليست تنميقات مدرسية، بل أدوات تحليل تمنح القارئ مقدرةً على فهم ما تتضمّنه الحكاية من بنيات سلطوية وأخلاقية.
ويلمس القارئ أن التوفيق لا يتعامل مع النص من موقع “السيطرة” بل من موقع “الحوار”. فهو لا يفرض قراءته على الغجدامي، بل يحاول الإصغاء إليه، والتقاط نظرته للزمن، وإعادة تقديمها دون أن تتحول إلى خطاب معاصر. وهذا الحوار يجعل المحقق شريكاً في كشف المعنى، لا وصياً على المعنى. وفي هذا الإطار، يظهر منهج التوفيق بوصفه منهجاً يتسم بنوع من “التواضع العلمي”، حيث لا يسمح للمفاهيم الحديثة أن تطغى على النص القديم، ولا يسمح في المقابل للنص أن ينغلق على ذاته. إنه يعيد خلق توازن بين زمنين، دون أن يذيب أحدهما في الآخر.
ويكشف تحقيق التوفيق للنص عن فهمه العميق للعلاقة بين الذاكرة والوثيقة. فالنص الذي بين يديه ليس وثيقة رسمية مثل سجلات العدول أو كتابات الرحلات الرسمية، بل هو ذاكرة فرد عاش تجربة خاصة. ولذلك فإن التوفيق يتعامل معه بوصفه وثيقة من نوع آخر: وثيقة للوعي الاجتماعي، وللتمثّلات وللمشاعر وللخوف الجماعي من الآفات. ومن هنا كان حرصه على التوقف عند بعض الجمل التي تكشف من خلال اختيار الألفاظ، عن توتر نفسي أو رؤية أخلاقية. إنّ مهمته لا تقتصر على التحقيق، بل تشمل أيضاً لفت النظر إلى “الأصوات الخفية” التي تتكثف خلف السرد.
وما يميز منهج التوفيق كذلك هو أنه يتعامل مع النص التراثي لا باعتباره “ماضياً منغلقاً”، بل باعتباره مادة معرفية حيّة قابلة لإعادة التوظيف. فالمحقق في عمله، يتجنب أن يحبس النص في زمانه، بل يقدّمه على هيئة وثيقة قادرة على الحوار مع أسئلة الزمن الحاضر. ولذلك نراه يبرز في مقدمته جوانب من الكتاب يمكن أن تهمّ الباحثين في التاريخ الاجتماعي أو في الأنثروبولوجيا، أو في الدراسات الأدبية، دون أن يحوّل الكتاب إلى مصدر لمقولات جاهزة. إنه يوسع إمكانات النص، بدل أن يضيّقها.
كما يتسم منهجه بالحضور الدقيق لروح “النقد الداخلي”. فهو يلاحظ أن المؤلف في بعض المواضع، يقدّم روايات متعارضة، أو يكرر القصص بصيغ مختلفة، أو يورد أحداثاً دون ضبط الزمن. والتوفيق لا يخفي هذه المواطن، بل يشير إليها، ويقدّم احتمالات لسبب حدوثها، دون أن يَجزم بما لا دليل عليه. وهذا الأسلوب يمنح التحقيق نزاهته، لأنه لا يجمّل النص ولا يخفي هشاشاته، بل يعرضه كما هو، مع توجيه القارئ إلى مواضع القوة ومواضع الخلل في بنية الرواية.
إن منهجية تحقيق التوفيق للكتاب بيّنت أنه لم يكن مجرد محقق تقنيّ، بل قارئا بعمق المؤرخ، ومصغياً بحسّ الروائي، ومقترباً من النص بقناعة أن الوثائق الهامشية قادرة على كشف ما لا تكشفه المدونات الكبرى. وهذه المقاربة هي ما يمنح تحقيقه لهذا الكتاب مكانته الخاصة داخل التراث المغربي، مكانة لا تتمثل في جودة الإخراج فحسب، بل في نوعية الأسئلة التي أثارها حول النص، وفي الطريقة التي منح بها صوت الغجدامي القدرة على العبور إلى زمن آخر دون أن يفقد نبرته الأصلية.
إذا كان تحقيق أحمد التوفيق لكتاب التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات قد كشف عن قدرة المحقق على إعادة إحياء نصّ هامشيّ وإدخاله إلى دائرة التداول العلمي، فإن القيمة النقدية الحقيقية لهذا العمل لا تتجلى في مجرد إخراج النص، بل في الأسئلة التي يطرحها هذا الإخراج على مستوى المنهج والوظيفة والحدود. فالتحقيق ليس عملية تقنية محضة، بل ممارسة معرفية تشترك فيها القراءة والتأويل والتاريخ واللغة. ومن ثمّ يتأتى لنا طرح سؤال مركزي: ما الذي أضافه تحقيق التوفيق إلى النص؟ وما الذي تركه معلّقاً؟ وما الذي يستثيره من إشكالات تتجاوز النص إلى طبيعة التحقيق في الثقافة المغربية؟
من أوّل ما يلفت النظر في عمل التوفيق أنّه قدّم نصّ الغجدامي في جوّ من الاحترام العلمي الذي يمنح للمؤلف مكانته دون مبالغة أو استصغار. فهو لا يرفع الغجدامي إلى مقام المؤرخين الكبار، ولا يتركه في هامش الهامش، بل يمنحه موقعاً وسطاً: موقع شاهد على زمن، لا موقع صانع زمن. وهذا التوازن مهم من الناحية المنهجية، لأنه يحمي النص من التأويل المفرط ومن التهوين في الوقت نفسه. غير أنّ هذا التوازن على ضرورته، قد يخفي توجّهاً تأويلياً يجعل القارئ يرى النص بعين التوفيق أكثر مما يراه بعين صاحبه. فالمحقق رغم حذره، يميل إلى قراءة الغجدامي ككاتب يمتلك “رؤية” موحَّدة، بينما قد يكون الكتاب في حقيقته تجميعاً لطبقات نفسية متقلبة، لا لنظام فكري واضح.
ويبرز السؤال أكثر حين نلاحظ أن التوفيق يعيد ترتيب العلاقة بين النص والسياق. فهو يقدّم مقدمة غنية تربط النص بالفضاء الاجتماعي والثقافي للمغرب، لكنه يتعامل مع السياق بوصفه إطاراً يفسر النص، لا بوصفه مادة مستقلة تحتاج إلى تفكيك. هذه المقاربة مفهومة من منظور المؤرخ، لكنها قد تقلل من أهمية التفصيل الاجتماعي الذي يقدّمه النص نفسه. فالقراءة النقدية قد تحتاج إلى عكس المعادلة: أن ننظر إلى السياق من داخل النص، لا إلى النص من داخل السياق. وهذا الجانب مفتوح للنقاش، لأنه يثير سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين المحقق والنص: هل هو موجِّه له، أم قارئ له، أم حاوٍ له داخل إطار أكبر؟
ومن الجوانب التي تستحق التوقف عندها، أن التوفيق رغم حياده النسبي، يمارس نوعاً من “التأديب” للنص، أي أنه يعيد تقديمه بطريقة تجعله قابلاً للاستهلاك الأكاديمي. فهو لا يغيّر النص، لكنه يختار أن يبرزه من زاوية معيّنة: زاوية البعد الأخلاقي والاجتماعي. هذا الاختيار مشروع ومبرر، لكنّه ليس الاختيار الوحيد الممكن. فالنص يمكن أن يُقرأ أيضاً من زاوية الأنثروبولوجيا الرمزية، أو من زاوية الأدب الشعبي، أو من زاوية التاريخ النفسي. والتحقيق كما نراه عند التوفيق، ينزع نحو أن يكون قراءة موجِّهة دون أن يتعمّد ذلك. وهذا ما يجعل النص في صورته النهائية يتخذ شكلاً محدداً، قد لا يكون الشكل الذي سيظهر لو اشتغل عليه باحث آخر.
وما يثير الانتباه في عمل التوفيق أيضاً هو العلاقة بين “الشرح” و”الصمت”. فالمحقق يشرح الكثير من الألفاظ والعبارات، لكنه يصمت عن بعض المواطن التي تحمل دلالات عميقة. وهذا الصمت قد يكون مقصوداً، لأنه يترك للقارئ مساحة حرّة للفهم. لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تقدير معيّن بأن بعض الإشارات لا تحتاج إلى توضيح. غير أنّ النص بطبيعته، يحتمل تفسيرات أكثر تشعباً مما تسمح به الهوامش المختصرة. ففي بعض القصص، تتجلى ديناميات السلطة المحلية، أو تداعيات الانكسارات السياسية، أو تغير العلاقات الاجتماعية، وكان يمكن للتوفيق أن يستثمر هذه اللحظات ليكشف طبقات أعمق من الوعي الاجتماعي. غير أنه اختار أن يظل ضمن حدود المحقق التقليدي، لا ضمن المؤوِّل الموسّع.
ويتّضح هذا أكثر حين نلاحظ أن التوفيق، على خلاف بعض المحققين المعاصرين، لا يمنح تحليلاً موسعاً لظاهرة الآفات نفسها. فهو يكتفي بالإشارة إلى طبيعة النص دون محاولة ربط موضوع الآفات بتطور الفكر الأخلاقي المغربي، أو بموقع الأدب الوعظي في القرون الماضية، أو بتقاطع هذا النص مع نصوص مشابهة. وهذه المساحة غير المستثمرة تفتح الباب أمام قراءة جديدة للنص عبر مقارنته بأعمال مثل الإلمام ببعض نصوص الوعظ الصوفي، أو حتى السرد الشعبي. غير أن التوفيق ترك هذه المهمة للقارئ والباحث، ملتزماً بحدٍّ معين من الحياد المنهجي.
ومع ذلك، فإنّ القيمة الكبرى لتحقيق التوفيق لا تظهر فقط في ما قدّمه، بل في ما منعه عن النص. فقد منع عنه الانزلاق إلى التبرير، ومنع عنه التزيين، ومنع عنه التطويع لذوق معاصر لا يحتمل خشونة اللغة القديمة. وبذلك حافظ على “حقيقة الصوت” كما خرج من صاحبه، وهو أمر جوهري في تحرير النصوص الهامشية. فالخطر الأكبر في التحقيق ليس دائماً الخطأ، بل “التحسين” الذي يجعل النص يبدو أفضل مما هو، لكنه يفقد روحه الأصلية. وقد تجنب التوفيق هذا الخطر بوعي ملحوظ، محافظاً على خشونة السرد وعلى تقطّعه، كأنما يقول للقارئ: هذه هي الحياة كما عبّر عنها صاحبها، لا كما نريد نحن أن نقرأها.
ومن المهم الإشارة إلى أن التوفيق أوجد دون تصريح، علاقة جديدة بين النص والقارئ. فهو يهيّئ القارئ للدخول في عالم الغجدامي، لكنه لا يتدخل في تشكيل تأويله النهائي. وهذا الدور الوسيط يمنح التحقيق وظيفة تربوية رفيعة: أن يعيد وصل القارئ المعاصر بتراثه دون أن يفرض عليه مقاربة جاهزة. ومع ذلك يظل هذا الدور بحاجة إلى تمحيص، لأن الوساطة نفسها شكل من أشكال التأثير، وقد تدفع القارئ إلى رؤية النص في إطار أخلاقي محدد. ومع أن هذا الإطار يستند إلى النص نفسه، إلا أن توسيعه أو تضييقه جزءٌ من وظيفة المحقق.
والسؤال الذي يُطرح هنا: هل ترك التوفيق مساحة كافية للنقد اللاحق؟
الجواب نعم، بل إن تحقيقه أسّس مادة خاماً خصبة للنقاش. فالنص كما قدّمه ليس نصاً مغلقاً، بل نصّاً مفتوحاً على مناهج متعددة. ويمكن إعادة قراءته من زوايا سياسية أو اقتصادية أو نفسية أو لغوية. وقد يكشف المستقبل أن قيمة تحقيق التوفيق لا تكمن في “اكتماله”، بل في “ناقصيته الخلّاقة”، أي في كونه فتح باباً أكثر مما أغلق باباً. وهذه الناقصية ليست عيباً، بل فضيلة، لأنها تنبّه الباحث إلى ضرورة العودة إلى النص، وإلى عدم الاكتفاء بما قُدِّم له.
إنّ أحمد التوفيق أعاد التسلي عن الآفات إلى الحياة، لكنّه لم يقدّم له خاتمة. لقد منحه بداية جديدة فقط. وهذه البداية هي جوهر العمل العلمي الحقيقي: أن يضع النص في سيرورة زمنية جديدة، وأن يتيح للقراء والباحثين أن يعيدوا اكتشافه بطرق قد لا يتوقعها المحقق نفسه. وهكذا، يصبح تحقيق التوفيق ليس نهاية للنص، بل لحظة انبعاث، تلتقي فيها أصوات ثلاثة: صوت المؤلف الذي عاش زمنه، وصوت المحقق الذي قرأ زمن المؤلف، وصوت القارئ الذي يقرأ الزمنين معاً.
تتكشف من خلال هذه القراءة صورةٌ مركبة لكتاب التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات، وصورة أخرى لمنهج أحمد التوفيق في تحقيقه، وصورة ثالثة لطبيعة الكتابة التاريخية الهامشية في المغرب وكيف يمكن استعادتها داخل مشروع معرفي معاصر. وعند جمع هذه الصور تتضح حقيقة أن هذا العمل ليس مجرد لقاء بين مؤلِّف من الماضي ومحقّق من الحاضر، بل هو لقاء بين ثلاثة أزمنة: زمن الغجدامي الذي عاش اضطراب عصره، وزمن التوفيق الذي أعاد قراءة تلك الاضطرابات، وزمن القارئ الذي يحاول –في عالمه الراهن– أن يفهم كيف تتكرر الآفات بأشكال مختلفة، وكيف تتشابه النفوس البشرية رغم اختلاف السياقات.
إنّ القيمة الأساسية لكتاب الغجدامي لا تكمن في ما يسرده من وقائع، فهذه الوقائع في ذاتها ليست ذات أهمية كبرى خارج إطارها المحدود، وإنما تكمن في ما تحمله من قدرة على كشف أنماط التفكير الشعبي، وعلى تسليط الضوء على طبقات غير مرئية من الوعي الجماعي. فالكتاب يمنحنا منظاراً ينظر إلى أسفل، إلى ما هو يومي وعابر ومتكرر، إلى المواقف التي تُكوِّن حياة الناس لكنها لا تجد مكاناً في كتب التاريخ الرسمية. ومن هنا جاءت أهميته بوصفه وثيقة للوجدان، لا وثيقة للأحداث، وبوصفه درساً في كيفية اختزان المجتمعات للآلام، لا مجرد حكاية عن الآفات.
وإذا كان الغجدامي قد قدّم النص من موقع التجربة والمكابدة، فإن التوفيق أعاده من موقع الفهم والمساءلة. ومع أن تحقيق النص يبدو للوهلة الأولى عملية تقنية، إلا أنه ينطوي في حقيقة الأمر على رهانات معرفية كبرى؛ فهو يحدد شكل حضور النص اليوم، ويعيد رسم حدوده، ويمنح القارئ مفاتيح معينة للقراءة. وقد مارس التوفيق هذا الدور بتوازن دقيق بين الوفاء للنص وبين إدخاله ضمن دائرة الفهم المعاصر، فحافظ على خشونته ولغته وارتباك بنيته، لكنه فتح الباب أمام فهم اجتماعي وثقافي أوسع لمضمونه. وهذه القدرة على الجمع بين الانضباط العلمي والحساسية التاريخية هي ما جعلت التحقيق عملاً تأسيسياً أكثر من كونه مجرد خدمة للنص.
غير أن هذا التأسيس لا يخلو من محدوديات، لأن كل تحقيق هو بالضرورة قراءة موجّهة. فالتوفيق رغم نزاهته العلمية، يختار الزاوية التي يبرزها ويترك غيرها، ويحدد مساحات الشرح ومساحات الصمت، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في توجيه النظر إلى الغجدامي بوصفه شاهد عصر أكثر منه حكّاءَ انطباعات. وهذه المحدودية لا تنقص من قيمة التحقيق، بل تؤكد أنّ النصوص الهامشية تحتاج إلى قراءات متعددة، وأن الإفادة الحقيقية منها تتوسّع كلما تعددت المقاربات التي تتناولها.
وهكذا يصبح التسلي عن الآفات نصّاً مفتوحاً، ليس لأنه ناقص في ذاته، بل لأنه ينتمي إلى طبقة النصوص التي لا تُقرأ دفعة واحدة، بل تُستعاد في كل زمن من زوايا جديدة. فقد يقرأه المؤرخ بوصفه أرشيفاً للحسّ الأخلاقي، ويقرأه الأنثروبولوجي بوصفه تمثيلاً لسلطة العرف والمجتمع، ويقرأه الأديب بوصفه سرداً للذات، ويقرأه الفيلسوف بوصفه تأملاً في هشاشة المصير. وهذه التعددية هي بالذات ما يجعل قيمته مستمرة، لأن النص الذي يتحمل التأويل ويبقى قابلاً للقراءة هو نص يملك قوة الحياة.
وتكشف هذه القراءة المتواضعة أن العلاقة بين التاريخ والأدب ليست علاقة فصل، بل علاقة تقاطع، وأن النصوص التي تبدو بسيطة في ظاهرها قد تحمل طبقات عميقة من الدلالة إذا أحسنّا الإنصات إليها. فالتاريخ ليس فقط ما دوّنه المؤرخون الكبار، بل أيضاً ما سجله المهمشون والآحاد، وما تركته النفوس المكلومة في لحظات الضيق. وهذه الطبقة من التاريخ–التي تحضر بقوة في التسلي عن الآفات– تمتلك قدرة على كشف ما لا تكشفه الوثائق الرسمية، لأنها تلامس الحساسية الداخلية للمجتمع، لا صورة المجتمع عن ذاته.
وفي ضوء هذا كله، يمكن القول إنّ قيمة الكتاب وقيمة تحقيقه تتكاملان: فالغجدامي يمنحنا مادّةً خاماً من التجارب الإنسانية، والتوفيق يمنحنا إطاراً علمياً يعيد تنظيم هذه المادة، والباحث المعاصر يمنحها حياة جديدة عبر القراءة النقدية. وهذه السلسلة المعرفية تكشف أنه لا وجود لنصّ نهائي، بل هناك دائماً نصّ يُولد من جديد كلما تغيّر القارئ، وكلما تغيّر السياق، وكلما أعيد طرح السؤال حول معنى الآفات في الزمان والمكان.
وبذلك يمكن اعتبار هذا العمل –بقلم المؤلف والمحقق والقارئ معاً– مساهمة في بناء وعي تاريخي جديد، ووعي أخلاقي متجدد، ووعي إنساني يعترف بأنّ الآفات ليست فقط آثاراً خارجية، بل مرآة لما يضطرب في الداخل. وفي هذا الاعتراف تكمن قيمة الكتاب الكبرى، لأنه لا يمنحنا تاريخاً فحسب، بل يمنحنا إلى جانب ذلك فرصة لفهم الإنسان: خوفه وهواجسهوأحكامه وظلمه، ورغبته الدائمة في النجاة.


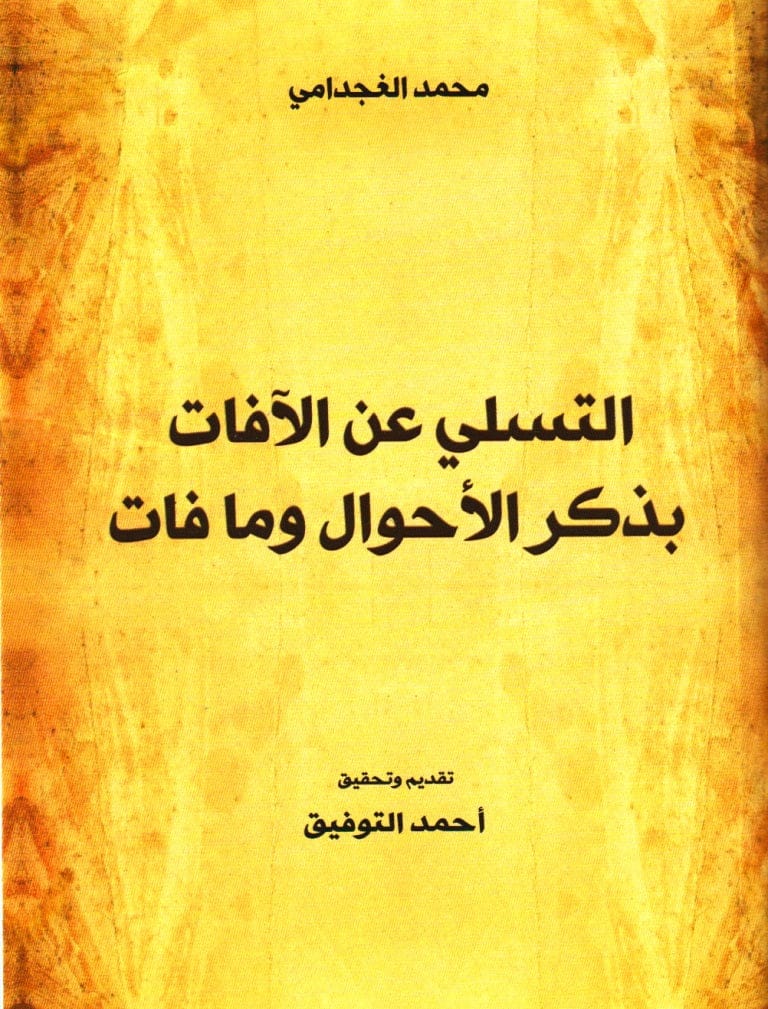 ومن أهم ما يميز الأسلوب أن الكاتب لا يقدّم العبرة كخاتمة مفروضة على السرد، بل يتسلل إليها تدريجياً، كأنها تنبثق من الوقائع ذاتها. فهو لا يقول للقارئ ماذا يفعل، بل يعرض له كيف انتهى الآخرون حين سلكوا طريقاً معيناً. وبهذا الأسلوب، يتجنب الخطاب الوعظي المباشر، ويستعيض عنه بنوع من الحكمة السردية التي تجعل القارئ شريكاً في التفكير، لا متلقياً فقط. وهذه التقنية تجعل الكتاب أكثر قرباً من النصوص التي تنتمي إلى ما يمكن تسميته “التأمل السردي”، حيث تتكثف التجربة الإنسانية وتتحول إلى معنى
ومن أهم ما يميز الأسلوب أن الكاتب لا يقدّم العبرة كخاتمة مفروضة على السرد، بل يتسلل إليها تدريجياً، كأنها تنبثق من الوقائع ذاتها. فهو لا يقول للقارئ ماذا يفعل، بل يعرض له كيف انتهى الآخرون حين سلكوا طريقاً معيناً. وبهذا الأسلوب، يتجنب الخطاب الوعظي المباشر، ويستعيض عنه بنوع من الحكمة السردية التي تجعل القارئ شريكاً في التفكير، لا متلقياً فقط. وهذه التقنية تجعل الكتاب أكثر قرباً من النصوص التي تنتمي إلى ما يمكن تسميته “التأمل السردي”، حيث تتكثف التجربة الإنسانية وتتحول إلى معنى