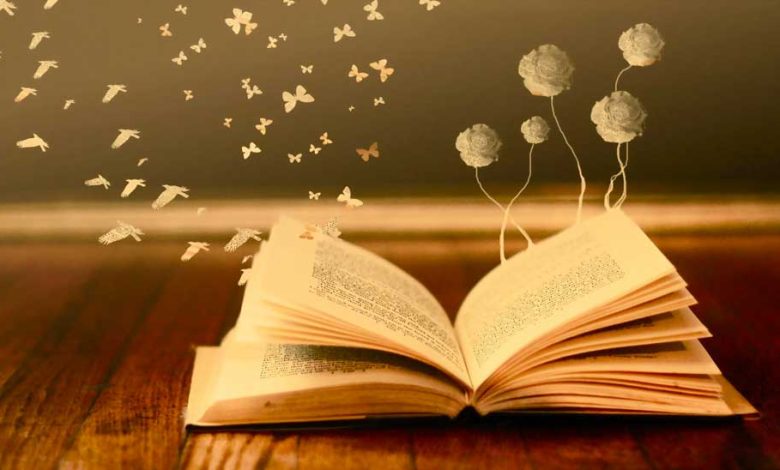

تتشكل روح العصر اليوم على إيقاع السرعة، وتُعاد صياغة أنماط الإدراك الإنساني في ظل تدفّق لا ينقطع للصور والمقاطع والرسائل القصيرة. إننا نعيش زمناً تتقوّض فيه المسافة بين الحدث وتمثّله، بين الخبر وتفسيره، وبين الكلمة ومعناها. لم تعد المعرفة تُبنى عبر التراكم والتأمل، بل عبر الومضات الخاطفة التي تستبدل العمق بالكثافة السطحية، والاستيعاب بالتلقي السريع. ولا تبدو القراءة مجرد نشاط ثقافي بريء، بل تغدو فعلاً ذا طابع وجودي، وممارسة مقاومة تُدافع عن الإنسان ضد اختزاله في كائنٍ مستهلكٍ للصور ومُعيد إنتاجٍ للانفعالات الجاهزة. فالقراءة حين تستعيد معناها الأصيل، تصير تمريناً على البطء وعلى الإصغاء وعلى إعادة بناء العالم بالكلمات لا بالانطباعات.
لقد كان الأدب عبر العصور مأوى للذات في وجه العواصف الاجتماعية والسياسية والفكرية. غير أن التحدي الذي يواجهه اليوم ليس قمع السلطة ولا رقابة المؤسسة فحسب، بل غواية التفاهة وسطوة الخوارزمية وإغراء الاختصار الذي يلتهم المعنى. إن ما يمكن تسميته بـ”التسطح الرقمي” ليس مجرد ظاهرة تقنية، بل هو بنية ذهنية تتغذى من ثقافة التمرير السريع، وتُنتج وعياً متشظياً وعلاقات هشة ولغة متآكلة. هنا تتقدّم القراءة بوصفها فعلاً مضاداً، إذ تُعيد الاعتبار للعمق وللجملة الطويلة وللصبر التأويلي وللذات القارئة التي لا تُختزل في معطى بياني أو في “تفاعل” عابر.
حين أعلن مارشال ماكلوهان أن “الوسيط هو الرسالة”، كان ينبه إلى أن الأداة التقنية لا تنقل المعنى فحسب، بل تعيد تشكيل الحواس والإدراك. وإذا كان الوسيط الرقمي اليوم يفرض منطق السرعة والتجزئة، فإن القراءة الأدبية تُعيد تشكيل الحواس وفق منطق مختلف، قوامه التدرّج والتركيب والاستبطان. إن قارئ الرواية أو القصيدة لا يمرّ على الكلمات مروراً استهلاكياً، بل يسكنها وتسكنه؛ يتعثر بها أحياناً ويعيد قراءتها ويتوقف عند مجازٍ أو استعارةٍ ليُعيد ترتيب عالمه الداخلي. وهنا تكمن مقاومة القراءة: إنها تعاند الزمن السريع، وتُقيم في منطقة التأمل.
لقد تنبّه فالتر بنيامين مبكراً إلى أن إعادة إنتاج العمل الفني في عصر التقنية تُغيّر “هالته”، أي ذلك البُعد الفريد الذي يربط العمل بزمنه ومكانه وتجربته الخاصة. وإذا كان بنيامين يتحدث عن الصورة الفوتوغرافية والسينمائية، فإننا اليوم بإزاء إعادة إنتاج لا نهائية للنصوص والمقاطع والاقتباسات، تُنتزع من سياقاتها وتُستهلك كسلع رمزية. في هذا المناخ، يُصبح الأدب مُعرّضاً للتفكيك إلى جملٍ معزولة تُستخدم كشعارات، ويُختزل الكاتب في “مقولة ملهمة” قابلة للمشاركة. غير أن القراءة المتأنية تُعيد للنص هالته، إذ تُرجعه إلى كليّته، وتُعيد وصل أجزائه، وتُدرك أن المعنى لا يُستخرج من اقتطاع، بل من شبكة العلاقات الداخلية التي ينسجها النص.
لقد قال فرانز كافكا في عبارته الشهيرة: “يجب أن يكون الكتاب فأساً للبحر المتجمد في داخلنا”. إن هذه الصورة الكثيفة تكشف عن وظيفة الأدب بوصفه صدمة داخلية تُحرّر الذات من جمودها. غير أن البحر المتجمد اليوم ليس فقط صقيع الروتين أو اغتراب الحداثة الصناعية، بل هو أيضاً تراكم الصور السريعة التي تُخدّر الحساسية وتُنتج بلادة وجدانية. القراءة هنا تُعيد للذات قابليتها للانفعال العميق، وتُوقظ فيها القدرة على الدهشة والحزن والفرح المركّب، لا ذلك الانفعال اللحظي الذي يزول بمجرد تمرير الإصبع على الشاشة.
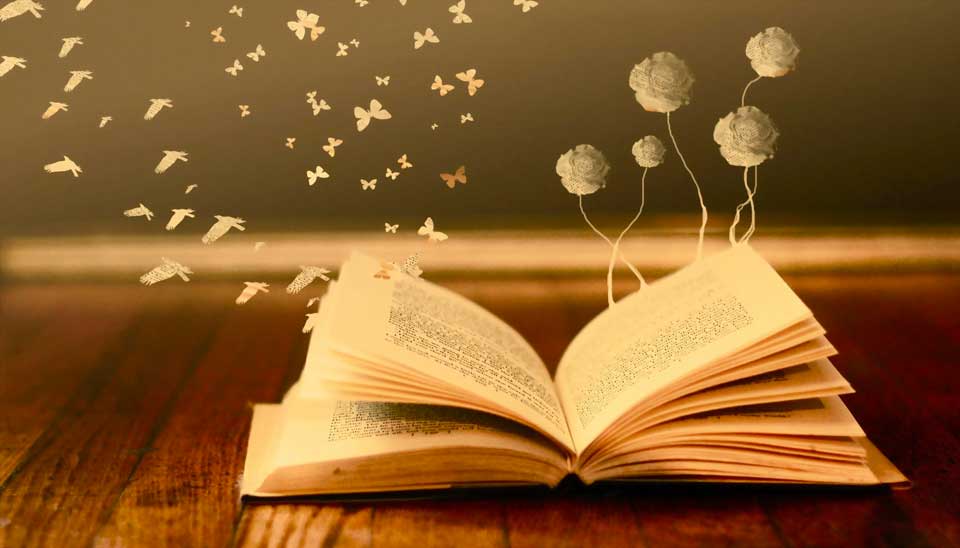 في زمن المنصات تُقاس القيمة بعدد المشاهدات، ويُختزل الرأي في تعليق ويُختصر النقاش في جدلٍ خاطف. إن اللغة ذاتها تتعرّض لعملية تبسيط قسري، حيث تُستبدل الجملة المركّبة بالعبارة المقتضبة، ويُفضّل الإيجاز الذي يُلغي الظلال الدلالية. لقد كان جورج أورويل يُحذّر من تدهور اللغة السياسية، معتبراً أن فساد اللغة يُفضي إلى فساد الفكر. وما نشهده اليوم يتجاوز اللغة السياسية إلى اللغة اليومية ذاتها، حيث تُختزل التجارب المعقدة في “إيموجي”، وتُختصر المشاعر في رموز. أمام هذا الاختزال تُمارس القراءة وظيفة تطهيرية: إنها تُعيد للغة اتساعها، وتُدرّب الذهن على متابعة الحجة، وتحمّل الغموض، ومواجهة التناقض.
في زمن المنصات تُقاس القيمة بعدد المشاهدات، ويُختزل الرأي في تعليق ويُختصر النقاش في جدلٍ خاطف. إن اللغة ذاتها تتعرّض لعملية تبسيط قسري، حيث تُستبدل الجملة المركّبة بالعبارة المقتضبة، ويُفضّل الإيجاز الذي يُلغي الظلال الدلالية. لقد كان جورج أورويل يُحذّر من تدهور اللغة السياسية، معتبراً أن فساد اللغة يُفضي إلى فساد الفكر. وما نشهده اليوم يتجاوز اللغة السياسية إلى اللغة اليومية ذاتها، حيث تُختزل التجارب المعقدة في “إيموجي”، وتُختصر المشاعر في رموز. أمام هذا الاختزال تُمارس القراءة وظيفة تطهيرية: إنها تُعيد للغة اتساعها، وتُدرّب الذهن على متابعة الحجة، وتحمّل الغموض، ومواجهة التناقض.
إن التسطح الرقمي لا يعني انعدام المعلومة بل وفرتها المفرطة. غير أن الوفرة حين تنفصل عن الترتيب والتأمل، تُفضي إلى التشويش. وقد نبّه ميلان كونديرا إلى أن الرواية هي “استكشاف لما لا يُعرف بعد”، وأنها مجالٌ لطرح الأسئلة التي لا تُختزل في أجوبة جاهزة. إن القراءة الأدبية لا تمنح يقيناً سريعاً، بل تُدخل القارئ في متاهة الأسئلة وتُعلّمه التعايش مع التعقيد. في المقابل، تُغري الثقافة الرقمية باليقين الفوري وبالتحليلات السريعة وبالتصنيفات الحادة التي تقسم العالم إلى ثنائيات مبسطة. وهنا يتجلّى الفرق بين معرفةٍ تُبنى عبر المسار الطويل، ومعرفةٍ تُستهلك كمنتج سريع.
لقد كتبت حنة أرندت عن “تفاهة الشر”، مشيرة إلى أن أخطر ما في الشر ليس دائماً نواياه الشيطانية، بل عاديته وسطحية التفكير التي تسمح له بالانتشار. وإذا أسقطنا هذا التحليل على المجال الثقافي، أمكننا أن نقول إن أخطر ما في التسطح الرقمي ليس في نواياه بل في عاديته اليومية، في تحوّله إلى نمط عيش لا يُسائل ذاته. القراءة هنا تُعيد إلينا القدرة على التفكير النقدي، على التوقف، على مساءلة ما يبدو بديهياً. إنها تخلق مسافة بين الذات والعالم، مسافة التأمل التي بدونها يستحيل الحكم.
يُروى عن خورخي لويس بورخيس قوله: “كنت أتخيّل الفردوس دائماً على هيئة مكتبة”. إن هذه الصورة ليست مجرد استعارة رومانسية، بل تعبير عن وعي بأن الكتب تُشكّل عالماً موازياً، فضاءً يُتيح للإنسان أن يتجاوز حدود زمنه ومكانه. في عالم المنصات، يُحاصر الفرد في “فقاعة” خوارزمية تُعيد إليه ما يُشبهه، وتُكرّس ميوله السابقة. أما القراءة فتنقله إلى عوالم أخرى، وتضعه في مواجهة اختلافات ثقافية وفكرية، وتُربّيه على التعدد. إنها تُحرّره من أسر “التخصيص” الرقمي الذي يُعيد إنتاج ذاته في مرآة ضيقة.
وقد أشار ميشيل فوكو إلى أن المعرفة ليست بريئة، بل تتشابك مع السلطة في شبكات معقدة. وإذا كانت المنصات الرقمية تُنتج أنماطاً جديدة من السلطة عبر التحكم في تدفق المعلومات وترتيبها، فإن القراءة الحرة تُشكّل فضاءً لاستعادة المبادرة المعرفية. حين يختار القارئ كتاباً ويخوض فيه بإرادته، فإنه يُمارس شكلاً من أشكال السيادة على انتباهه. والانتباه في زمن الاقتصاد الرقمي، صار مورداً نادراً ومُستهدفاً. إن الدفاع عن القراءة هو دفاع عن الحق في توجيه الانتباه، في عدم الخضوع الكامل لإيقاع الإشعارات والتنبيهات.
لقد نبّه نيل بوستمان في كتابه “التسلية حتى الموت” إلى أن الثقافة التي تُخضع كل شيء لمنطق الترفيه تُفرغ الخطاب العام من جديته. وإذا كان يتحدث عن التلفزيون، فإن المنصات الرقمية قد عمّقت هذا المنطق، حيث تُقاس القيمة بمدى الجذب والإثارة. القراءة الأدبية بخلاف ذلك، لا تسعى دائماً إلى الإمتاع السريع، بل إلى بناء تجربة داخلية مركّبة، قد تكون مؤلمة أو مربكة. إنها تُعلّم القارئ أن القيمة لا تُختزل في المتعة اللحظية، بل في التحول البطيء الذي يحدثه النص في بنية الوعي.
إن مقاومة التسطح الرقمي لا تعني رفض التقنية في ذاتها، بل رفض اختزال الإنسان في بعد واحد من أبعاده. لقد رأى مارتن هايدغر أن الخطر الأكبر في التقنية ليس في أدواتها، بل في نمط الانكشاف الذي تفرضه، حيث يُختزل الكائن إلى مورد. وإذا أُسقط هذا التحليل على المجال الثقافي، فإن الخطر يكمن في تحويل النصوص إلى محتوى، والقراءة إلى استهلاك، والكاتب إلى صانع “ترند”. القراءة بوصفها فعلاً تأملياً تُعيد للنص كينونته وللقارئ إنسانيته وتُقاوم هذا الاختزال.
لقد قال ألبير كامو إن “الصراع نفسه نحو القمم يكفي لملء قلب الإنسان”. إن القراءة تُشبه هذا الصراع، فهي مسارٌ صعودي نحو فهمٍ أعمق للعالم والذات. في المقابل، يُغري التصفح السريع بنشوة آنية لا تترك أثراً عميقاً. إن الفارق بين الاثنين ليس في كمية المعلومات، بل في نوعية التجربة. القراءة تُحوّل المعلومة إلى معرفة، والمعرفة إلى حكمة محتملة؛ أما التصفح فيُراكم المعطيات دون أن يُعيد ترتيبها في بنية ذات معنى.
إن الأدب حين يُقرأ بوعي يُعيد للإنسان علاقته بالزمن. فالرواية الطويلة تُجبر القارئ على مرافقة الشخصيات عبر تحوّلاتها، وعلى الصبر على تطور الأحداث، وعلى تقبّل البطء. هذا التمرين على الزمن الممتد يُناقض ثقافة “الآن” التي تُهيمن على الفضاء الرقمي. لقد كتب مارسيل بروست عملاً ضخماً حول البحث عن الزمن المفقود، كأنما أراد أن يُقاوم النسيان عبر السرد. القراءة هنا فعل استعادة، فعل إنقاذ للزمن من التبديد.
إن التسطح الرقمي يُهدد كذلك الذاكرة. فحين تُخزن المعارف في السحابة، وتُستدعى بضغطة زر، يضعف الجهد الشخصي للحفظ والاستيعاب. غير أن القراءة العميقة تُرسّخ المعاني في الذاكرة، لأنها تمرّ عبر الجسد والوجدان، لا عبر العين وحدها. إن القارئ يتذكّر المشاهد والشخصيات لأنه عاشها تخيّلياً، لا لأنه مرّ عليها عابراً. وهنا تتجلّى وظيفة الأدب في بناء ذاكرة داخلية تُحصّن الذات ضد النسيان الجماعي الذي تُنتجه سرعة التداول.
ولعل ما يُضفي على القراءة طابع المقاومة هو كونها نشاطاً فردياً في جوهره. إنها لحظة عزلة مختارة، انسحاب مؤقت من الضجيج. في عالمٍ يُطالبنا بالحضور الدائم والتفاعل المستمر حيثتُصبح العزلة شبهة. غير أن هذه العزلة هي شرط التفكير. لقد كان جان بول سارتر يرى أن الإنسان مشروع، وأن عليه أن يختار ذاته. والقراءة أحد أشكال هذا الاختيار، لأنها تُمكّن الفرد من تشكيل وعيه خارج الإملاءات الفورية.
إن الأدب لا يُنقذ الإنسان عبر تقديم أجوبة جاهزة، بل عبر توسيع أفق أسئلته. إنه يُعلّمه التعاطف مع المختلف والعيش في احتمالات متعددة وتقبّل هشاشته. في زمن تُختزل فيه الهويات في شعارات، تُعيد الرواية والقصة والشعر بناء التعقيد الإنساني. إن شخصية روائية واحدة قد تكشف من التناقضات ما لا تكشفه آلاف التعليقات. وهكذا تُصبح القراءة تمريناً أخلاقياً، تُربّي في القارئ حساسية تجاه الألم والظلم والجمال.
ولا تكون القراءة ترفاً ثقافياً، بل ضرورة وجودية. إنها دفاع عن العمق في وجه السطح، وعن المعنى في وجه الضجيج، وعن الإنسان في وجه اختزاله الرقمي. وإذا كان العصر الرقمي قد غيّر شروط التواصل والمعرفة، فإن القراءة تُذكّرنا بأن الإنسان لا يُختزل في سرعة إصبعه، بل في قدرة عقله على التأمل، وفي طاقة قلبه على الفهم. ومن هنا تنبثق الحاجة الملحّة إلى إعادة الاعتبار للأدب، لا كملاذ نوستالجي، بل كقوة حية تُقاوم التسطح، وتُعيد للإنسان ثقله الوجودي. وهذا ما يستدعي مواصلة التأمل في آليات هذه المقاومة، وفي أبعادها المعرفية والأخلاقية والجمالية، بما يكشف أن القراءة ليست مجرد عادة، بل فعل تحرّر متجدد.
غير أن فعل المقاومة الذي تنهض به القراءة لا يقتصر على البعد المعرفي أو اللغوي، بل يمتد إلى تخليق الذات ذاتها، إلى إعادة تشكيل بنيتها الداخلية في مواجهة عالم يتجه باطراد نحو الاختزال والتشييء. إن الإنسان الرقمي مهدد بأن يتحول إلى ملف بيانات، إلى سلسلة من التفضيلات القابلة للقياس والتحليل، إلى أثر إحصائي يُعاد توجيهه بخوارزميات لا يرى عملها. هنا تستعيد القراءة معناها بوصفها فضاءً لحرية داخلية لا تُختزل في قابلية القياس، إذ لا تستطيع أي خوارزمية أن تتنبأ على وجه الدقة بما سيحدث في وعي قارئ وهو يواجه استعارة عميقة أو مفارقة روائية مزلزلة.
لقد كتب أومبرتو إيكو أن النص الأدبي “آلة كسولة” تتطلب قارئاً نشيطاً كي يحقق إمكاناتها. إن هذا التصور يضع القارئ في قلب العملية الإبداعية، لا بوصفه مستهلكاً بل شريكاً في إنتاج المعنى. وفي مقابل ذلك، تعمل المنصات الرقمية على تقليص هامش المبادرة، إذ تقترح وتوجّه وتعيد ترتيب العالم وفق منطق خفي. القراءة، حين تُمارَس بوصفها جهداً تأويلياً، تُعيد للذات قدرتها على الفعل، على ملء الفراغات، على بناء الروابط بين المقاطع وعلى مساءلة النص لا ابتلاعه. إنها تدرّب الذهن على العمل البطيء، على الصبر، على قبول أن المعنى لا يُعطى دفعة واحدة بل يُنتزع انتزاعاً.
وهنا تتجلى القراءة كفعل مقاومة ضد ما يمكن تسميته بـ”اقتصاد الانتباه”. لقد أشار هربرت سيمون إلى أن وفرة المعلومات تعني فقر الانتباه، لأن الانتباه مورد محدود. في عالم يتنافس على هذا المورد، تُصبح القدرة على التركيز فعلاً شبه بطولي. إن قراءة عمل طويل تتطلب انقطاعاً عن الإشعارات، وتحرراً مؤقتاً من سيل التنبيهات. هذا الانقطاع ليس هروباً من الواقع، بل استعادة لحق أساسي: حق الإنسان في أن يختار ما يُنصت إليه، وما يمنحه زمنه. إن القراءة تُعيد للزمن كثافته وتُخرجه من التبديد المتواصل.
لقد نبّه تيودور أدورنو إلى أن صناعة الثقافة تُنتج وعياً نمطياً، يُعيد استهلاك الصيغ ذاتها في قوالب متكررة. وإذا كان حديثه موجهاً إلى السينما والموسيقى الشعبية في سياق معين، فإن ما نشهده اليوم في الفضاء الرقمي هو تعميم لهذا النمط، حيث تتكرر الصيغ البصرية واللغوية في سلسلة لا تنتهي من النسخ. القراءة الأدبية في المقابل، تُواجه القارئ بفرادة كل نص، بخصوصية أسلوبه، بتوتراته الداخلية. إنها ترفض القالب الجاهز، وتُجبر القارئ على إعادة تشكيل أدواته الإدراكية مع كل عمل جديد. وهكذا تُقاوم النمطية، وتُدرّب الذهن على الاختلاف.
إن التسطح الرقمي لا يهدد اللغة وحدها، بل يهدد الخيال ذاته. فالخيال بوصفه قدرة على تصور ما ليس حاضراً، يحتاج إلى فراغ، إلى صمت، إلى مسافة بين الصورة والمتلقي. غير أن الصورة الرقمية حين تتدفق بكثافة، تملأ هذا الفراغ وتترك القليل للذهن كي يُكمله. القراءة بخلاف ذلك، لا تمنح صوراً جاهزة، بل تُثير صوراً داخلية تتشكل في ذهن القارئ. وقد كان غاستون باشلار يرى أن الصورة الشعرية ليست مجرد زخرف بل “حدث في الوعي”، لحظة انفتاح على أفق جديد. إن هذا الحدث لا يتحقق إلا حين يتورط القارئ في بناء الصورة، حين يُسهم بخياله في تشكيلها. وهنا تتجلى القراءة بوصفها تدريباً على الخلق، لا على الاستهلاك.
وفي سياقٍ يتسم بتسارع الأحكام وتكاثر الاستقطابات، تُقدّم القراءة تمريناً على التعقيد الأخلاقي. لقد رأى ليو تولستوي في الرواية وسيلة لاكتشاف أعماق النفس البشرية، بما فيها من تناقضات وضعف وقوة. إن الشخصيات الروائية الكبرى لا تُختزل في خير مطلق أو شر مطلق، بل تتأرجح في منطقة رمادية تُشبه الحياة. هذا الإدراك للتعقيد يُربّي في القارئ حساً نقدياً تجاه الخطابات التي تُبسط الواقع في ثنائيات حادة. القراءة هنا تُصبح تربية أخلاقية، لأنها تُعلّمنا أن نفهم قبل أن نحكم، وأن نصغي قبل أن ندين.
ولا يخفى أن التسطح الرقمي يُنتج نوعاً من “الحضور الدائم” الذي يستنزف الذات. فالفرد مدعو باستمرار إلى إبداء رأيه، إلى التفاعل، إلى إعلان موقف. غير أن هذا الحضور قد يُفضي إلى ضياع الداخل، إلى غياب المساحة التي تتخمر فيها الأفكار. لقد كان سورين كيركغور يُحذّر من “الجمهور” بوصفه كياناً مجرداً يبتلع الفرد، ويُفقده تفرده. القراءة بوصفها نشاطاً فردياً صامتاً تُعيد للفرد تفرده، لأنها تخلق علاقة حميمة بينه وبين النص، علاقة لا تُعرض على الملأ ولا تُقاس بعدد الإعجابات. إنها تُذكّر الإنسان بأن عمقه لا يُستمد من صدى الآخرين، بل من حواره الداخلي.
وإذا كان العصر الرقمي قد عمّق الإحساس بالتشتت، فإن القراءة تُعيد بناء الوحدة الداخلية. إن متابعة حجة فلسفية دقيقة، أو حبكة روائية متشابكة، تتطلب جمع شتات الانتباه في نقطة واحدة. هذا الجمع ليس مجرد مهارة ذهنية، بل هو استعادة لتماسك الذات. لقد كتب بول ريكور عن السرد بوصفه وسيلة لتشكيل الهوية، إذ تُبنى الذات عبر الحكاية التي ترويها عن نفسها. القراءة تُغني هذا البناء، لأنها تُدخل الذات في حكايات أخرى، وتُتيح لها إعادة تأويل تجربتها الخاصة. وهكذا تُصبح القراءة فعلاً أنطولوجياً يُسهم في تكوين الكينونة.
وفي مواجهة ثقافة الصورة التي تميل إلى الفورية، تُعيد القراءة الاعتبار للزمن التأويلي. إن فهم نص معقد لا يتم دفعة واحدة، بل عبر حركة ذهاب وإياب بين الجزء والكل، كما أشار إلى ذلك تقليد التأويل الحديث. هذا التمرين على الدائرة التأويلية يُنمّي في القارئ وعياً بتاريخية الفهم، وبأن المعنى ليس معطى ثابتاً بل نتيجة تفاعل حي. إن التسطح الرقمي بخلاف ذلك يُوهم بإمكانية الفهم الفوري، ويُغري بالأحكام السريعة. القراءة تُقاوم هذا الوهم، لأنها تُذكّرنا بأن الفهم يحتاج إلى وقت، وإلى استعداد للاعتراف بحدودنا. وقد كتبت فرجينيا وولف عن ضرورة “غرفة تخص المرء وحده” كي يكتب.
إن القراءة أيضاً تحتاج إلى غرفة، إلى فضاء يحميها من التشويش. هذه الغرفة ليست جدراناً مادية فحسب، بل هي موقف داخلي، قرار بالانسحاب المؤقت من الضجيج. في هذا الانسحاب لا ينقطع القارئ عن العالم، بل يعيد بناء علاقته به. إنه يعود إلى الواقع محملاً برؤية أعمق، بلغة أغنى، بحساسية أشد تجاه التفاصيل.
إن مقاومة التسطح الرقمي عبر القراءة لا تعني الدفاع عن ماضٍ مثالي لم يكن موجوداً قط، بل تعني البحث عن توازن جديد. فالتقنية كما أشار يورغن هابرماس في سياقات متعددة، يمكن أن تُسهم في توسيع الفضاء العمومي إذا وُضعت في إطار تواصلي عقلاني. غير أن هذا الإطار لا يتحقق إلا بوجود ذوات قادرة على التفكير النقدي، على تمييز الحجة من الشعار، وعلى متابعة النقاش المركّب. القراءة تُسهم في تكوين هذه الذوات، لأنها تُدرّبها على تحليل النصوص، وعلى كشف الافتراضات المضمرة، وعلى اختبار الاتساق الداخلي.
إن الأدب في جوهره ليس مجرد حكاية، بل هو مختبر للتجربة الإنسانية. حين نقرأ رواية عن حرب أو عن حب أو عن اغتراب، فإننا نعيش تجربة لا تخصنا مباشرة، لكننا نخرج منها وقد اتسع أفقنا. وقد رأت مارثا نوسباوم أن الأدب يُنمّي ما سمّته “الخيال الأخلاقي”، أي القدرة على تصور حياة الآخرين من الداخل. في عالم رقمي قد يُغري بالتقوقع في دوائر ضيقة، تُصبح هذه القدرة شرطاً للتعايش. القراءة هنا فعل مقاومة ضد الانغلاق، وضد النزعة إلى اختزال الآخر في صورة نمطية.
وإذا تأملنا أثر القراءة على اللغة أدركنا أنها لا تُنمّي المفردات فحسب، بل تُعمّق الحس بالمعنى. إن اللغة الأدبية تُعرّفنا على طبقات من الدلالة، على مفارقات، على ظلال لا تُدرك في الخطاب المباشر. هذا الثراء يُحصّننا ضد الشعارات الفارغة، لأنه يُعوّدنا على مساءلة الكلمات. لقد كان لودفيغ فيتغنشتاين يُذكّر بأن حدود لغتنا هي حدود عالمنا. القراءة تُوسّع هذه الحدود، فتُوسّع عالمنا. إنها تمنحنا أدوات للتفكير، ومفاتيح لفهم التعقيد.
إن الإنسان الذي يقرأ لا يُصبح معزولاً عن عصره، بل يُصبح أكثر قدرة على فهمه. فالأدب لا يهرب من الواقع، بل يعيد صياغته، يكشف تناقضاته، يفضح أوهامه. وقد كتب غابرييل غارسيا ماركيز عن “الواقعية السحرية” بوصفها طريقة لقول الحقيقة عبر المجاز. هذا النوع من الكتابة يُعلّمنا أن الواقع ليس ما يظهر فقط، بل ما يتوارى خلفه. القراءة تُنمّي هذه الحساسية، فتجعلنا أقل قابلية للانخداع بالمظاهر.
إن القراءة كفعل مقاومة ليست شعاراً بل ممارسة يومية. إنها تبدأ بقرار بسيط: أن نمنح كتاباً وقتاً من يومنا، أن نُصغي إلى صوت مختلف، أن نتحمّل صعوبة الفهم. غير أن هذا القرار البسيط ينطوي على رهانات كبرى، لأنه يُعيد ترتيب علاقتنا بالزمن وباللغة وبالآخرين وبأنفسنا. إن الأدب لا يُنقذ الإنسان بمعجزة خارقة، بل عبر تراكم بطيء لتحولات صغيرة في الوعي. كل رواية تُقرأ بعمق، كل قصيدة تُتأمل، تُضيف طبقة إلى بنية الذات، تُعزّز قدرتها على المقاومة.
إن التسطح الرقمي، بما يحمله من إغراءات، ليس قدراً محتوماً. إنه نمط يمكن مساءلته، ويمكن موازنته بممارسات مضادة. القراءة واحدة من أقوى هذه الممارسات، لأنها تُعيد للإنسان ثقله الداخلي. إنها تُذكّرنا بأننا لسنا مجرد نقاط بيانات، بل ذوات قادرة على التأمل، على الشك وعلى الحلم. في عالم يُغري بالاختزال، تُصرّ القراءة على التعقيد؛ في زمن السرعة، تُصرّ على البطء؛ في ثقافة الضجيج، تُصرّ على الصمت المثمر.
تتجلّى القراءة كفعل مقاومة هادئ لكنه عميق، لا يرفع شعارات صاخبة، بل يُغيّر الإنسان من الداخل. إنها مقاومة تبدأ من الصفحة، لكنها تمتد إلى الحياة بأسرها. فمن تعلّم أن يقرأ بعمق، تعلّم أن يرى بعمق، وأن يُنصت بعمق، وأن يعيش بعمق. وذلك هو الإنقاذ الحقيقي: أن يُستعاد الإنسان إلى ذاته، وأن يُحرَّر من سطوة السطح، وأن يُمنح فرصة أن يكون أكثر من مجرد مستهلك عابر في فضاء رقمي لا يهدأ.




