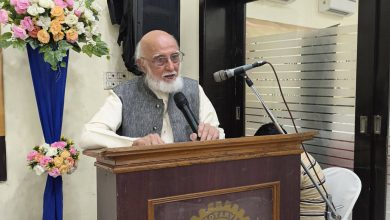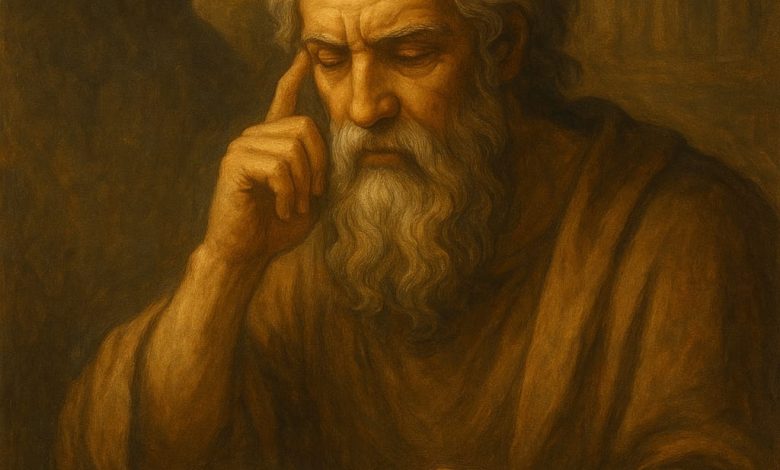
الميثوس واللوغوس في النص
تأملات فلسفية ونقدية في مسارات التخييل وبناء المعنى
د. حمزة مولخنيف، المغرب
منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الإنسان يواجه العالم بالأسئلة بدل الخضوع الأعمى للأسطورة، نشأت علاقة ملتبسة بين الفلسفة والنقد الأدبي، علاقة تتأرجح بين الحاجة إلى التفسير والحاجة إلى التخييل، وبين الرغبة في القبض على الحقيقة والرغبة في الانفلات منها. ولعلّ هذا التوتر العميق هو ما جعل التفكير الفلسفي، منذ بدايته الأولى عند اليونان، يسعى إلى فهم النصوص لا باعتبارها مجرد تعبير لغوي، بل باعتبارها علامات تنبع من عمق الوعي الإنساني، وتشكّل في الوقت نفسه مرآة لطرائق إدراكه للعالم. فالفلسفة في جوهرها محاولة متواصلة لفهم ما يتجاوز الظاهر، والنقد الأدبي في عمقه محاولة لالتقاط أثر هذا الفهم في اللغة، بينما تشكّل الأسطورة المجال الأول الذي التقت فيه محاولات الإنسان للتفسير بمحاولاته للسرد، حتى قبل أن يظهر الفرق بين التفكير المفهومي والكتابة الإبداعية.
ولم يكن عبثا أن يجعل أفلاطون الشعراء في مدينته في موضع المراقبة، بل وفي أحيان كثيرة في موضع الطرد، لأنه كان واعيا بأن الخيال قادر على أن يؤسس رؤى للعالم مزاحمة للرؤية الفلسفية. غير أن أفلاطون نفسه ـ على نحو مفارق ـ لم يستطع الهروب من السرد الخيالي والأسطرة، كما يتضح في «أسطورة الكهف» التي صارت مثالا كلاسيكيا على كيفية توظيف الخيال في خدمة الفلسفة. فهنا يتقدم السرد بوصفه أداة لتفكير فلسفي لا يستطيع أن يحيا بلا صور. وهذا ما لاحظه الفيلسوف بول ريكور حين قال: «إنّ الرمز يعطي للفكر ما يفكّر فيه»، دالا بذلك على أنّ الخيال ليس نقيضا للعقل، بل شرطٌ من شروطه.
وليس النقد الأدبي بمنأى عن هذا التوتر، لأنه حين يحاول تفسير النصوص إنما ينحاز بطريقة أو بأخرى، إلى تصور فلسفي للعالم. فالنقاد الكلاسيكيون على سبيل المثال كانوا يعتقدون بأن الأدب محاكاة للواقع، وهذا اعتقاد يقوم على رؤية فلسفية للأشياء، تماما كما ذهب أرسطو في «فن الشعر» إلى أنّ الشعر «أصدق من التاريخ»، لأنه يعبر عن الممكن لا عن الواقعي فحسب. ومن هنا بدأت علاقة معقدة بين الفلسفة والنقد، أساسها السؤال عن طبيعة المعنى: هل هو شيء ثابت يُستخرج من النص، أم هو شيء ينشأ في القراءة والتأويل؟ وهو السؤال ذاته الذي سيعود بقوة مع الهرمينوطيقا الحديثة، حيث تتحول القراءة إلى عملية كشف متدرّج عن طبقات المعنى، لا عن حقيقة نهائية واحدة.
وإذا كانت الأسطورة في المجتمعات القديمة قد أدت وظيفة تفسيرية للعالم، فإنها في الوقت نفسه شكّلت أول شكل من أشكال الوعي الأدبي. فالأسطورة ليست مجرد حكاية، بل هي ـ كما يقول ميرسيا إلياد ـ «تجربة أولى للوجود». ومن هنا يصبح التخييل أو القدرة على بناء عالم بديل، لحظة تأسيسية للوعي البشري. فحين خلق الإنسان الأسطورة لم يكن يهرب من الواقع، بل كان يحاول أن يمنحه معنى، لأن الواقع بلا معنى هو واقع لا يُطاق. والفلسفة حين ظهرت لم تقطع الصلة بالأسطورة تماما، بل استعارت الكثير من آلياتها، كما نرى في كتابات الفيثاغوريين أو الرواقيين الذين امتزجت أفكارهم الفكرية بتصورات كونية شبه أسطورية. أمّا النقد الأدبي فقد بدأ يدرك أنّ النصوص الكبرى، حتى تلك التي صيغت في شكل عقلاني، تحمل في أعماقها آثار الأسطورة الأولى، بما فيها من رموز وأقنعة وشخصيات وخواطر تتكرر عبر الأزمنة.
إنّ الكتابة الخيالية في تاريخها الأوسع ليست مكملة للأسطورة فقط، بل هي وريثتها المباشر. فالخيال الأدبي يشتغل على المادة نفسها: الزمن والمصير والهوية والخوف والرغبة والموت. وما يميز الأدب أنه يعيد صياغة الأسطورة وفق أسئلة جديدة. فـ«الإلياذة» و«الأوديسة» لهوميروس في جزء كبير منهما إعادة كتابة للتراث الأسطوري اليوناني، لكنها إعادة تضع الإنسان في مركز الحدث، وتمنح البطولة طابعا إنسانيا لا إلهيا، مما جعل بعض الباحثين يعتبرونهما بداية نزعة «إنسية» قبل الفلسفة نفسها. وهذا التصور سيعود لاحقا في أعمال فلاسفة كبار مثل هيغل الذي رأى في الفن مرحلة من مراحل الروح المطلق، وفي النص الأدبي قدرة على تمثيل الروح التاريخية لشعب ما.
وإذا كان الفلاسفة قد تعاملوا مع النصوص الأدبية بوصفها تجليات لصور الفكر في لحظة ما، فإن النقاد الأدبيين بدورهم استعانوا بالرؤية الفلسفية لقراءة النصوص. فنقد القرن العشرين ـ من الشكلانية الروسية إلى البنيوية ثم ما بعد البنيوية ـ لم يكن سوى محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين النص والواقع والقارئ والمعنى. بل إنّ رولان بارت ذهب إلى حد إعلان «موت المؤلف»، وهو إعلان ذو جذور فلسفية، لأنه يعكس انتقالا من رؤية للمعنى بوصفه متجذرا في إرادة الكاتب إلى رؤيته بوصفه عملية لا نهائية من إنتاج الدلالات. وبارت نفسه لم يخفِ اعتماده على نيتشه، الذي رأى أن الحقيقة «جيش من الاستعارات»، أي أنها في جوهرها نتاج تخييل تمامًا كما هو الأدب.
لقد كان للفلاسفة دائما موقف مزدوج من الخيال. فهم من جهة يخشون أن يزيّف الوعي، ومن جهة يدركون أنه ضروري لإنتاج المفهوم. ولعلّ هذا ما جعل كانط يتحدث عن «الخيال المبدع» باعتباره عملية تركيبية تجمع بين الحساسية والفهم، وبذلك يصبح الخيال قوة عقلية لا مجرد قدرة على التصوير. ومن هنا تبرز أهمية التخييل في العمل الأدبي: فهو ليس مجرد زخرفة لغوية، بل بنية معرفية تسمح بفهم ما لا يمكن فهمه بغيرها. ولهذا فإن النقد الأدبي الذي يتجاهل البعد الفلسفي في التخييل يفقد جزءا أساسيا من وظيفته، لأنه يعالج النص بوصفه بنية لغوية فقط، بدل اعتباره فعلا من أفعال الوعي.
إن علاقة الفلسفة بالنقد الأدبي علاقة لا يمكن فهمها إلا بقراءة تطورها التاريخي، لأن كل حقبة أعادت صياغة مفهوم الأدب والفلسفة معا. ففي العصر الوسيط على سبيل المثال، هيمنت القراءة الرمزية للنصوص، حيث كان يُنظر إلى النص الأدبي بوصفه مستودعا للمعاني الروحية. وهذا ما نجده عند القديس أوغسطين في قراءته للكتاب المقدس، أو عند فلاسفة التصوف الإسلامي الذين قرأوا الشعر والنثر بما يتجاوز المعنى الظاهر. أمّا عصر النهضة فقد حاول إعادة الاعتبار للإنسان ولخياله، كما نرى عند ديكارت الذي استخدم الشك لبناء يقين جديد، وعند مونتين الذي جعل الكتابة فعلاً للتفلسف. ومن هنا بدأ الخط الفاصل بين الفيلسوف والكاتب يبهت تدريجيا، إلى أن جاء القرن التاسع عشر ليجعل من الأدب مجالاً أساسيا للتأمل الوجودي كما عند دوستويفسكي، الذي يرى فيه كامو «أول من وضع أسئلة العبث والمصير الإنساني في إطار جمالي».
يصبح من الصعب التمييز بين الفيلسوف والأديب وبين الفلسفة والنقد، لأن كليهما ينطلق من السؤال ذاته: كيف نفهم الإنسان وهو يروي نفسه؟ وكيف نميز بين ما يقوله النص وما يخفيه؟ وكيف نصوغ الحقيقة في شكل قصة أو مفهوم؟ وهي أسئلة ستزداد تعقيدا في العصر الحديث مع صعود نقد اللغة والتحليل البنيوي والاهتمام باللاشعور عند فرويد ويونغ، وما نتج عن ذلك من ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين الأسطورة والخيال والفكر.
حين تطورت الدراسات الإنسانية في القرن العشرين، تبيّن أن الفصل بين الفلسفة والنقد الأدبي ليس إلا فصلا اصطناعيا، لأن النصوص الكبرى ـ سواء كانت فلسفية أو أدبية ـ تنبع من التوتر نفسه بين الرغبة في قول الحقيقة والرغبة في الخلق. وقد كان مارتن هايدغر من أبرز من أعادوا النظر في مركزية الشعر داخل الفكر، حين اعتبر أن اللغة «مسكن الوجود» وأن الشاعر هو من يفتح هذا المسكن في أعمق صوره. إنّ هايدغر من خلال قراءته لهولدرلن، لم يقدّم مجرد تأويل شعري، بل قدّم منهجا جديدا يرى أنّ الكتابة ليست تمثيلا للعالم بل انكشافا له. وهنا يصبح التخييل بعيدا عن كونه تزيينا لغويا، بل فعلا أنطولوجيا يلامس جوهر الوجود نفسه. ولذلك فإن النقد الأدبي المعاصر لم يعد يستطيع التعامل مع النص بوصفه بنية لغوية فحسب، بل بوصفه أثرا لوجود يعبّر عن نفسه من خلال اللغة.
كان للفلاسفة الوجوديين دور حاسم في إعادة الاعتبار للأدب بوصفه شكلا للتفلسف. فسارتر على سبيل المثال، لم يكن يكتب الرواية ليهجر الفلسفة، بل ليمنحها صوتا آخر، صوت التجربة المعيشة التي لا تستطيع اللغة الفلسفية الصارمة أن تحتويها. وفي كتابه «ما الأدب؟» بيّن أن الكاتب مسؤول عن العالم الذي يصنعه، لأنه يقدّم «عالما ممكنا» يدعو القارئ إلى اتخاذ موقف. وهي فكرة تجد صداها في مبادئ الفلسفة الأخلاقية والوجودية، لأن الخيال هنا يتحول إلى مجال للاختيار. أما كامو فكان أوضح، حين اعتبر أن «الخيال هو المكان الوحيد الذي يستطيع فيه الإنسان أن يواجه عبث العالم بأسلوب جميل». وهكذا يتداخل الوجودي بالجمالي، ويصبح الأدب وسيلة للتفكير في المسائل التي تتجاوز القدرة المنطقية للفلسفة.
ولم تكن البنيوية وما بعدها سوى محاولة لإعادة ترتيب هذه العلاقة من جديد. فمع كلود ليفي-شتراوس يعود مفهوم الأسطورة بقوة، لكن ليس باعتبارها رواية شعبية، بل بوصفها بنية ذهنية تُنتج داخل الوعي الإنساني أنماطا ثابتة من التفكير. لقد اهتم ليفي-شتراوس بما سماه «العمليات العقلية البدائية»، التي لا تختلف في جوهرها عن التفكير العلمي أو الفلسفي، لأنها تبحث بدورها عن الترتيب والمعنى. وبذلك تصبح الأسطورة شكلا من أشكال العقل، لا مجرد خيال. أما رولان بارت فقد أخذ هذه الفكرة إلى مستوى آخر حين رأى أن المخيال الجماعي ينتج أساطيره الخاصة في الإعلام والسياسة واللغة اليومية، ومنها ما سماه «الأسطرة المعاصرة». ومن هنا يتبيّن أن الكتابة الخيالية حتى في عصر الحداثة، لا تزال تعمل على المواد نفسها التي بنيت بها الأسطورة القديمة، وإن اختلفت وسائل التعبير وتقنيات السرد.
وفي السياق نفسه، قدّم الفيلسوف بول ريكور مشروعا هائلا في فهم التخييل والأسطورة والرمز، حيث يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم ذاته إلا عبر السرد. إنّ «الهوية السردية» التي تحدّث عنها ريكور تجعل من النص الروائي أداة للفهم، لأن القصّة تمنح الزمن معنى، والزمن هو مادة الوعي والتاريخ. ولعلّ هذا التصور يفسر لماذا يتقاطع التاريخ مع الأدب: فكلاهما يواجهان الزمن، لكن أحدهما يختار التوثيق والآخر يختار التخييل. ومع ذلك فإن المؤرخ كما يقول كروتشه، «لا يروي ما حدث، بل يروي ما يفهمه ممّا حدث». وبذلك يصبح التاريخ نفسه عملية تأويلية أقرب إلى السرد الأدبي مما نتصور، وهو ما جعل هايدن وايت يؤكد أن «الخطاب التاريخي يستعير دائما بنيته من الخطاب الأدبي». ومن هنا يمكن القول إن الفلسفة والتاريخ والنقد الأدبي ينحدرون من المصدر نفسه: الرغبة الإنسانية في إقامة معنى للوجود عبر اللغة.
إنّ التفكير في علاقة الفلسفة بالكتابة الخيالية يجرّ بالضرورة إلى التفكير في مفهوم الحقيقة. ففي الفلسفة الكلاسيكية، كما عند أفلاطون وأرسطو، كانت الحقيقة مفهوما موضوعيا، يمكن التعبير عنه بلغة واضحة وصريحة. لكن مع الحداثة، خصوصا مع نيتشه، تغير الوضع كليا، إذ لم تعد الحقيقة معطى ثابتا، بل أصبحت «شبكة من الاستعارات» كما يقول. وهذا يعني أن الحقيقة في عمقها ليست إلا تخييلا تمّ ترسيخه بالتكرار، وأن الفلسفة نفسها لم تسلم من هذا الطابع الأدبي. ومن خلال هذا المنظور تتحول الأسطورة إلى شكل من أشكال الحقيقة لا لأنها واقعية، ولكن لأنها تحمل بنية معرفية تساعد على فهم الإنسان لنفسه. وهذا تماما ما جعل كارل يونغ يرى في الأساطير «بنى نفسية» موروثة تعكس ما سمّاه «اللاوعي الجمعي»، وهي أفكار أثّرت بعمق في النقد الأدبي، خصوصا في المدرسة الرمزية والتحليل النفسي.
ولعلّ أكثر ما يربك هذه العلاقة بين الفلسفي والخيالي هو أن النص الأدبي قادر على إنتاج معرفة لا تستطيع الفلسفة إنتاجها. فالأدب يستطيع أن يلتقط ما يفلت من المفهوم الفلسفي: الانفعالات والرغبات والتجارب الحية، والتفاصيل الدقيقة للوجود اليومي. وهو ما جعل ليف شستوف يقول: «إن دوستويفسكي فهم الإنسان أكثر مما فهمه الفلاسفة جميعا». ورغم أن الرأي مبالغ فيه، إلا أنه يعبّر عن حقيقة مهمة، وهي أنّ التجربة الإنسانية لا يمكن اختزالها في المفهوم وحده. فالفلسفة لا تستطيع أن تتحدث عن الألم كما تتحدث عنه رواية، ولا عن الحب كما يتحدث عنه شعر، ولا عن الصراع الروحي كما يتحدث عنه نص صوفي. وهكذا كانت علاقة الفلسفة بالأدب علاقة بحث عمّا يعجز أحدهما عن قوله دون الآخر.
لقد حاول بعض المفكرين العرب أيضا التفكير في هذه العلاقة، خصوصا أولئك الذين اهتموا بمسألة الأسطورة والتخييل. فطه حسين في «حديث الأربعاء»، كان يرى أن الأدب العربي القديم لا يمكن فهمه دون فهم المخيال الذي أنتجه، وهو مخيال كان يجمع بين الواقعي والأسطوري والخرافي. أما نصر حامد أبو زيد فقد قدّم قراءة جديدة للنصوص، تؤكد أن المعنى ليس معطى ثابتا، بل يتشكل بالتفاعل بين النص والقارئ، وهو تصور يقترب كثيرا من الهرمينوطيقا الحديثة. وفي السياق نفسه، تحدّث محمد عابد الجابري عن «العقل البياني» و«العقل البرهاني» و«العقل العرفاني»، وهي تصنيفات تساعد على فهم كيف تتداخل الفلسفة والأدب والتصوف في الثقافة العربية. وهذا يبيّن أن العلاقة بين الفلسفة والخيال ليست مسألة غريبة عن الفكر العربي، بل هي جزء من بنائه العميق.
ومع ذلك فإن السؤال يظل قائما: هل يمكن للفلسفة أن تستغني عن الخيال؟ وهل يمكن للنقد الأدبي أن يستغني عن الفكر؟ يبدو الجواب بالنفي في الحالتين. فالفلسفة مهما ادعت الصرامة فهي تحتاج إلى الصور والتشبيهات والأمثلة والقصص لكي تنقل أفكارها، بل إن العديد من الفلاسفة ـ من أفلاطون إلى نيتشه إلى دريدا ـ كانوا كتّابا قبل أن يكونوا فلاسفة. عدا ذلك، فإن النقد الأدبي الذي يكتفي بوصف النصوص دون تأمل يتجه بسرعة إلى السطحية، لأنه يتجاهل الأسئلة الكبرى التي تجعل الأدب قابلا للحياة: سؤال الحقيقة وسؤال الإنسان وسؤال التاريخ وسؤال اللغة. وهكذا فإن التقاء الفلسفة بالنقد الأدبي ليس تقاطعا عرضيا، بل ضرورة معرفية.
على هذا المنوال، يظهر أن الكتابة الخيالية ليست مجرد لعبة تخييل، بل هي فعل معرفي يشتغل على مواد الفلسفة نفسها. والأسطورة رغم أصلها الديني أو الطقوسي، ليست بعيدة عن هذا الفعل. فهي محاولة أولى لتنظيم العالم وتصنيف قواه وتفسير ظواهره، مثلما تفعل الفلسفة لاحقا. والناقد الأدبي الذي يقرأ نصا خياليا يواجه في الحقيقة محاولة بشرية لصياغة المعنى، تماما كما يفعل الفيلسوف. وهنا تذوب الحدود بين الفكر والتخييل واللغة، لأن اللغة نفسها ـ كما يقول هايدغر ـ ليست أداة بل فضاء، وفي هذا الفضاء تتحرك فيه الفلسفة والأسطورة والأدب.
إنّ المسار الطويل الذي قطعته العلاقة بين الفلسفة والنقد الأدبي يكشف أن الحدود التي رسمها الفكر الإنساني بين العقل والخيال لم تكن يوما حدودا نهائية، بل كانت دائما قابلة للتحوّل وفق ما يفرضه التطور التاريخي للمعرفة. فالعقل نفسه لا يتشكل في فراغ، بل ينبثق داخل شبكة من الرموز والصور والاستعارات التي يتوارثها الإنسان منذ الأسطورة الأولى. وإنّ ما يدعو إلى التأمل أنّ الفلسفة وهي تحاول منذ أرسطو أن تصوغ المفهوم في أنقى أشكاله، لم تكن قادرة على التحرر من البنية الأدبية للغة، وهو ما جعل دريدا يؤكد أن «لا شيء خارج النص»، في محاولة منه لكشف الطابع الكتابي للفكر نفسه. فالفلسفة ليست صوتا يحلّ محلّ النص، بل هي نصٌّ يكتب نفسه، ويعيد تشكيل علاقته باللغة كلما تغيّر العالم.
من هنا تأتي الحاجة إلى قراءة العلاقة بين الفلسفة والخيال من منظور موسوعي، لأنّ هذه العلاقة تشتبك مع التاريخ والأنثروبولوجيا والفنون والعلوم الدينية واللغويات وتاريخ الأفكار. فحين نقرأ ملحمة «جلجامش»، على سبيل المثال، لا نقرأ نصا أدبيا قديما فحسب، بل نقرأ في الوقت ذاته أقدم محاولة إنسانية لصياغة معنى الموت والحياة والصداقة والمفارقة الوجودية. وهذه الأسئلة ذاتها هي التي سيعيد الفلاسفة طرحها بصيغ جديدة بعد آلاف السنين. وفي «الإنياذة» لفِرجيل، نرى كيف يصبح الأدب وسيلة لتأسيس هوية سياسية وروحية لروما، وهو ما جعل بعض المؤرخين يعتبرون الملحمة عملا فلسفيا عن المصير الجمعي. أما في النصوص الدينية الكبرى ـ كالملاحم الهندوسية «المهابهاراتا» و«الرامايانا» ـ فالخيال يصل إلى مستوى يمزج فيه بين الأسطورة والحكمة الفلسفية، مما يجعل الحدّ الفاصل بين النص المقدس والنص الأدبي أمرا عسيرا، لأن الاثنين يشتغلان على الهمّ ذاته: تنظيم الوجود عبر الحكاية.
وعندما ننتقل إلى الفلسفة اليونانية، نلاحظ أنّ الأسطورة لم تغادر المشهد قط. فأفلاطون وهو من أراد تحجيم الشعراء، كان الأكثر توظيفا للأسطورة في فلسفته، سواء في «أسطورة إر» أو «العربة المجنّحة» أو «الجزيرة المفقودة». وقد رأى عدد من الباحثين أنّ هذا التناقض ليس اعتباطيا، لأن أفلاطون كان يدرك أن المفهوم وحده عاجز عن حمل أبعاد الوجود كلها، وأنّ الصورة الخيالية قادرة على فتح أفق للمعنى لا تسعف به الصياغة المنطقية وحدها. وهذا ما سيظهر بوضوح لاحقا عند نيتشه الذي جعل الأسطورة نقيضا للميتافيزيقا التقليدية، بل اعتبرها شرطا لإعادة بناء الروح اليونانية، قائلاً: «لقد ماتت التراجيديا يوم ماتت الأسطورة». وفي هذا الحكم ما يكشف أن الإبداع الأدبي بالنسبة إليه ليس زخرفة، بل هو طاقة وجودية تُحيي الشعوب وتمنحها صورتها عن ذاتها.
أما في التراث العربي-الإسلامي، فإنّ العلاقة بين الفلسفة والخيال اتخذت أشكالا متعددة. فالخطاب القرآني نفسه يستثمر الصورة والرمز والمجاز على نحو جعل العلماء يتحدثون عن «المثل القرآني» بوصفه مدخلا لفهم الحقيقة. وقد أدرك الفلاسفة المسلمون، من الكندي إلى ابن رشد وغيره، أنّ الحقيقة لها مستويات، وأنَّ البيان والبرهان والعرفان ليست طرقا متعارضة بقدر ما هي مستويات مختلفة لإدراك الوجود. ولعلّ أبرز مثال في هذا السياق هو نص «حيّ بن يقظان» لابن طفيل، العمل الذي جمع بين الخيال الفلسفي والرمزية الروحية والعلم الطبيعي في توليفة واحدة، وأصبح لاحقا مصدر إلهام للعديد من الأدباء والفلاسفة في أوروبا. فالقصة ليست مجرد حكاية عن طفل ينشأ وحده في جزيرة، بل هي تأمل عميق في كيفية نشأة المعرفة، وكيف ينتقل الإنسان من الحسّ إلى العقل إلى الكشف. وهي بذلك نموذج فريد لكيفية امتزاج الفلسفة بالخيال كامتزاج طبيعي لا يمكن الفكاك منه.
وفي العصور الحديثة، أصبحت الكتابة الخيالية مختبرا للفلسفة السياسية والأخلاقية، كما نرى في أعمال توماس مور («يوتوبيا»)، وفرنسيس بيكون («أطلانتس الجديدة»)، ثم في روايات القرن التاسع عشر التي جعلت من الأدب حقلا للتفكير في المجتمع والعقل والحرية. فقد اعتبر هيغل أن الفن رغم أنّه مرحلة أدنى من الفلسفة في سلم الروح، فهو قادر على التقاط روح العصر بشكل أشد مباشرة من الفكر، لأن الصورة الجمالية تعمل في الوعي قبل أن يعمل المفهوم. ومن هنا جاء اهتمام ماركس نفسه بالأدب، وتفسيره أنّ الرواية الواقعية تحمل في طياتها القدرة على كشف البنى الاجتماعية والاقتصادية. ولعلّ تولستوي وبلزاك وديكنز كانوا بالنسبة للفلاسفة مفكرين اجتماعيين بقدر ما كانوا روائيين.
وفي القرن العشرين، بدأت التحولات العميقة في فهم اللغة والمعنى تُعيد تشكيل علاقة الفلسفة بالأدب. فمع فيتغنشتاين، لم تعد اللغة أداة شفافة، بل أصبحت «عالما» قائما بذاته، يُنتج معناه من خلال «ألعاب لغوية» تتعدد بتعدد السياقات. أما في مدرسة فرانكفورت، فقد رأى أدورنو أن الأدب ـ بخياله وقدرته على إزعاج الواقع ـ يملك سلطة نقدية أكبر من الفلسفة ذاتها، لأن الفن يحتفظ دائما بما يسميه «الطابع اليوتيوبي»، أي القدرة على تخيّل عالم آخر محتمل. وهذا التصور يجعل من الكتابة الخيالية ضرورة سياسية وأخلاقية، لا مجرد متعة جمالية.
وبالتوازي مع ذلك، كانت حركة النقد الأدبي تتطور باتجاه يجعلها أقرب إلى الفلسفة، بل جزءا منها. فالهرمينوطيقا الحديثة، من شلايرماخر إلى ريكور وغادامر، وضعت التأويل في مركز العلوم الإنسانية، وبيّنت أن القراءة ليست اكتشافا لمعنى جاهز، بل بناء مستمر لمعنى جديد. ومن ثمّ فإنّ النقد ليس نشاطا ثانويا، بل هو فعل معرفي أصيل. أما التفكيكية عند دريدا فقد دفعت الأمور إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن النص ليس كيانا له حدود ثابتة، بل شبكة تتناسل فيها الإحالات والدلالات بلا نهاية. وهذا الفهم يجعل الناقد أقرب إلى الفيلسوف الذي يحاول دوما زعزعة اليقينيات، ويفتح المجال لسؤال الحقيقة أكثر مما يغلقه. وهكذا يصبح النص الأدبي، في زمن ما بعد البنيوية ساحة للفلسفة، كما تصبح الفلسفة ساحة للكتابة.
ولعلّ من أهم النقاشات المعاصرة تلك المرتبطة بالدراسات الأسطورية والخيال العلمي والفانتازيا، حيث تتجدد العلاقة بين التفكير العقلي والتخييل. فالرواية الفانتازية اليوم تُقرأ في العديد من الجامعات الغربية كخطاب فلسفي وأنثروبولوجي، لأنها تطرح أسئلة الهوية والسلطة والخوف والغيرية والزمان والمكان. بل إن بعض المنظرين يرون أنّ عالم «السرديات الكبرى» عاد اليوم بشكل جديد عبر الخيال العلمي الذي يعيد صياغة أسئلة الوجود في ضوء التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي روايات مثل «1984» لأورويل أو «عالم جديد شجاع» لهكسلي، نرى كيف يتداخل النقد الاجتماعي والفلسفات السياسية مع الخيال السردي ليكوّنا رؤية شاملة للطبيعة البشرية. وهنا يتضح أن الأدب ما يزال، كما كان منذ الأسطورة الأولى، وسيلة للتفكير في الحدود القصوى لما يمكن أن يحدث، لا لما حدث بالفعل.
إن العلاقة بين الفلسفة والنقد الأدبي وبين الأسطورة والخيال ليست علاقة تجاور، بل هي علاقة انتماء عميق إلى البنية نفسها التي تشكل الوعي البشري. فالمعرفة تبدأ بالسرد قبل أن تتحول إلى مفهوم؛ وأيّ مفهوم مهما بدا صارما، يحمل في داخله أثرا من السرد. ولعلّ هذه الحقيقة هي ما أدركه جورج ستاينر عندما كتب: «حيثما توجد لغـة، توجد استعارة؛ وحيثما توجد استعارة، توجد أسطورة». ومعنى هذا أن الفكر والخيال ليسا نقيضين، بل هما وجهان لعملية إنسانية واحدة تُدعى التأويل. ولأن الإنسان كائن لا يفهم نفسه إلا عبر الحكاية، فإن الفلسفة ذاتها يمكن النظر إليها كتاريخ طويل لإعادة كتابة تلك الحكاية بطرق مختلفة، بينما يقوم الأدب بتجسيدها في صور تظل أحيانا أعمق من كل المفاهيم.
وهكذا ننتهي إلى أن الكتابة الخيالية ليست ضدّ الفلسفة، وأن النقد الأدبي ليس مجرد تعليق على النصوص، بل هو جزء من حركة الوعي الإنساني في بحثه عن معنى يتجاوز اللحظة ويمنح اللغة قدرتها على الكشف. وبين الأسطورة والفلسفة والأدب يمتدّ تاريخ واحد: تاريخ الإنسان وهو يحاول أن يصنع لنفسه عالما يمكن السكن فيه، عالم تمنحه الحكاية شكله، ويمنحه المفهوم معناه، وتمنحه اللغة صوته.

 د. حمزة مولخنيف، المغرب
د. حمزة مولخنيف، المغرب 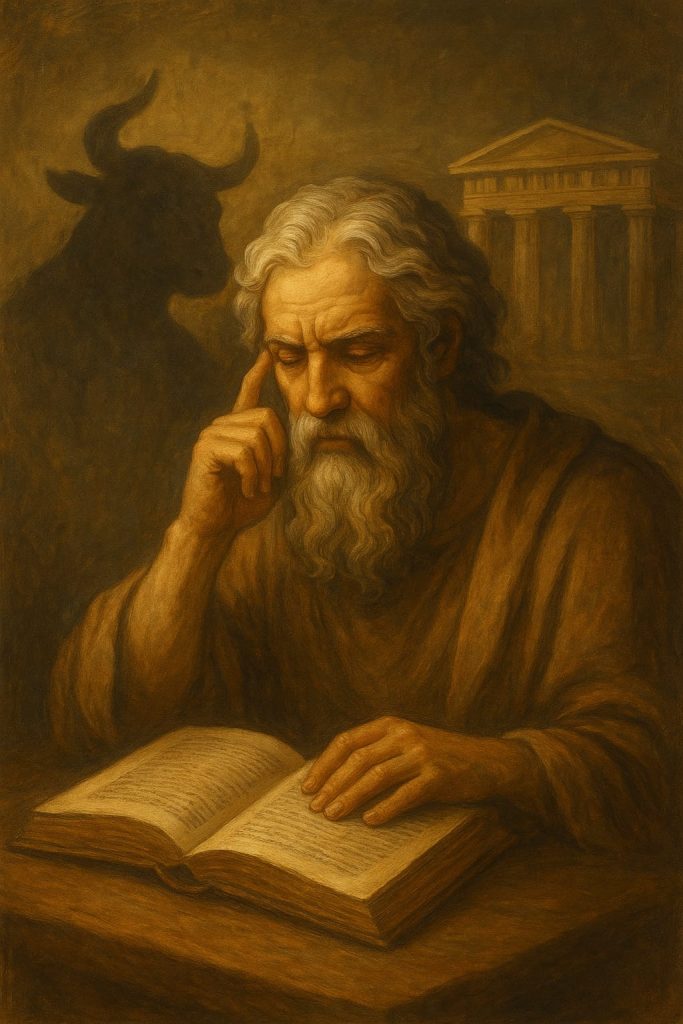 حين تطورت الدراسات الإنسانية في القرن العشرين، تبيّن أن الفصل بين الفلسفة والنقد الأدبي ليس إلا فصلا اصطناعيا، لأن النصوص الكبرى ـ سواء كانت فلسفية أو أدبية ـ تنبع من التوتر نفسه بين الرغبة في قول الحقيقة والرغبة في الخلق. وقد كان مارتن هايدغر من أبرز من أعادوا النظر في مركزية الشعر داخل الفكر، حين اعتبر أن اللغة «مسكن الوجود» وأن الشاعر هو من يفتح هذا المسكن في أعمق صوره. إنّ هايدغر من خلال قراءته لهولدرلن، لم يقدّم مجرد تأويل شعري، بل قدّم منهجا جديدا يرى أنّ الكتابة ليست تمثيلا للعالم بل انكشافا له. وهنا يصبح التخييل بعيدا عن كونه تزيينا لغويا، بل فعلا أنطولوجيا يلامس جوهر الوجود نفسه. ولذلك فإن النقد الأدبي المعاصر لم يعد يستطيع التعامل مع النص بوصفه بنية لغوية فحسب، بل بوصفه أثرا لوجود يعبّر عن نفسه من خلال اللغة.
حين تطورت الدراسات الإنسانية في القرن العشرين، تبيّن أن الفصل بين الفلسفة والنقد الأدبي ليس إلا فصلا اصطناعيا، لأن النصوص الكبرى ـ سواء كانت فلسفية أو أدبية ـ تنبع من التوتر نفسه بين الرغبة في قول الحقيقة والرغبة في الخلق. وقد كان مارتن هايدغر من أبرز من أعادوا النظر في مركزية الشعر داخل الفكر، حين اعتبر أن اللغة «مسكن الوجود» وأن الشاعر هو من يفتح هذا المسكن في أعمق صوره. إنّ هايدغر من خلال قراءته لهولدرلن، لم يقدّم مجرد تأويل شعري، بل قدّم منهجا جديدا يرى أنّ الكتابة ليست تمثيلا للعالم بل انكشافا له. وهنا يصبح التخييل بعيدا عن كونه تزيينا لغويا، بل فعلا أنطولوجيا يلامس جوهر الوجود نفسه. ولذلك فإن النقد الأدبي المعاصر لم يعد يستطيع التعامل مع النص بوصفه بنية لغوية فحسب، بل بوصفه أثرا لوجود يعبّر عن نفسه من خلال اللغة.