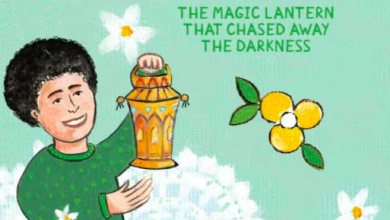في نجاة المعنى من العدم:
الكتابة بوصفها إقامة في الوجود
د. حمزة مولخنيف. المملكة المغربية
ليس من قبيل المجاز البلاغي أن تُوصَف الكتابة بالنجاة، بل إن هذا الوصف يكشف عن بنية أنطولوجية عميقة تربط فعل القول بفعل الوجود ذاته. فالإنسان لا يكتب لأنه يملك فائضاً من الزمن أو ترفاً من اللغة، بل لأنه مهدَّد في جوهره بالاندثار، لأن وجوده معلق دوماً على حافة الصمت، ولأن المعنى فيه هشّ، قابل للتلاشي كما يتلاشى الأثر في الرمل. الكتابة ليست إضافة خارجية إلى الحياة، بل هي نمط من أنماط الدفاع عنها، مقاومة دقيقة للفناء وشكل من أشكال البقاء في وجه ما يسميه بول ريكور «قابلية الوجود للانمحاء داخل الزمن». ليست اللغة هنا وسيلة للتعبير عن شيء سابق عليها، بل هي المكان الذي يحدث فيه هذا الشيء لأول مرة. إن ما لا يُكتب لا يُوجَد تماماً، أو يوجد على نحو ناقص، عرضةً لأن يبتلعه النسيان كما يبتلع البحر الأجساد بلا شواهد.
لقد وعى كبار الكتّاب هذا البعد الإنقاذي للكتابة قبل أن تصوغه الفلسفة في مفاهيمها الصارمة. حين يقول كافكا في يومياته إن «الكتابة هي الصلاة الوحيدة التي أعرفها»، فهو لا يقصد بها فعل تديّن، بل تجربة خلاص، التماساً للمعنى في عالم فقد أي ضمان متعالٍ. وحين تعلن فرجينيا وولف أن «الكتابة فعل مقاومة للزمن»، فهي تشير إلى أن الذات لا تملك سوى اللغة لكي لا تنحلّ في تيار التغيّر، لكي تضع علامة تقول: كنت هنا، فكرت هكذا، تألمت بهذا الشكل. في هذا المعنى تتحول الكتابة إلى ما يشبه الأثر الجنائزي الذي يقاوم المحو، لكنها أثر حيّ نابض قادر على أن يعيد خلق صاحبه في كل قراءة جديدة.
إن العلاقة بين الكتابة والنجاة لا يمكن فهمها إلا إذا استُحضرت هشاشة الكائن الإنساني بوصفه كائناً زمنياً، أي بوصفه موجوداً في التبدد. فالإنسان كما علّمنا هايدغر، هو الكائن الذي يعي موته، أي الذي يعيش دائماً على خلفية فنائه الممكن. هذا الوعي لا يقوده بالضرورة إلى اليأس، بل يدفعه إلى البحث عن أشكال للثبات داخل الجريان، عن صيغٍ لترك أثر في عالم لا يحتفظ بشيء. الكتابة هي إحدى هذه الصيغ، وربما أكثرها كثافة وعمقاً، لأنها لا تترك أثراً مادياً فقط، بل أثراً دلالياً ووجوداً من المعنى داخل الوجود.
ما يجعل الكتابة شكلاً من أشكال النجاة ليس فقط كونها تحفظ التجربة، بل كونها تعيد تشكيلها. فالذات لا تكتشف نفسها إلا وهي تكتب. موريس بلانشو كان يقول إن «الكاتب لا يعرف ما يريد قوله إلا حين يبدأ في قوله»، لأن اللغة لا تنقل معنى جاهزاً، بل تنتجه في لحظة التلفظ أو التسطير. إن السرد ضمن هذا السياق ليس مجرد تمثيل للواقع، بل هو إعادة بنائه بطريقة تجعل العيش فيه ممكناً. لهذا السبب نجد أن كثيراً من الأعمال الكبرى لم تُكتب من موقع الطمأنينة، بل من قلب الجرح. دوستويفسكي كتب لأنه كان محكوماً بالموت المؤجل، بروست كتب لأنه كان مسكوناً بزمن يتفلت منه، سيوران كتب لأنه كان عاجزاً عن الانتحار. في كل هذه الحالات، لا تكون الكتابة ترفاً بل بديلاً عن الانهيار.
النجاة التي توفرها الكتابة ليست نجاة بيولوجية، بل نجاة رمزية، وهي في كثير من الأحيان أكثر عمقاً من الأولى. الجسد قد يعيش، لكن الذات قد تموت إذا فقدت قدرتها على السرد. الإنسان الذي لا يستطيع أن يحكي نفسه، وأن يضع تجربته في شكل لغوي، يظل أسير الصدمة وأسير العشوائية، كما لو أن حياته مجرد سلسلة من الوقائع غير المفهومة. بول ريكور في تحليله للهوية السردية، يبيّن أن الشخص لا يصير ذاته إلا حين يربط أحداث حياته داخل حبكة تمنحها معنى. الهوية بهذا المعنى ليست معطى، بل قصة تُروى باستمرار. وحين تتعطل القدرة على السرد تتفكك الذات، ويتحوّل الوجود إلى مجرد تتابع بلا روح.

يمكن فهم الكتابة بوصفها ممارسة أنطولوجية بامتياز. إنها ليست وصفاً للعالم، بل مشاركة في تأسيسه. كل نص يضيف طبقة من المعنى إلى الواقع يوسّع حدوده، ويفتح فيه ممراً لم يكن موجوداً من قبل. ولهذا قال بورخيس إن «العالم موجود لكي يصبح كتاباً». ليست هذه عبارة شاعرية فحسب، بل إعلان فلسفي بأن الواقع لا يكتمل إلا حين يُقرأ ويُكتب، لأن المعنى لا يقيم في الأشياء بل في العلاقات التي تنسجها اللغة بينها.
الكتابة حين تُفهم بهذا العمق، تكفّ عن أن تكون نشاطاً فردياً معزولاً، لتغدو شكلاً من أشكال الوجود المشترك. الكاتب لا ينجو وحده، بل ينجو مع الآخرين ومن أجلهم. النص يخلق جماعة غير مرئية من القرّاء الذين يتقاسمون تجربة واحدة، ويعبرون الجسر ذاته من الكلمات، ويتعرّفون في مرآتها على هشاشتهم المشتركة. حنة آرنت كانت ترى أن الفعل الإنساني لا يكتسب معنى إلا إذا دخل مجال الظهور، أي إذا صار قابلاً لأن يُحكى. ما لا يُحكى يظل خارج التاريخ، خارج العالم المشترك. والكتابة هي الشكل الأكثر كثافة لهذا الحكي، لأنها تمنحه دواماً نسبياً، وتحرره من محدودية الصوت واللحظة.
لهذا السبب أيضاً، ترتبط الكتابة ارتباطاً وثيقاً بالذاكرة، لا بوصفها خزّاناً للماضي، بل بوصفها طاقة لإعادة بنائه. الذاكرة التي لا تُكتب تظل فوضوية، قابلة للتشويه والنسيان، أما حين تتحول إلى نص، فإنها تخضع لمنطق الشكل، لمنطق الترتيب والتأويل. هذا ما يجعل السيرة الذاتية على سبيل المثال لا الحصر، ليست مجرد استرجاع، بل إعادة خلق للذات عبر اللغة. ميشيل ليريس كان يقول إن كتابة الحياة تشبه تشريحاً للذات، لكنها في الوقت نفسه عملية ترميم، لأن ما يُسمّى في اللغة يكتسب شكلاً يمكن احتماله.
غير أن الكتابة لا تنقذنا من الموت، بل تنقذنا من عبثيته. إنها لا تلغي النهاية، لكنها تمنح ما قبلها معنى. يمكن فهم قول ألبير كامو إن «الخلق هو الجواب الوحيد على العبث». الكتابة هي أحد أشكال هذا الخلق، وربما أكثرها راديكالية، لأنها لا تصنع عالماً مادياً، بل عالماً من الدلالة، وهذا العالم هو ما يجعل العيش في العالم المادي ممكناً. من دون السرد، يتحول الوجود إلى مجرد صمت ممتد، إلى فراغ لا يُحتمل.
إن العلاقة بين الكتابة والنجاة تتجلى بوضوح خاص في سياقات القهر، المنفى، السجن، المرض، حيث تصبح اللغة الملجأ الأخير للذات. حين يُسلب الإنسان كل شيء يبقى له صوته، ويبقى له أن يكتب. لهذا كانت اليوميات في المعتقلات، والرسائل في المنافي، والروايات التي تُكتب على حافة الجنون، كلها أشكالاً من مقاومة الفناء. ليست مقاومة سياسية بالضرورة، بل مقاومة أنطولوجية، دفاع عن الحق في أن يكون المرء ذاتاً لها قصة، لا رقماً في سجل النسيان.
ولا تكون الكتابة مجرد تقنية، بل أخلاقاً وموقفاً من الوجود. أن تكتب يعني أن ترفض أن تُختزل في ما هو عابر، أن تصرّ على أن لحياتك معنى يستحق أن يُصاغ في كلمات. ولهذا قال نيتشه إن «من لديه لماذا يعيش، يمكنه أن يتحمل أي كيف». الكتابة هي إحدى صيغ هذا الـ«لماذا»، إحدى الطرق التي بها يحوّل الإنسان ألمه إلى دلالة، وفوضاه إلى شكل، وزواله إلى أثر.
وهنا تبرز اللغة لا بوصفها أداة محايدة، بل بوصفها فضاء للكينونة. فالذات لا توجد خارج الكلمات التي تقولها عن نفسها والعالم. لا أحد يعيش خارج خطاب ما، حتى الصمت هو شكل من أشكال الخطاب. لكن الكتابة تتيح للذات أن تمتلك خطابها، أن تعيد صياغته بدل أن تظل خاضعة لما يفرضه الآخرون أو المؤسسات أو الأيديولوجيات. أن تكتب يعني أن تستعيد سيادتك على قصتك، أن ترفض أن تُروى حياتك بلغة غيرك.
إن الكتابة ليست فقط نجاة من الموت، بل نجاة من التشييء، من أن تتحول إلى موضوع في خطاب غيرك. إنها استعادة للذات بوصفها ذاتاً ناطقة، قادرة على أن تقول «أنا» داخل نص، داخل عالم من العلامات يعترف بها. وهذا ما يجعل كل كتابة في جوهرها فعلاً من أفعال الحرية، حتى حين تُكتب داخل أقسى الشروط.
إن السرد حين يتحول إلى فعل وجودي، لا يعود مجرد ترتيب للأحداث، بل يصبح طريقة في السكن داخل العالم. كما يسكن المرء بيتاً، يسكن الكاتب نصه، ويقيم فيه ضد العدم. هذا السكن ليس هروباً من الواقع، بل شكل من أشكال الإقامة فيه على نحو أكثر كثافة. فالواقع الذي لا يُروى يظل سطحياً، بينما الواقع الذي يدخل اللغة يكتسب عمقاً ويصير قابلاً للتأمل وللنقد وللتحويل.
ولعل هذا ما قصده رولان بارت حين قال إن «اللغة ليست أداة تواصل، بل مصير». أن نكون بشراً يعني أن نكون محكومين بالكلمات، لكن أن نكتب يعني أن نحول هذا الحكم إلى إمكانية وإلى فضاء للعبور بدل أن يكون سجناً. في هذا التحويل يكمن بعد النجاة: لا ننجو من اللغة، بل ننجو بها، لأن ما يقتلنا ليس الكلام بل غيابه، ليس السرد بل انقطاعه.
الكتابة ليست سوى محاولة دؤوبة لتأجيل الصمت النهائي، لتوسيع المسافة بيننا وبين العدم عبر الكلمات. ليست وهماً بالخلود، بل وعياً بالفناء يُجابَه بالمعنى. وهذا ما يجعل كل نص حقيقياً في جوهره، رسالة في زجاجة تُلقى في بحر الزمن، لا ضمانا لوصولها، لكن مجرد إرسالها هو فعل نجاة، وإعلان عن أن ذاتاً ما كانت هنا، قاومت وكتبت ووُجدت.
وتستمر هذه الرسالة في الزجاجة في السباحة داخل بحر الزمن لا لأنها تضمن الوصول، بل لأنها ترفض الغرق. ذلك أن السرد في عمقه الأنطولوجي، لا يُكتب من أجل قارئ مفترض فحسب، بل من أجل إمكان أن يكون هناك معنى في عالم قابل دائماً لأن يصير بلا معنى. من هنا فإن الكتابة لا تُقيم ضد الموت باعتباره نهاية بيولوجية، بل ضد ما هو أخطر، ضد التفاهة، ضد الفراغ وضد أن تمرّ الحياة دون أن تُقرأ.
إن التحول من العيش إلى السرد ليس انتقالاً من الواقع إلى التخييل، بل من الواقعة إلى الدلالة. الحدث في ذاته لا يقول شيئاً، إنه فقط يقع، أما حين يدخل اللغة فإنه يُدرج في شبكة من العلاقاتومن الأسباب والنتائج ومن القيم والتوترات، فيصير قابلاً للفهم، ومن ثم قابلاً للتحمل. ولهذا كانت الصدمة في تعريفها النفسي العميق، هي الحدث الذي لم يُسرد، الذي بقي خارج اللغة، معلقاً في الجسد أو في اللاوعي دون أن يجد طريقه إلى الحكاية. الكتابة في سياقنا هذا ليست ترفاً أدبياً، بل عملاً علاجياً بمعنى فلسفي، إنها تعيد للذات قدرتها على أن تقول ما جرى لا كما وقع، بل كما يمكن احتماله داخل نظام من المعنى.
فرويد نفسه حين أسس للتحليل النفسي، لم يفعل سوى أن أعاد الاعتبار للسرد بوصفه أفقاً للشفاء. المريض لا يُشفى حين يتخلص من أعراضه، بل حين يصبح قادراً على أن يحكي قصته دون أن ينهار. بول ريكور التقط هذا الخيط العميق بين السرد والعلاج حين رأى أن إعادة رواية الحياة هي شكل من أشكال إعادة امتلاكها. فالإنسان الذي يُصاب بانكسار في معنى وجوده لا يحتاج إلى وقائع جديدة، بل إلى قصة جديدة عن الوقائع القديمة، قصة تمنحه موقعاً داخلها، دوراً، معنى.
يتضح لنا أن الكتابة لا تُنقذنا لأنها تحفظ الماضي، بل لأنها تعيد تشكيله في ضوء حاضر يمكن العيش فيه. الذاكرة ليست أرشيفاً بل مشروع تأويل دائم. وما نكتبه عن طفولتنا أو جراحنا أو خيباتنا ليس هو ما حدث، بل ما نستطيع اليوم أن نقوله عما حدث. هذا الفارق الدقيق بين الحدث ومعناه هو الفضاء الذي تعمل فيه الكتابة كقوة وجودية. إنها لا تمحو الألم لكنها تمنحه شكلاً، وما له شكل يمكن النظر إليه والتفكير فيه ووضعه في مسافة تتيح للذات ألا تذوب فيه.
لهذا السبب نجد أن أعظم النصوص ليست تلك التي تحكي عن السعادة، بل تلك التي تُمسك بالجرح دون أن تسقط فيه. بروست لم يكن يكتب ليستعيد الزمن المفقود، بل ليصنع منه زمناً آخر، زمناً صالحاً للسكن. كافكا لم يكن يدوّن كوابيسه ليغرق فيها، بل ليقيم بينها وبين ذاته حداً لغوياً يحولها إلى مادة للتفكير. حتى سيلفيا بلاث في لحظات الكتابة، كانت تحاول أن تحول ثقل العالم إلى وزن من الكلمات يمكن حمله ولو مؤقتاً.
والسرد ليس مجرد ترتيب زمني، بل بناء أخلاقي للوجود. إنه يقرر ما هو مهم وما هو هامشي، ما يستحق أن يُذكر وما يمكن أن يُنسى، من هو البطل ومن هو الظل. حين نكتب فإننا لا نصف العالم، بل نعيد توزيعه وفق قيم ونظرة ومعنى نختاره أو يُفرض علينا. ولهذا لا توجد كتابة بريئة، لأن كل سرد هو موقف من الوجود حتى حين يتظاهر بالحياد.
إن الذات التي لا تسرد نفسها تظل عرضة لأن تُسرد من الخارج. التاريخ، السلطة، الإعلام، الإيديولوجيا، كلها قوى تكتب قصصاً عن الأفراد والجماعات، وغالباً ما تختزلهم في صور نمطية، في أرقام ووظائف. الكتابة الذاتية في مقابل ذلك هي محاولة لاستعادة الحق في أن تكون لك روايتك الخاصة. إنها مقاومة ناعمة، لكنها عميقة ضد التشييء. أن تكتب يعني أن تقول أنا أكثر من هذا الدور ومن هذا الملف، ومن هذه الصورة التي وُضعت لي.
وهنا تتقاطع الكتابة مع السياسة في أعمق مستوياتها، لا بوصفها خطاباً حزبياً، بل بوصفها صراعاً على المعنى. من يمتلك السرد يمتلك القدرة على تعريف الواقع. ولهذا كانت الرواية والسيرة واليوميات والقصيدة كلها أشكالا من إعادة توزيع السلطة الرمزية. حين يكتب المهمَّش قصته، فإنه لا يضيف مجرد نص إلى العالم، بل يغيّر خريطة ما يُرى وما يُسمع. هكذا تصبح الكتابة نجاة لا للفرد فقط، بل للخبرة الإنسانية التي كان يمكن أن تُمحى.
غير أن هذا البعد التحريري للكتابة لا يلغي بعدها المأساوي. فاللغة نفسها التي ننشد فيها الخلاص، هي أيضاً ما يكشف لنا محدوديتنا. كل كتابة هي اعتراف ضمني بأن ما نريد قوله أكبر مما نستطيع قوله. جاك دريدا كان يصرّ على أن المعنى دائماً مؤجل، وأن النص لا يغلق على حقيقة نهائية. لكن هذا التأجيل بدل أن يكون عيباً، هو ما يجعل الكتابة حية. النجاة التي توفرها ليست نجاة كاملة، بل نجاة ناقصة مفتوحة مثل الحياة نفسها.
في هذا الانفتاح، تتأسس علاقة خاصة بين الكاتب والقارئ. القارئ لا يستهلك معنى جاهزاً، بل يشارك في إنتاجه. كل قراءة تعيد كتابة النص بطريقة ما، وتمنحه حياة جديدة.
إن الكتابة لا تنقذ صاحبها فقط، بل تمنحه امتدادات وجودية عبر الآخرين. كل من يقرأ نصاً بعمق يعيد إحياء التجربة التي وُلد منها ويضيف إليها شيئاً من ذاته. هنا تتحول النجاة من فعل فردي إلى شبكة من الحيوات المتقاطعة داخل الكلمات.
ولعل هذا ما يفسر لماذا يخاف الطغاة من الكتابة أكثر مما يخافون من السلاح. السلاح يقتل جسداً، أما السرد فيمكن أن يقتل رواية رسمية عن العالم. إنه يفتح شقوقاً في اليقين، ويُظهر أن ما قُدِّم بوصفه ضرورة يمكن أن يُحكى بطريقة أخرى. هكذا تصبح الكتابة فعلاً تخريبياً بالمعنى الإيجابي وتخريباً للثبات الزائف، وللمعاني المغلقة وللصور التي تريد أن تُقنعنا بأن ما هو قائم هو ما ينبغي أن يكون.
غير أن أعمق مستويات النجاة في الكتابة لا تكمن في بعدها السياسي أو العلاجي فقط، بل في قدرتها على أن تمنح الزمن شكلاً. الزمن في تجربتنا اليومية يتدفق بلا نظام، يمحو ما قبله ويتركنا دائماً متأخرين عن أنفسنا. السرد هو ما يبطئ هذا التدفق، ما يقطعه إلى مقاطع يمكن النظر إليها، ما يحول العبور إلى مسار له ملامح. هايدغر رأى أن الزمن ليس إطاراً خارجياً، بل هو نسيج وجودنا نفسه. حين نكتب فإننا لا نمسك بالزمن، بل نعيد تشكيل علاقتنا به، نحوله من قوة تعصف بنا إلى قصة يمكن أن نكون شخصياتها.
لهذا فإن الرواية في جوهرها ليست عن الأحداث، بل عن الزمن الذي يمر عبرها. إنها محاولة للإجابة عن السؤال، ماذا يعني أن نعيش؟ كيف يتشكل المعنى عبر التكرار والتغير وعبر الفقد والاستمرار؟ في كل نص عميق هناك صراع بين ما يزول وما يبقى، بين ما يُنسى وما يُكتب. والكتابة حين تنتصر لا تنتصر على الزوال، بل تنتصر للذاكرة بوصفها شكلاً من أشكال العدالة الوجودية.
العدالة هنا لا تعني إنصافاً قانونياً، بل إنصاف التجربة. كل حياة مهما بدت صغيرة تحمل عالماً من الأحاسيس والأفكار والتناقضات. حين تُكتب فإنها تُمنح حقها في الظهور. هذا ما يجعل الأدب العظيم قادراً على أن يمنح صوتاً لمن لم يكن لهم صوت، ليس لأنه يتحدث باسمهم، بل لأنه يفتح فضاءً يمكن أن يُسمعوا فيه. وهكذا تتحول الكتابة إلى أرشيف للوجود الإنساني في تنوعه وهشاشته، إلى ذاكرة ضد الإلغاء.
لكن هذه الذاكرة ليست محايدة. إنها دائماً مُعاد تشكيلها من داخل لغة محددة وثقافة محددةومنظور محدد. ومع ذلك فإن هذا التحديد لا يلغي طابعها الكوني، بل يمنحه جسداً. فكلما كان النص أكثر تجذراً في تجربة بعينها، كان أقدر على أن يلمس تجارب أخرى. الغريب في الكتابة أن خصوصيتها هي طريقها إلى العمومية. حين يكتب شخص ما ألمه بصدق، يجد فيه الآخرون أصداء لآلامهم، لا لأن الوقائع متشابهة، بل لأن البنية الوجودية واحدة.
تتكشف الكتابة بوصفها شكلاً من أشكال التضامن الأنطولوجي. نحن لا ننجو وحدنا، بل ننجو معاً داخل فضاء اللغة. كل نص هو دعوة غير معلنة إلى قارئ محتمل: تعال، اجلس هنا، في هذه الكلمات، ولنحاول معاً أن نفهم ما يعني أن نكون بشراً. هذا النداء الصامت هو ما يمنح الكتابة بعدها الأخلاقي الأعمق، لأنها تفترض دائماً الآخر حتى حين تُكتب في عزلة.
وعند هذا الحدّ يتبدّى السرد بوصفه فعلاً وجوديًا، لا كأداة فنية بل ككيفيةٍ في الوجود. فالكتابة هي أن تُنشئ فجوةً تأملية بين الذات وما يصيبها لا للفرار منه، بل لإعادة تشكيله في أفق المعنى. وفي تلك الفجوة يتأسس الخلاص، لا عبر نفي الألم، بل عبر احتوائه داخل لغة تمنحه قابلية الاحتمال.
اللغة هنا ليست زخرفاً بل أفقاً للعيش. كل كلمة هي محاولة صغيرة لترتيب الفوضى، وكل جملة هي جسر فوق هاوية الصمت. والكاتب ليس إلا من يمشي على هذه الجسور الهشة، مرة بعد مرة، لا لأنه واثق من الوصول، بل لأنه يرفض السقوط في اللامعنى. تستمر الكتابة لا كضمان بل كرهان دائم على أن الوجود مهما كان هشّاً يمكن أن يُقال، ومن ثم يمكن أن يُحتمل.